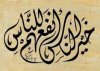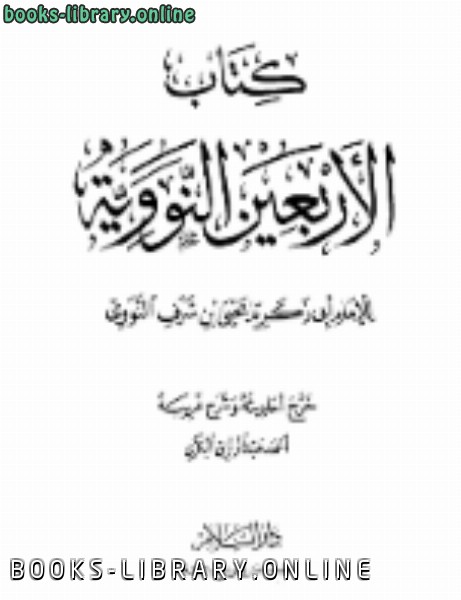❞ الفروع ❝ 💬 اقتباسات من الكتب 📖
- الفروع 💬 اقتباسات من الكتب 📖
█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2025
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
اقتباسات في ❞الفروع❝
-
❞ الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروفة بـ الأربعون النووية، متن اشتمل على اثنين وأربعين حديثاّ جمعها يحيى بن شرف النووي المتوفى 676 هـ. تعريف الأربعون النووية هي مؤلف يحتوي على أربعين حديثاً نبويا شريفا، جمعها: الإمام النووي الذي التزم في جمعها أن تكون صحيحة، وعلل النووي سبب جمعه للأربعين فقال: «من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة، رضي الله عن قاصديها. وقد رايت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي اربعون حديثاً مشتملةً على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليه، أو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك.» ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، وحذف أسانيدها ليسهل حفظها، ثم أتبعها بباب في ضبط خفيّ ألفاظها. فرغ المؤلف من تأليفها ليلة الخميس 29 جمادى الأول سنة 668 هـ. وقال النووي في مقدمة كتابه عن هذا الحديث ومدى اعتماده عليه في جمع الأربعين النووية: "وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة: "ليبلغ الشاهد منكم الغائب"، وقوله: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها". وقد علق الأستاذ ماهر الهندي على قول النووي، بأن الأعتماد على الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال هو قول الجمهور وليس متفقًا عليه. سبب التسمية الأربعون حديثا الأربعينات التي ظهرت استنادا على حديث ضعيف يقول «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ». شروح الأربعين هذا ثبت للعلماء الذين شرحوا الأربعين استنادا على كتاب «الدليل إلى المتون العلمية» لابن قاسم، مرتبة حسب تاريخ وفاة الشارح:. ❝ ⏤أبو زكريا يحي بن شرف النووي❞ الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروفة بـ الأربعون النووية، متن اشتمل على اثنين وأربعين حديثاّ جمعها يحيى بن شرف النووي المتوفى 676 هـ.
تعريف
الأربعون النووية هي مؤلف يحتوي على أربعين حديثاً نبويا شريفا، جمعها: الإمام النووي الذي التزم في جمعها أن تكون صحيحة، وعلل النووي سبب جمعه للأربعين فقال:
«من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة، رضي الله عن قاصديها. وقد رايت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي اربعون حديثاً مشتملةً على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليه، أو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك.»
ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، وحذف أسانيدها ليسهل حفظها، ثم أتبعها بباب في ضبط خفيّ ألفاظها. فرغ المؤلف من تأليفها ليلة الخميس 29 جمادى الأول سنة 668 هـ.
وقال النووي في مقدمة كتابه عن هذا الحديث ومدى اعتماده عليه في جمع الأربعين النووية: ˝وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة: ˝ليبلغ الشاهد منكم الغائب˝، وقوله: ˝نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها˝. وقد علق الأستاذ ماهر الهندي على قول النووي، بأن الأعتماد على الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال هو قول الجمهور وليس متفقًا عليه.
سبب التسمية
الأربعون حديثا الأربعينات التي ظهرت استنادا على حديث ضعيف يقول «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ».
شروح الأربعين
هذا ثبت للعلماء الذين شرحوا الأربعين استنادا على كتاب «الدليل إلى المتون العلمية» لابن قاسم، مرتبة حسب تاريخ وفاة الشارح:. ❝
⏤ أبو زكريا يحي بن شرف النووي -
❞ عبد القادر الجيلي أو الجيلاني أو الكيلاني (470 - 561 هـ)، هو أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله، يعرف ويلقب في التراث المغاربي بالشيخ بوعلام الجيلاني، وبالمشرق عبد القادر الجيلاني، ويعرف أيضا ب\"سلطان الأولياء\"، وهو إمام صوفي وفقيه حنبلي شافعي، لقبه أتباعه بـ\"باز الله الأشهب\" و\"تاج العارفين\" و\"محيي الدين\" و\"قطب بغداد\". وإليه تنتسب الطريقة القادرية الصوفية. كان الجيلاني يفتي على المذهب الشافعي بالإضافة إلى المذهب الحنبلي لذلك قال عنه النووي: إنه كان شيخ الشافعية والحنابلة في بغداد. ولقد علّق على ذلك أبو عبد الله محمد المسناوي الدلائي (ت 1136هـ) فيما كتبه عن الشيخ قائلاً: «وهذا مما يدل على أنه لم يكن متقيداً بمذهب أحمد حتى في الفروع، وكأنه كان يختار من المذهبين، بمقتضی غزير علمه، وسدید نظره، الأحوط للدين، والأوفق باليقين، كما هو شأن أهل الرسوخ في العلم والتكوين». وقد بين الجيلاني عقيدته في المقالة التي وردت في آخر كتابه (فتوح الغيب) كما أوردها إسماعيل بن محمد سعيد القادري في كتاب (الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية). توفي الإمام الجيلاني ليلة السبت 10 ربيع الثاني سنة 561 هـ، جهزه وصلى عليه ولده عبد الوهّاب في جماعة من حضر من أولاده وأصحابه، ثم دفن في رواق مدرسته، ولم يفتح باب المدرسة حتى علا النهار وهرع الناس للصلاة على قبره وزيارته، وبلغ تسعين سنة من عمره.. ❝ ⏤علي محمد الصلابي❞ عبد القادر الجيلي أو الجيلاني أو الكيلاني (470 - 561 هـ)، هو أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله، يعرف ويلقب في التراث المغاربي بالشيخ بوعلام الجيلاني، وبالمشرق عبد القادر الجيلاني، ويعرف أيضا ب˝سلطان الأولياء˝، وهو إمام صوفي وفقيه حنبلي شافعي، لقبه أتباعه بـ˝باز الله الأشهب˝ و˝تاج العارفين˝ و˝محيي الدين˝ و˝قطب بغداد˝. وإليه تنتسب الطريقة القادرية الصوفية.
كان الجيلاني يفتي على المذهب الشافعي بالإضافة إلى المذهب الحنبلي لذلك قال عنه النووي: إنه كان شيخ الشافعية والحنابلة في بغداد. ولقد علّق على ذلك أبو عبد الله محمد المسناوي الدلائي (ت 1136هـ) فيما كتبه عن الشيخ قائلاً: «وهذا مما يدل على أنه لم يكن متقيداً بمذهب أحمد حتى في الفروع، وكأنه كان يختار من المذهبين، بمقتضی غزير علمه، وسدید نظره، الأحوط للدين، والأوفق باليقين، كما هو شأن أهل الرسوخ في العلم والتكوين». وقد بين الجيلاني عقيدته في المقالة التي وردت في آخر كتابه (فتوح الغيب) كما أوردها إسماعيل بن محمد سعيد القادري في كتاب (الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية).
توفي الإمام الجيلاني ليلة السبت 10 ربيع الثاني سنة 561 هـ، جهزه وصلى عليه ولده عبد الوهّاب في جماعة من حضر من أولاده وأصحابه، ثم دفن في رواق مدرسته، ولم يفتح باب المدرسة حتى علا النهار وهرع الناس للصلاة على قبره وزيارته، وبلغ تسعين سنة من عمره. ❝
⏤ علي محمد الصلابي -
 ❞ \"مشاعر مُبعثرة\" دائمًا ما يراودني ذلك الشعور بأن رأسي كجذع شجرة، وذكرياتي كأوراقها، ظلت الذكريات صامدة بحزنها، وفرحها خيباتها، وإنتصاراتها خذلانها وجبرها.. ظلت أوراق الذكريات متشبثة بتلك الفروع، حتى جاءت تلك اللحظه شعرت؛ وكأن الأوراق بدأت بترك فروعها، شعرت وكأنها تتطاير واحدةً تلو الأخري، اصبحتُ أفقد الكثير من أوراق الذكريات، حاولت الفروع الإحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الأوراق، كنت كجذع شجرة لتلك الفروع حاولت السعي معها؛ لإنقاذ أكبر عدد من الأوراق؛ لكن كل المحاولات إنتهت بالفشل مع تقدم العمر … ظلت السنين تمر، وتلك الأوراق تتطاير، حاولتُ ألا ألتفت للوراء بكل الطرق؛ لكي لا أشعر بكم الأوراق التي خسرتها، مع مرور كل تلك السنين لكني مع الوقت بدأت أشعر؛ وكأنه لا بأس بفقدان بعض الأوراق، فقد كانت أكثرها سيئة علي أي حال. ك/ Zahraa Kasem. ❝ ⏤𝚉𝙰𝙷𝚁𝙰𝙰 𝙺𝙰𝚂𝙴𝙼❞ ˝مشاعر مُبعثرة˝
❞ \"مشاعر مُبعثرة\" دائمًا ما يراودني ذلك الشعور بأن رأسي كجذع شجرة، وذكرياتي كأوراقها، ظلت الذكريات صامدة بحزنها، وفرحها خيباتها، وإنتصاراتها خذلانها وجبرها.. ظلت أوراق الذكريات متشبثة بتلك الفروع، حتى جاءت تلك اللحظه شعرت؛ وكأن الأوراق بدأت بترك فروعها، شعرت وكأنها تتطاير واحدةً تلو الأخري، اصبحتُ أفقد الكثير من أوراق الذكريات، حاولت الفروع الإحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الأوراق، كنت كجذع شجرة لتلك الفروع حاولت السعي معها؛ لإنقاذ أكبر عدد من الأوراق؛ لكن كل المحاولات إنتهت بالفشل مع تقدم العمر … ظلت السنين تمر، وتلك الأوراق تتطاير، حاولتُ ألا ألتفت للوراء بكل الطرق؛ لكي لا أشعر بكم الأوراق التي خسرتها، مع مرور كل تلك السنين لكني مع الوقت بدأت أشعر؛ وكأنه لا بأس بفقدان بعض الأوراق، فقد كانت أكثرها سيئة علي أي حال. ك/ Zahraa Kasem. ❝ ⏤𝚉𝙰𝙷𝚁𝙰𝙰 𝙺𝙰𝚂𝙴𝙼❞ ˝مشاعر مُبعثرة˝
دائمًا ما يراودني ذلك الشعور
بأن رأسي كجذع شجرة،
وذكرياتي كأوراقها،
ظلت الذكريات صامدة بحزنها، وفرحها
خيباتها، وإنتصاراتها
خذلانها وجبرها.
ظلت أوراق الذكريات متشبثة بتلك الفروع،
حتى جاءت تلك اللحظه
شعرت؛ وكأن الأوراق بدأت بترك فروعها،
شعرت وكأنها تتطاير واحدةً تلو الأخري،
اصبحتُ أفقد الكثير من أوراق الذكريات،
حاولت الفروع الإحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الأوراق،
كنت كجذع شجرة لتلك الفروع
حاولت السعي معها؛ لإنقاذ أكبر عدد من الأوراق؛
لكن كل المحاولات إنتهت بالفشل مع تقدم العمر …
ظلت السنين تمر، وتلك الأوراق تتطاير،
حاولتُ ألا ألتفت للوراء بكل الطرق؛ لكي لا أشعر بكم الأوراق التي خسرتها،
مع مرور كل تلك السنين
لكني مع الوقت بدأت أشعر؛
وكأنه لا بأس بفقدان بعض الأوراق،
فقد كانت أكثرها سيئة علي أي حال.
ك/ Zahraa Kasem. ❝
⏤ 𝚉𝙰𝙷𝚁𝙰𝙰 𝙺𝙰𝚂𝙴𝙼 -
❞ يشير الزركشي إلى السبب العلمي والمنهجي في التفريق بين التفسير والتأويل وجعل كل منهما ذا دلالة محددة وواضحة، ومتميزة ومخالفة لدلالة الآخر، وذلك حيث يقول : " والحق أن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ وتعيين المبهم، وتبيين المجمل، ومنه ما لا يتوقف ويكفي في تحصيله التفقه على الوجه المعتبر، وكأن السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير والتأويل، التمييز بين المنقول والمستنبط، ليحمل على الإعتماد في المنقول، وعلى النظر في المستنبط، تجويزا له وازديادا، وهذا من الفروع في الدين. ويفهم من هذا الكلام ومن الذي قبله أن التفسير يتعلق بالرواية، وأما التأويل فمرتبط بالدراية وإعمال النظر، ولكل منهما شروط صحة وقبول. ❝ ⏤أحمد بزوي الضاوي❞ يشير الزركشي إلى السبب العلمي والمنهجي في التفريق بين التفسير والتأويل وجعل كل منهما ذا دلالة محددة وواضحة، ومتميزة ومخالفة لدلالة الآخر، وذلك حيث يقول : ˝ والحق أن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ وتعيين المبهم، وتبيين المجمل، ومنه ما لا يتوقف ويكفي في تحصيله التفقه على الوجه المعتبر، وكأن السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير والتأويل، التمييز بين المنقول والمستنبط، ليحمل على الإعتماد في المنقول، وعلى النظر في المستنبط، تجويزا له وازديادا، وهذا من الفروع في الدين.
ويفهم من هذا الكلام ومن الذي قبله أن التفسير يتعلق بالرواية، وأما التأويل فمرتبط بالدراية وإعمال النظر، ولكل منهما شروط صحة وقبول. ❝
⏤ أحمد بزوي الضاوي -
❞ الانشغال بخلاف الجزئيات في زمن ضعف الكليات يُضيّع الكليات ، لهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة بالأصول وترسيخها ثم أقام عليها الفروع فرسخت رسالته. ❝ ⏤عبد العزيز بن مرزوق الطريفي❞ الانشغال بخلاف الجزئيات في زمن ضعف الكليات يُضيّع الكليات ، لهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة بالأصول وترسيخها ثم أقام عليها الفروع فرسخت رسالته. ❝
⏤ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي