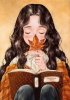❞ لغة العرب ❝ 💬 اقتباسات من الكتب 📖
- لغة العرب 💬 اقتباسات من الكتب 📖
█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2025
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
اقتباسات في ❞لغة العرب❝
-
❞ من بلاغة اللغة العربية أن العرب كانت تنزل الجن مراتب: فإذا أرادوا أن يذكروا الجن بصفة عامة قالوا: جن. فإن سكن مع الناس قالوا: عامر. وإن تعرض للصبيان قالوا: أرواح. فإذا خبث قالوا: شيطان. أما المارد فهو من عُتاة الشياطين. فإن زاد عنه في القوة قالوا: عفريت. أما الأبالسة فهم من نسل إبليس وجنوده وهو نوع من الجن وشياطين الوسوسة الذين يغوون بني آدم. و القرين، وهو شيطان كافر، مهمته الاقتران بالإنسان من الميلاد حتى الممات لإغوائه، ولا يفارقه أبداً حتى الموت، وتنتهي المهمة بموت الإنسي ولا يُعلم أين يذهب بعد ذلك. الظاهر والله أعلم أن القرين مختلف عن جند إبليس الذي يبثهم كل يوم لإغواء الناس، فإبليس يبث سراياه ثم يعودون إليه بعد ذلك فهؤلاء لا يلازمون الإنسان دائماً، أما القرين فهو مقترن به لا يفارقه أبداً. والغول في لغة العرب هو الجان إذا تبدى بالليل، وذلك أنّها كانت تتراءى لهم في الليالي وأوقات الخلوات. وكانوا يطلقون اسم القطرب على الذكور منهم. أما أبو فانوس فهو الغول الذي يُرى في الصحراء على شكل نور وعندما تقترب منه يختفي. وبالنسبة لِـ \"السعالي\" فهم سحرة الجن. نوماً هانئاً 😊. ❝ ⏤Aнмed Elѕarнany❞ من بلاغة اللغة العربية أن العرب كانت تنزل الجن مراتب:
فإذا أرادوا أن يذكروا الجن بصفة عامة قالوا: جن.
فإن سكن مع الناس قالوا: عامر.
وإن تعرض للصبيان قالوا: أرواح.
فإذا خبث قالوا: شيطان.
أما المارد فهو من عُتاة الشياطين.
فإن زاد عنه في القوة قالوا: عفريت.
أما الأبالسة فهم من نسل إبليس وجنوده وهو نوع من الجن وشياطين الوسوسة الذين يغوون بني آدم.
و القرين، وهو شيطان كافر، مهمته الاقتران بالإنسان من الميلاد حتى الممات لإغوائه، ولا يفارقه أبداً حتى الموت، وتنتهي المهمة بموت الإنسي ولا يُعلم أين يذهب بعد ذلك.
الظاهر والله أعلم أن القرين مختلف عن جند إبليس الذي يبثهم كل يوم لإغواء الناس، فإبليس يبث سراياه ثم يعودون إليه بعد ذلك فهؤلاء لا يلازمون الإنسان دائماً، أما القرين فهو مقترن به لا يفارقه أبداً.
والغول في لغة العرب هو الجان إذا تبدى بالليل، وذلك أنّها كانت تتراءى لهم في الليالي وأوقات الخلوات.
وكانوا يطلقون اسم القطرب على الذكور منهم.
أما أبو فانوس فهو الغول الذي يُرى في الصحراء على شكل نور وعندما تقترب منه يختفي.
وبالنسبة لِـ ˝السعالي˝ فهم سحرة الجن.
نوماً هانئاً 😊. ❝
⏤ Aнмed Elѕarнany -
❞ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) قوله تعالى : " بل عجبت " قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم بفتح التاء خطابا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، أي : بل عجبت مما نزل عليك من القرآن وهم يسخرون به . وهي قراءة شريح وأنكر قراءة الضم وقال : إن الله لا يعجب من شيء ، وإنما يعجب من لا يعلم . وقيل : المعنى بل عجبت من إنكارهم للبعث . وقرأ الكوفيون إلا عاصما بضم التاء . واختارها أبو عبيد والفراء ، وهي مروية عن علي وابن مسعود ، رواه شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ : " بل عجبت " بضم التاء . ويروى عن ابن عباس . قال الفراء في قوله - سبحانه - : بل عجبت ويسخرون قرأها الناس بنصب التاء ورفعها ، والرفع أحب إلي ; لأنها عن علي وعبد الله وابن عباس . وقال أبو زكريا الفراء : العجب إن أسند إلى الله - عز وجل - فليس معناه من الله كمعناه من العباد ، وكذلك قوله : الله يستهزئ بهم ليس ذلك من الله كمعناه من العباد . وفي هذا بيان الكسر لقول شريح حيث أنكر القراءة بها . روى جرير والأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : قرأها عبد الله ، يعني : ابن مسعود بل عجبت ويسخرون قال شريح : إن الله لا يعجب من شيء ، إنما يعجب من لا يعلم . قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم فقال : إن شريحا كان يعجبه رأيه ، إن عبد الله كان أعلم من شريح وكان يقرؤها عبد الله " بل عجبت " . قال الهروي : وقال بعض الأئمة : معنى قوله : " بل عجبت " بل جازيتهم على عجبهم ; لأن الله تعالى أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الحق ، فقال : وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال : إن هذا لشيء عجاب ، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم فقال تعالى : " بل عجبت " بل جازيتهم على التعجب . قلت : وهذا تمام معنى قول الفراء واختاره البيهقي . وقال علي بن سليمان : معنى القراءتين واحد ، التقدير : قيل يا محمد بل عجبت ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مخاطب بالقرآن . النحاس : وهذا قول حسن ، وإضمار القول كثير . البيهقي : والأول أصح . المهدوي : ويجوز أن يكون إخبار الله عن نفسه بالعجب محمولا على أنه أظهر من أمره وسخطه على من كفر به ما يقوم مقام العجب من المخلوقين ، كما يحمل إخباره تعالى عن نفسه بالضحك لمن يرضى عنه - على ما جاء في الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنه أظهر له من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين مجازا واتساعا . قال الهروي : ويقال معنى ( عجب ربكم ) أي : رضي وأثاب ، فسماه عجبا وليس بعجب في الحقيقة ، كما قال تعالى : " ويمكر الله " معناه ويجازيهم الله على مكرهم ، ومثله في الحديث عجب ربكم من إلكم وقنوطكم . وقد يكون العجب بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيما . فيكون معنى قوله : " بل عجبت " أي : بل عظم فعلهم عندي . قال البيهقي : ويشبه أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : عجب ربك من شاب ليست له صبوة وكذلك ما خرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل قال البيهقي : وقد يكون هذا الحديث وما ورد من أمثاله أنه يعجب ملائكته من كرمه ورأفته بعباده ، حين حملهم على الإيمان به بالقتال والأسر في السلاسل ، حتى إذا آمنوا أدخلهم الجنة . وقيل : معنى " بل عجبت " بل أنكرت . حكاه النقاش . وقال الحسين بن الفضل : التعجب من الله إنكار الشيء وتعظيمه ، وهو لغة العرب . وقد جاء في الخبر عجب ربكم من إلكم وقنوطكم . ويسخرون قيل : الواو واو الحال ، أي : عجبت منهم في حال سخريتهم . وقيل : تم الكلام عند قوله : بل عجبت ثم استأنف فقال : ويسخرون أي : مما جئت به إذا تلوته عليهم . وقيل : يسخرون منك إذا دعوتهم .. ❝ ⏤محمد بن صالح العثيمين❞ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12)
قوله تعالى : ˝ بل عجبت ˝ قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم بفتح التاء خطابا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، أي : بل عجبت مما نزل عليك من القرآن وهم يسخرون به . وهي قراءة شريح وأنكر قراءة الضم وقال : إن الله لا يعجب من شيء ، وإنما يعجب من لا يعلم . وقيل : المعنى بل عجبت من إنكارهم للبعث . وقرأ الكوفيون إلا عاصما بضم التاء . واختارها أبو عبيد والفراء ، وهي مروية عن علي وابن مسعود ، رواه شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ : ˝ بل عجبت ˝ بضم التاء . ويروى عن ابن عباس . قال الفراء في قوله - سبحانه - : بل عجبت ويسخرون قرأها الناس بنصب التاء ورفعها ، والرفع أحب إلي ; لأنها عن علي وعبد الله وابن عباس . وقال أبو زكريا الفراء : العجب إن أسند إلى الله - عز وجل - فليس معناه من الله كمعناه من العباد ، وكذلك قوله : الله يستهزئ بهم ليس ذلك من الله كمعناه من العباد . وفي هذا بيان الكسر لقول شريح حيث أنكر القراءة بها . روى جرير والأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : قرأها عبد الله ، يعني : ابن مسعود بل عجبت ويسخرون قال شريح : إن الله لا يعجب من شيء ، إنما يعجب من لا يعلم . قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم فقال : إن شريحا كان يعجبه رأيه ، إن عبد الله كان أعلم من شريح وكان يقرؤها عبد الله ˝ بل عجبت ˝ . قال الهروي : وقال بعض الأئمة : معنى قوله : ˝ بل عجبت ˝ بل جازيتهم على عجبهم ; لأن الله تعالى أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الحق ، فقال : وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال : إن هذا لشيء عجاب ، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم فقال تعالى : ˝ بل عجبت ˝ بل جازيتهم على التعجب .
قلت : وهذا تمام معنى قول الفراء واختاره البيهقي . وقال علي بن سليمان : معنى القراءتين واحد ، التقدير : قيل يا محمد بل عجبت ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مخاطب بالقرآن . النحاس : وهذا قول حسن ، وإضمار القول كثير . البيهقي : والأول أصح . المهدوي : ويجوز أن يكون إخبار الله عن نفسه بالعجب محمولا على أنه أظهر من أمره وسخطه على من كفر به ما يقوم مقام العجب من المخلوقين ، كما يحمل إخباره تعالى عن نفسه بالضحك لمن يرضى عنه - على ما جاء في الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنه أظهر له من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين مجازا واتساعا . قال الهروي : ويقال معنى ( عجب ربكم ) أي : رضي وأثاب ، فسماه عجبا وليس بعجب في الحقيقة ، كما قال تعالى : ˝ ويمكر الله ˝ معناه ويجازيهم الله على مكرهم ، ومثله في الحديث عجب ربكم من إلكم وقنوطكم . وقد يكون العجب بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيما . فيكون معنى قوله : ˝ بل عجبت ˝ أي : بل عظم فعلهم عندي . قال البيهقي : ويشبه أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : عجب ربك من شاب ليست له صبوة وكذلك ما خرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل قال البيهقي : وقد يكون هذا الحديث وما ورد من أمثاله أنه يعجب ملائكته من كرمه ورأفته بعباده ، حين حملهم على الإيمان به بالقتال والأسر في السلاسل ، حتى إذا آمنوا أدخلهم الجنة . وقيل : معنى ˝ بل عجبت ˝ بل أنكرت . حكاه النقاش . وقال الحسين بن الفضل : التعجب من الله إنكار الشيء وتعظيمه ، وهو لغة العرب . وقد جاء في الخبر عجب ربكم من إلكم وقنوطكم . ويسخرون قيل : الواو واو الحال ، أي : عجبت منهم في حال سخريتهم . وقيل : تم الكلام عند قوله : بل عجبت ثم استأنف فقال : ويسخرون أي : مما جئت به إذا تلوته عليهم . وقيل : يسخرون منك إذا دعوتهم. ❝
⏤ محمد بن صالح العثيمين -
❞ القرآن في لغة العرب مصدر كالقراءة، ومعناه الجمع، وسمّي القرآن الّذي أنزل الله على محمّد صلى الله عليه وسلم قرآنا؛ لأنّه يجمع السّور ويضمّها. ❝ ⏤عبد الله بن يوسف الجديع❞ القرآن في لغة العرب مصدر كالقراءة، ومعناه الجمع، وسمّي القرآن الّذي أنزل الله على محمّد صلى الله عليه وسلم قرآنا؛ لأنّه يجمع السّور ويضمّها. ❝
⏤ عبد الله بن يوسف الجديع -
❞ كلمة (كاشر) تأتي بمعنى عبوس الوجه والضحوك على النقيض، أليس كذلك؟ هشّ بَشّ جَهْم عابس x هَاشٌّ باشٌّ ضحوكٌ x بَكَّاء بَسَّام x كئيب باسم x حزين كشر معناها كَشَفَ. إذا كشف الإنسان أو الحيوان عن أسنانه يقال: كَشَرَ. أسَدٌ كاشر. قال المتنبي: إذا رأيتَ نيوبَ الليثِ بارزةً •• فلا تظنن أنَّ الليثَ يبتسِمُ قال الْجَوْهَرِيُّ: الْكَشْرُ التَّبَسُّمُ. يُقَالُ: ڪَشَرَ الرَّجُلُ وَانْكَلَّ وَافْتَرَّ وَابْتَسَمَ ڪُلُّ ذَلِكَ تَبْدُو مِنْهُ الْأَسْنَانُ. ابْنُ سِيدَهْ: ڪَشَرَ عَنْ أَسْنَانِهِ يَكْشِرُ ڪَشْرًا أَبْدَى، يَكُونُ ذَلِكَ فِي الضَّحِكِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ ڪَاشَرَهُ، وَالِاسْمُ الْكِشْرَةُ ڪَالْعِشْرَةِ. وَكَشَرَ الْبَعِيرُ عَنْ نَابِهِ أَيْ ڪَشَفَ عَنْهُ. وَكَاشَرَهُ إِذَا ضَحِكَ فِي وَجْهِهِ وَبَاسَطَهُ\". قال صاحبي: \"سمعت العوامّ مراراً يقولون: (ماتكشَّرش وشك) من باب النهي عن الحزن فخيِّل لي أمرٌ\". قلت: \"رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أنه قال: إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ، وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَقْلِيهِمْ أَيْ نَبْسِمُ فِي وُجُوهِهِمْ مع أن قلوبنا تكرههم\". اللهجة العامية لغة منحدرة من أصل. والتكشير بالمعنى العاميّ صحيحٌ. ڪَشَرَ السَّبْعُ عَنْ نَابِهِ إِذَا هَرَّ الْحِرَاشَ، وَكَشَرَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ إِذَا تَنَمَّرَ لَهُ وَأَوْعَدَهُ ڪَأَنَّهُ سَبْعٌ. كشَّر فعل يدل على مبالغة في الكشْر الذي هو -بنص المعجم- كشف الأسنان لتبسُّم أو لإيعادٍ وتهديد. الحِراش معناه المنازعة والمصارعة التي تكون بين الحيوانات. والسبع لفظ يُطلق على كل حيوان مفترس يأكل اللحم. فأنت إذا لطمتَ غلامًا على وجهه مثلًا فإنك تراه ينظر إليك مُغاضبًا يحكُّ بعضُ أسنانه بعضًا مِن الغيظ يريد أن يفتِك بك. عندئذٍ يحق لك أن تقول له: لا تكشر! \"كشَّر الشخصُ :أظهر استياءً وعدم رضى عن أمر\". هذا نصّ ما ذكره صاحب معجم اللغة العربية المعاصرة. ولستُ أعلم متى صارت الناس تستعمل كشَّر بمعنى \"أبدى الحزن\". أعني المدة الزمنية أو العصر الذي بدأت الناس تستعمل هذه اللفظة بهذا المعنى (الحديث). وردت كلمة \"نسوان\" عليَّ مِن الشعر القديم والحديث وهذه شواهد: قال الشَّنْفَرَىٰ: فأيَّمتُ نسوانًا ويَتَّمتُ وِلدةً •• وعدتُ كما أبدأتُ والليلُ أليَلُ أي قتلتُ رجالًا فصارت النساء أيامى والأولاد يتامى، وعدتُ مثل اللمح بالبصر، والليل مظلم لا قمر له، وليس فيه ضوءٌ ألبتَّةَ. قال عمر بن أبي ربيعة: أهذا سِحرك النسوان قد خبَّرنني الخبَرَا وقال المتنبي: مِن كُلِّ رِخوِ وِكاءِ البَطنِ مُنفَتِقٍ •• لا في الرِّجالِ وَلا النِسوانِ مَعدودُ وقال شاعر: فواللهِ ما أدري أزِيدَتْ ملاحةً •• على سائرِ النسوانِ أم ليس لي عقلُ وقال ابن حزم: وهل يأمَن النسوانَ غيرُ مغفَّل •• جهولٍ لأسباب الرَّدَى متأرضِ؟ قال معروف الرصافيّ: لو أخلص الغُزَّى بنُصرةِ دينهم •• ما حَلَّ سَبْيُ حَرائرِ النسوانِ وقال حافظ إبراهيم: فتَضَعضَعَ النسوانُ والــ••ــنِسوانُ ليس لَهُنَّ مُنَّةْ قال صاحبي: \"هل أفهم مِن كلامك أنها استعملت بهذا المعنى؟\" قلت: \"كل لفظة استُعملت في العصر الجاهليّ والإسلامي: صحيحة فصيحة. وأما اللفظة التي بدأ الناس استعمالها أو استعمالها بمعنى حديث في العصر العباسيّ فإنها تسمَّىٰ لفظة مولَّدة. وأما اللفظة التي استعملت في العصر الحديث تُسمى لفظة مُحدَثة. استعمل ما شئتَ ولا تقيّد نفسك، فالله رحيم بعباده. كم مِن عالِمٍ ضيَّق واسعًا لأنَّ الله تعالى وهبه علمًا غزيرًا بلغة العرب. أنت لا تعيش في الجاهلية، ولا تعيش في العصر العباسيّ. أنت تعيش في عصر فيه رجاله وعلماؤه، ولكل واحد منهم رأيُه. فخذ ما شئتَ ودع ما شئت ما دمتَ لا تتكلَّف. إنها لغة. ولا شك في أن عمل علمائنا القدامى انحصر في محاولة تحديد اللغة وتراكيبها ومعاني ألفاظها في مدة زمنية تتراوح ما بين العصر الجاهليّ والعصر العباسيّ الأول. ونظروا إلى لغة هذه المدة على أنها لغة نقية -أو تكاد- وسموا هذه المدة بـ\"عصور الاحتجاج\"، ونظروا بازدراء ظل يزداد إلى كل تطوير ينال اللغة \"النقية\"، تلك اللغة القريبة من لغة القرآن الكريم. وفي القرآن تراكيب لا يُستحسن استعمالها الآن لأنها تسبب ارتباكا. مثل: لا أقسم بيوم القيامة، و\"إن كل نفسٍ لمّا عليها حافظ\"، و\"وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم\". ولم يعد أحد يستعمل لولا بمعنى: هَلَّا والعكس بالعكس. ففي اللغة المعاصرة ألفاظ تستعمل على نحوٍ يؤثّر في فَهمنا لكتاب الله إن لم نُدرِك أن اللفظة القرآنية لها معنى يخالف ذلك المعنى الذي نستعمل هذه اللفظة به\".. ❝ ⏤محمد سيد عبد الفتاح❞ كلمة (كاشر) تأتي بمعنى عبوس الوجه والضحوك على النقيض، أليس كذلك؟
هشّ بَشّ
جَهْم عابس x هَاشٌّ باشٌّ
ضحوكٌ x بَكَّاء
بَسَّام x كئيب
باسم x حزين
كشر معناها كَشَفَ. إذا كشف الإنسان أو الحيوان عن أسنانه يقال: كَشَرَ. أسَدٌ كاشر. قال المتنبي:
إذا رأيتَ نيوبَ الليثِ بارزةً •• فلا تظنن أنَّ الليثَ يبتسِمُ
قال الْجَوْهَرِيُّ: الْكَشْرُ التَّبَسُّمُ. يُقَالُ: ڪَشَرَ الرَّجُلُ وَانْكَلَّ وَافْتَرَّ وَابْتَسَمَ ڪُلُّ ذَلِكَ تَبْدُو مِنْهُ الْأَسْنَانُ. ابْنُ سِيدَهْ: ڪَشَرَ عَنْ أَسْنَانِهِ يَكْشِرُ ڪَشْرًا أَبْدَى، يَكُونُ ذَلِكَ فِي الضَّحِكِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ ڪَاشَرَهُ، وَالِاسْمُ الْكِشْرَةُ ڪَالْعِشْرَةِ. وَكَشَرَ الْبَعِيرُ عَنْ نَابِهِ أَيْ ڪَشَفَ عَنْهُ. وَكَاشَرَهُ إِذَا ضَحِكَ فِي وَجْهِهِ وَبَاسَطَهُ˝.
قال صاحبي: ˝سمعت العوامّ مراراً يقولون: (ماتكشَّرش وشك) من باب النهي عن الحزن فخيِّل لي أمرٌ˝.
قلت: ˝رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أنه قال: إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ، وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَقْلِيهِمْ أَيْ نَبْسِمُ فِي وُجُوهِهِمْ مع أن قلوبنا تكرههم˝.
اللهجة العامية لغة منحدرة من أصل.
والتكشير بالمعنى العاميّ صحيحٌ.
ڪَشَرَ السَّبْعُ عَنْ نَابِهِ إِذَا هَرَّ الْحِرَاشَ، وَكَشَرَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ إِذَا تَنَمَّرَ لَهُ وَأَوْعَدَهُ ڪَأَنَّهُ سَبْعٌ.
كشَّر فعل يدل على مبالغة في الكشْر الذي هو -بنص المعجم- كشف الأسنان لتبسُّم أو لإيعادٍ وتهديد.
الحِراش معناه المنازعة والمصارعة التي تكون بين الحيوانات.
والسبع لفظ يُطلق على كل حيوان مفترس يأكل اللحم.
فأنت إذا لطمتَ غلامًا على وجهه مثلًا فإنك تراه ينظر إليك مُغاضبًا يحكُّ بعضُ أسنانه بعضًا مِن الغيظ يريد أن يفتِك بك.
عندئذٍ يحق لك أن تقول له: لا تكشر!
˝كشَّر الشخصُ :أظهر استياءً وعدم رضى عن أمر˝. هذا نصّ ما ذكره صاحب معجم اللغة العربية المعاصرة. ولستُ أعلم متى صارت الناس تستعمل كشَّر بمعنى ˝أبدى الحزن˝. أعني المدة الزمنية أو العصر الذي بدأت الناس تستعمل هذه اللفظة بهذا المعنى (الحديث).
وردت كلمة ˝نسوان˝ عليَّ مِن الشعر القديم والحديث وهذه شواهد:
قال الشَّنْفَرَىٰ:
فأيَّمتُ نسوانًا ويَتَّمتُ وِلدةً •• وعدتُ كما أبدأتُ والليلُ أليَلُ
أي قتلتُ رجالًا فصارت النساء أيامى والأولاد يتامى، وعدتُ مثل اللمح بالبصر، والليل مظلم لا قمر له، وليس فيه ضوءٌ ألبتَّةَ.
قال عمر بن أبي ربيعة:
أهذا سِحرك النسوان قد خبَّرنني الخبَرَا
وقال المتنبي:
مِن كُلِّ رِخوِ وِكاءِ البَطنِ مُنفَتِقٍ •• لا في الرِّجالِ وَلا النِسوانِ مَعدودُ
وقال شاعر:
فواللهِ ما أدري أزِيدَتْ ملاحةً •• على سائرِ النسوانِ أم ليس لي عقلُ
وقال ابن حزم:
وهل يأمَن النسوانَ غيرُ مغفَّل •• جهولٍ لأسباب الرَّدَى متأرضِ؟
قال معروف الرصافيّ:
لو أخلص الغُزَّى بنُصرةِ دينهم •• ما حَلَّ سَبْيُ حَرائرِ النسوانِ
وقال حافظ إبراهيم:
فتَضَعضَعَ النسوانُ والــ••ــنِسوانُ ليس لَهُنَّ مُنَّةْ
قال صاحبي: ˝هل أفهم مِن كلامك أنها استعملت بهذا المعنى؟˝
قلت: ˝كل لفظة استُعملت في العصر الجاهليّ والإسلامي: صحيحة فصيحة. وأما اللفظة التي بدأ الناس استعمالها أو استعمالها بمعنى حديث في العصر العباسيّ فإنها تسمَّىٰ لفظة مولَّدة. وأما اللفظة التي استعملت في العصر الحديث تُسمى لفظة مُحدَثة.
استعمل ما شئتَ ولا تقيّد نفسك، فالله رحيم بعباده.
كم مِن عالِمٍ ضيَّق واسعًا لأنَّ الله تعالى وهبه علمًا غزيرًا بلغة العرب.
أنت لا تعيش في الجاهلية، ولا تعيش في العصر العباسيّ. أنت تعيش في عصر فيه رجاله وعلماؤه، ولكل واحد منهم رأيُه. فخذ ما شئتَ ودع ما شئت ما دمتَ لا تتكلَّف.
إنها لغة. ولا شك في أن عمل علمائنا القدامى انحصر في محاولة تحديد اللغة وتراكيبها ومعاني ألفاظها في مدة زمنية تتراوح ما بين العصر الجاهليّ والعصر العباسيّ الأول. ونظروا إلى لغة هذه المدة على أنها لغة نقية -أو تكاد- وسموا هذه المدة بـ˝عصور الاحتجاج˝، ونظروا بازدراء ظل يزداد إلى كل تطوير ينال اللغة ˝النقية˝، تلك اللغة القريبة من لغة القرآن الكريم.
وفي القرآن تراكيب لا يُستحسن استعمالها الآن لأنها تسبب ارتباكا. مثل: لا أقسم بيوم القيامة، و˝إن كل نفسٍ لمّا عليها حافظ˝، و˝وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم˝.
ولم يعد أحد يستعمل لولا بمعنى: هَلَّا
والعكس بالعكس. ففي اللغة المعاصرة ألفاظ تستعمل على نحوٍ يؤثّر في فَهمنا لكتاب الله إن لم نُدرِك أن اللفظة القرآنية لها معنى يخالف ذلك المعنى الذي نستعمل هذه اللفظة به˝. ❝
⏤ محمد سيد عبد الفتاح -