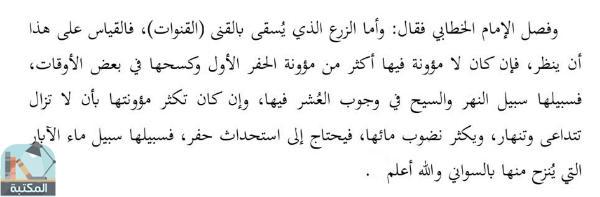❞ الزكاة ❝ 💬 اقتباسات من الكتب 📖
- الزكاة 💬 اقتباسات من الكتب 📖
█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2025
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
اقتباسات في ❞الزكاة❝
-
❞ مقدمة عن الكتاب : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اعتنى ديننا الإسلامي الحنيف بعبادة الزكاة، وجعلها أحد مبانيه العظام التي لا يستقيم إلا بها، ويكفي لبيان قدرها وعظيم شأنها أن ورد ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من ثلاثين موضعا، من ذلك قوله تعالى: \" وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ\" [النور:56] وقوله سبحانه: \" وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ\" [البينة:5]، وقد فُرضت لحكم عظيمة ومنافع عميمة، إذ ليس الهدف منها مجرد جمع المال وتقديمه لمستحقيه من الفقراء والمحتاجين فحسب، وإنما الهدف منها أن يصير الإنسان سيدًا للمال لا عبدًا له، وإن كان ظاهرها نقصان المال، ففي حقيقتها نموه وبركته، فإن أداها المسلم بامتنان واطمئنان، برئت ذمته وفاز برضى المعطي المنان، فالمال ماله سبحانه، والفضل فضله، والجود جوده وكرمه. إلا أنه في وقتنا المعاصر، أصبحت معظم بلداننا الإسلامية تعاني من تعطيل شبه كامل لهذه الفريضة، إما جهلا بأحكامها، أو تهاونا في أدائها، وكان نتيجة ذلك أن استفحل الفقر وازدادت البطالة، فقد أثبتت الإحصائيات أن ما يزيد عن 25 دولة من بلاد المسلمين ترزح تحت وطأة الفقر على الرغم مما تزخر به الأمة من ثروات،فلو أقام المسلمون هذا الركن العظيم من دينهم، لما وجد فيهم فقير مدقع، ولا ذو غرم مفجع. ومن منطلق تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية، دأبت البنوك الإسلامية على الاهتمام بفريضة الزكاة، واعتبرت الدور الذي تقوم به في هذا الإطار منسجما ومتكاملا مع باقي الأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها، بل وجزءا لا يتجزأ من صميم عملها ومهامها، خاصة في ظل غياب دور الدولة في جباية الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، كما هو الحال في العديد من البلدان الإسلامية، حيث تقوم مجموعة من هذه المؤسسات بجمع الأموال الزكوية في صناديق خاصة، لتوزيعها على مستحقيها من مصارفها الشرعية.. ❝ ⏤❞ مقدمة عن الكتاب :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اعتنى ديننا الإسلامي الحنيف بعبادة الزكاة، وجعلها أحد مبانيه العظام التي لا يستقيم إلا بها، ويكفي لبيان قدرها وعظيم شأنها أن ورد ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من ثلاثين موضعا، من ذلك قوله تعالى: ˝ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ˝ [النور:56] وقوله سبحانه: ˝ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ˝ [البينة:5]، وقد فُرضت لحكم عظيمة ومنافع عميمة، إذ ليس الهدف منها مجرد جمع المال وتقديمه لمستحقيه من الفقراء والمحتاجين فحسب، وإنما الهدف منها أن يصير الإنسان سيدًا للمال لا عبدًا له، وإن كان ظاهرها نقصان المال، ففي حقيقتها نموه وبركته، فإن أداها المسلم بامتنان واطمئنان، برئت ذمته وفاز برضى المعطي المنان، فالمال ماله سبحانه، والفضل فضله، والجود جوده وكرمه.
إلا أنه في وقتنا المعاصر، أصبحت معظم بلداننا الإسلامية تعاني من تعطيل شبه كامل لهذه الفريضة، إما جهلا بأحكامها، أو تهاونا في أدائها، وكان نتيجة ذلك أن استفحل الفقر وازدادت البطالة، فقد أثبتت الإحصائيات أن ما يزيد عن 25 دولة من بلاد المسلمين ترزح تحت وطأة الفقر على الرغم مما تزخر به الأمة من ثروات،فلو أقام المسلمون هذا الركن العظيم من دينهم، لما وجد فيهم فقير مدقع، ولا ذو غرم مفجع.
ومن منطلق تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية، دأبت البنوك الإسلامية على الاهتمام بفريضة الزكاة، واعتبرت الدور الذي تقوم به في هذا الإطار منسجما ومتكاملا مع باقي الأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها، بل وجزءا لا يتجزأ من صميم عملها ومهامها، خاصة في ظل غياب دور الدولة في جباية الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، كما هو الحال في العديد من البلدان الإسلامية، حيث تقوم مجموعة من هذه المؤسسات بجمع الأموال الزكوية في صناديق خاصة، لتوزيعها على مستحقيها من مصارفها الشرعية. ❝
⏤ -
❞ فإن زَكاة العلم نشره وإذاعتُه والإبانة عنه، وهي علينا فريضة مُحْكَمة كفريضة زكاة الأموال، نؤدَّيها لوجه الله لا نريدُ منكُم جزاءً ولا شُكُورا.. ❝ ⏤محمود محمد شاكر❞ فإن زَكاة العلم نشره وإذاعتُه والإبانة عنه، وهي علينا فريضة مُحْكَمة كفريضة زكاة الأموال، نؤدَّيها لوجه الله لا نريدُ منكُم جزاءً ولا شُكُورا. ❝
⏤ محمود محمد شاكر -
❞ اقتباس من كتاب ضياع الدين في التعبد بحديث موضوع والاغترار بلفظ مصنوع بقلم د محمد شنطة رمضان لفظ مصنوع استخدمه أناس لتحريف المصطلحات الشرعية عند المسلمين فإن مما أحدثه الناس في زماننا ما قالو عنه شنطة رمضان وان من عظمة دين الإسلام هو تحديد المسميات للاشياء حتي تتضح ملامحها وحكمها الشرعي. وهذا جاء منذ اللحظة الاولي للخليقة يوم أن أخبرالله عز وجل الملائكة بخلق ادم ايذانا ببدء التكاليف. قال تعالي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ نعم ايها السادة فإن تعليم المسميات الكونية والشرعية انما جاء من قبل الله تعالي لابينا ادم عليه السلام فإن الله عز وجل هو الذي علم ادم المسميات الكونية والغرض منها فهو الذي سمي الشمس والقمر ثم قال الشمس والقمر بحسبان وهو الذي سمي النجوم والكواكب وقال عنها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي سمي البحار وقال لتاكلو منه لحما طريق وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وهو الذي خلق الجبال الرواسي الي آخر المسميات كلها التي سماها الله عز وجل لادم كل اسم بمدلوله والهدف من وجوده . فلما نأتي الي المسميات الشرعية فالله عز وجل هو الذي سمي الماء الطهور وهو الباقي علي خلقته فإن خالطه طاهر ممازج صار الماء طاهرا وليس طهورا فإن خالطه نجس صار الماء نجسا وامرنا أن نتطهر بالطهور فقط وليس الطاهر وهو الذي سمي لنا الصلاة والصيام وهو الذي وصف لنا الطريقة وهو الذي سمي الخنزير والكلب وبين الحكم في نجاستهما وهو الذي اباح لنا الإبل والبقر والغنم الي آخر هذه المسميات فلما نأتي الي مسألة الإنفاق محل الكلام الان فالله عز وجل سمي لنا زكاة في المال جعلها من نفس المال وقيمتها ربع العشر تخرج عن بلوغ المال النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب الخالص ووصف لها المصارف الشرعية لهذه الزكاة وجعل اخراج هذه الزكاة فرض فمن جحد إخراجها فهو كافر وهناك زكاة للزروع وهناك زكاة للماشية وهناك زكاة لعروض التجارة وهناك زكاة لكنوز الارض او ما يقال عنه الركاز وهناك زكاة عن الانفس وهي زكاة الفطر ثم وصف لنا مصدر آخر للانفاق وهو أموال الصدقات والتي تعد من السنن وليست فريضة ولا يشترط لها نصاب ولا يشترط لها قيمة ولا يشترط لها حلول الحول عليها ثم هناك مصدر آخر للاتفاق وهو الكفارات التي تجبر بها الذنوب التي فيها تعدي علي شرع الله وحدوده مثل كفارة اليمين المعقدة وكفارة الظهار وكفارة الوطء في نهار رمضان وهناك الفدية التي يفتدي بها المرء نفسه عند العجز عن اداء أمر من الأوامر الإلهية مثل فدية الإفطار في رمضان بسب مرض دائم أو طعن في السن كما قال ربنا وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وكذلك فدية من انتهك محظور من محظورات الاحرام فعليه فدية كما قال ربنا تبارك وتعالي فدية من صيام أو صدقة أو نسك وكذلك فدية الصيد في الحرم أثناء الاحرام ثم هناك مصدر آخر للاتفاق وهو النذور فمن نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه قال تعالي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير وكذلك هناك ذبائح محلله للفقراء مثل الاضحية والعقيقة والوليمة وكلها شرعت من أجل إطعام الفقراء وهناك ذبيحة الهدي الذي يهدي الي فقراء الحرم وهذه المسميات كلها مما شرعه الله عز وجل وسماه للناس وينبغي علي المسلم أن يعلمه ويسميه بما سماه به الله فلما جاء زماننا انما خرج علينا مجددون بما سموه شنطة رمضان بعد أن جمعوا اموالها من اهل الخير والفضل ووصفوا لنا شنطه نسبوها الي شهر رمضان ووضع فيها انواعا من لاطعمة مثل السكر والزيت والشاي والارز والتمر والبقوليات مثل العدس والفول والفاصوليا ومنهم من وضع فرخة مثلجه أو كيلو من اللحوم المجمدة ونحن لا ننكر علي اهل الفضل إطعام الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات انما تعالو بنا نتدبر رؤوس هذه الأموال من اين أتت؟ إذ اننا ما زلنا ملتزمين بالمسمي الشرعي لغة واصطلاحا فمن قال أن هذه أموال زكاة جمعت من الاغنياء رغبة منهم في اطعام الفقراء نقول لكم جزاكم الله خيرا لكن من خول لكم تحويل زكاة المال الي أطعمة فإن الأصل أن زكاة المال تخرجونها مال وزكاة الزروع تخرج كما هي من الزروع وزكاة الماشية تخرج من رؤوس الماشية حتي الركاز وزكاة عروض التجارة تخرج من الأموال وان قلتم انها صدقات جاز لكم إخراجها في اي صورة وفق رغبة صاحب الصدقة وان قلتم نذور فاخرجوها حسب نية من نذر وان قلتم انها كفارات أو فدية فاخرجوها وفق توصيف الفدية أو الكفارة من أوسط ما تطعمون اهليكم ومن هنا نصل الي توصيف شنطة رمضان فهل هذه أموال صدقات فعليكم أن تقولو صدقات الفقراء لكي تميزو بينها وبين أموال الزكوات وكذلك بين أطعمة العقيقة والوليمة والاضحية والتي يجوز للأغنياء أن ياكلو منها علي خلاف أموال الزكاة التي تعد من ارجاس الناس بل ميزوا بين الصدقة والزكاة إذ أن الغني جاز له أن ياكل من أموال الصدقات وتحرم عليه أموال الزكاة لكن هذا اللفظ المصطنع قد استبدله هؤلاء بديلا لكل المصطلحات الشرعية السابق ذكرها ومن هنا وجب التنبيه هذا والله تعالي اعلم انتهي...... ❝ ⏤Dr Mohammed omar Abdelaziz❞ اقتباس من كتاب
ضياع الدين في
التعبد بحديث موضوع
والاغترار بلفظ مصنوع
بقلم د محمد
شنطة رمضان لفظ مصنوع استخدمه أناس
لتحريف المصطلحات الشرعية عند المسلمين
فإن مما أحدثه الناس في زماننا ما قالو عنه شنطة رمضان وان من عظمة دين الإسلام هو تحديد المسميات للاشياء حتي تتضح ملامحها وحكمها الشرعي.
وهذا جاء منذ اللحظة الاولي للخليقة يوم أن أخبرالله عز وجل الملائكة بخلق ادم ايذانا ببدء التكاليف.
قال تعالي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
نعم ايها السادة فإن تعليم المسميات الكونية والشرعية انما جاء من قبل الله تعالي لابينا ادم عليه السلام
فإن الله عز وجل هو الذي علم ادم المسميات الكونية والغرض منها فهو الذي سمي الشمس والقمر ثم قال الشمس والقمر بحسبان
وهو الذي سمي النجوم والكواكب وقال عنها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي سمي البحار وقال لتاكلو منه لحما طريق وتستخرجوا منه حلية تلبسونها
وهو الذي خلق الجبال الرواسي الي آخر المسميات كلها التي سماها الله عز وجل لادم كل اسم بمدلوله والهدف من وجوده .
فلما نأتي الي المسميات الشرعية
فالله عز وجل هو الذي سمي الماء الطهور وهو الباقي علي خلقته فإن خالطه طاهر ممازج صار الماء طاهرا وليس طهورا فإن خالطه نجس صار الماء نجسا وامرنا أن نتطهر بالطهور فقط وليس الطاهر
وهو الذي سمي لنا الصلاة والصيام وهو الذي وصف لنا الطريقة وهو الذي سمي الخنزير والكلب وبين الحكم في نجاستهما وهو الذي اباح لنا الإبل والبقر والغنم الي آخر هذه المسميات
فلما نأتي الي مسألة الإنفاق محل الكلام الان
فالله عز وجل سمي لنا زكاة في المال جعلها من نفس المال وقيمتها ربع العشر تخرج عن بلوغ المال النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب الخالص ووصف لها المصارف الشرعية لهذه الزكاة
وجعل اخراج هذه الزكاة فرض فمن جحد إخراجها فهو كافر
وهناك زكاة للزروع وهناك زكاة للماشية وهناك زكاة لعروض التجارة وهناك زكاة لكنوز الارض او ما يقال عنه الركاز وهناك زكاة عن الانفس وهي زكاة الفطر
ثم وصف لنا مصدر آخر للانفاق وهو أموال الصدقات والتي تعد من السنن وليست فريضة ولا يشترط لها نصاب ولا يشترط لها قيمة ولا يشترط لها حلول الحول عليها
ثم هناك مصدر آخر للاتفاق وهو الكفارات التي تجبر بها الذنوب التي فيها تعدي علي شرع الله وحدوده مثل كفارة اليمين المعقدة وكفارة الظهار وكفارة الوطء في نهار رمضان
وهناك الفدية التي يفتدي بها المرء نفسه عند العجز عن اداء أمر من الأوامر الإلهية
مثل فدية الإفطار في رمضان بسب مرض دائم أو طعن في السن كما قال ربنا وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وكذلك فدية من انتهك محظور من محظورات الاحرام فعليه فدية كما قال ربنا تبارك وتعالي فدية من صيام أو صدقة أو نسك وكذلك فدية الصيد في الحرم أثناء الاحرام
ثم هناك مصدر آخر للاتفاق وهو النذور فمن نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه قال تعالي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير
وكذلك هناك ذبائح محلله للفقراء مثل الاضحية والعقيقة والوليمة وكلها شرعت من أجل إطعام الفقراء
وهناك ذبيحة الهدي الذي يهدي الي فقراء الحرم
وهذه المسميات كلها مما شرعه الله عز وجل وسماه للناس وينبغي علي المسلم أن يعلمه ويسميه بما سماه به الله
فلما جاء زماننا انما خرج علينا مجددون بما سموه شنطة رمضان بعد أن جمعوا اموالها من اهل الخير والفضل ووصفوا لنا شنطه نسبوها الي شهر رمضان ووضع فيها انواعا من لاطعمة مثل السكر والزيت والشاي والارز والتمر والبقوليات مثل العدس والفول والفاصوليا ومنهم من وضع فرخة مثلجه أو كيلو من اللحوم المجمدة
ونحن لا ننكر علي اهل الفضل إطعام الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات
انما تعالو بنا نتدبر رؤوس هذه الأموال من اين أتت؟
إذ اننا ما زلنا ملتزمين بالمسمي الشرعي لغة واصطلاحا
فمن قال أن هذه أموال زكاة جمعت من الاغنياء رغبة منهم في اطعام الفقراء نقول لكم جزاكم الله خيرا لكن من خول لكم تحويل زكاة المال الي أطعمة فإن الأصل أن زكاة المال تخرجونها مال وزكاة الزروع تخرج كما هي من الزروع وزكاة الماشية تخرج من رؤوس الماشية حتي الركاز وزكاة عروض التجارة تخرج من الأموال
وان قلتم انها صدقات جاز لكم إخراجها في اي صورة وفق رغبة صاحب الصدقة
وان قلتم نذور فاخرجوها حسب نية من نذر
وان قلتم انها كفارات أو فدية فاخرجوها وفق توصيف الفدية أو الكفارة من أوسط ما تطعمون اهليكم
ومن هنا نصل الي توصيف شنطة رمضان فهل هذه أموال صدقات فعليكم أن تقولو صدقات الفقراء لكي تميزو بينها وبين أموال الزكوات وكذلك بين أطعمة العقيقة والوليمة والاضحية والتي يجوز للأغنياء أن ياكلو منها علي خلاف أموال الزكاة التي تعد من ارجاس الناس
بل ميزوا بين الصدقة والزكاة إذ أن الغني جاز له أن ياكل من أموال الصدقات وتحرم عليه أموال الزكاة
لكن هذا اللفظ المصطنع قد استبدله هؤلاء بديلا لكل المصطلحات الشرعية السابق ذكرها ومن هنا وجب التنبيه
هذا والله تعالي اعلم
انتهي. ❝
⏤ Dr Mohammed omar Abdelaziz -
❞ حكم الإكرامية الإكرامية عرفا هي: (البقشيش) وهو: ما يُعطى لخادم أو عامل التاجر، أو عامل المطعم، أو المقهى، أو غيره زيادة على أجر السلعة. وتسمى بالفرنسية: Pourboire وبالإنجليزية Tip حكم الإكرامية: الإكرامية ليست من حق العامل، بل هي من حق المالك، يتصرَّف فيها كما يشاء، إما يعطيها للعامل، أو يأخذها لنفسه. دليل حكم الإكرامية: الدليل هو القياس على حديث أبو حميد الساعدي لمَّا قال: اسْتَعْمَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأسْدِ، يُقَالُ له: ابنُ اللُّتْبِيَّةِ، قالَ عَمْرٌو: وَابنُ أَبِي عُمَرَ، علَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: هذا لَكُمْ، وَهذا لِي، أُهْدِيَ لِي، قالَ: فَقَامَ رَسولُ اللهِ ﷺ علَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عليه، وَقالَ: ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فيَقولُ: هذا لَكُمْ، وَهذا أُهْدِيَ لِي، أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ والقياس هو: ردُّ فرعٍ لأصلٍ لعلَّة مشتركة بينهما. والمعنى أنه: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم والعلة المشتركة: بين أخذ إكرامية العمل في الزكاة، والعمل في غيرها، هو أنَّ كلامها عامل وليس مالكا، قال النبي ﷺ في الحديث السابق {ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ}. كذلك أنَّ هذا المال الزائد لولا عمله ما كان ليأخذه، قال النبي ﷺ في الحديث السابق: {أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟}. والمعنى: أنَّ الذي أخذ الإكرامية؛ فإنَّه لو لم يكن يعمل في ذلك المحل أو غيره... ما كان ليأخذها، {أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟}. والفرق بينها: أي: إكرامية العمل في جمع الزكاة، وإكرامية غيرها، أنَّ مالك إكرامية العمل في جمع الزكاة هو كل المسمين، يتصرف فيها ولي الأمر بما شرع الله تعالى فيها، وأمَّا إكرامية غيرها فهي ملك لمالك العمل وهو واحد أو جماعة. كما أنَّ إكرامية غير الزكاة يحق لمالكها التصرف فيها كما يشاء. وأما الإكرامية التي تؤخذ في العمل في جمع الزكاة؛ فإنَّ وليَّ الأمر مقيد بالشرع فيها، وهي ليست من حقه الخاص. وهذه الفروق ليس لها تأثير في أصل العلَّة. حكم أخذ الإكرامية بدون موافقة المالك: حكمها حكم النبي ﷺ حيث قال: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ. أي: حرام أخذها إلا بموافقة المالك. كذلك لا تؤخذُ الإكرامية من المالك بسيف الحياء، أي: بأن يحرجه أمام الناس، فيقول له الملك: خذها هي لك حياء، فقد قال النبي ﷺ: لا يَحِلُّ مالُ امرِيءٍ مُسلمٍ إلَّا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ وقال البعض: ما أُخذَ بسيف الحياء كالذي أخذ بسيف الغصب. وقيل: ما أُخذَ بسيف الحياء فهو حرام. وقيل: ما أُخذَ بسيف الحياء فالنار أولى بهِ، وغير ذلك من الألفاظ. قال ابن حجر الهيتميُّ في «الفتاوى الكبرى»: «ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن مَن أُخذ منه شيءٌ على سبيل الحياء من غير رضًا منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعلَّلوه بأن فيه إكراهًا بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحِسِّي، بل كثيرون يُقابلون هذا السيف ويتحمَّلون مرار جُرحه ولا يقابلون الأوَّل خوفًا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتمَّ الخوف» . الخلاصة: - الإكرامية من حق المالك يتصرف فيها كما يشاء. - لاتؤخذ الإكرامية من المالك إلا بطيب خاطره وعن قناعة منه. - أخذ الإكرامية بدون علم المالك: حرام. هذا واللهُ تعالى أعلى وأعلم كتبه: الدكتور: عصام الدين إبراهيم النقيلي. ❝ ⏤الدُّكتُور: عِصَامُ الدِّينِ إِبْرَاهِيمَ النُّقَيْلِي❞ حكم الإكرامية
الإكرامية عرفا هي: (البقشيش) وهو: ما يُعطى لخادم أو عامل التاجر، أو عامل المطعم، أو المقهى، أو غيره زيادة على أجر السلعة.
وتسمى بالفرنسية:
Pourboire
وبالإنجليزية
Tip
حكم الإكرامية:
الإكرامية ليست من حق العامل، بل هي من حق المالك، يتصرَّف فيها كما يشاء، إما يعطيها للعامل، أو يأخذها لنفسه.
دليل حكم الإكرامية:
الدليل هو القياس على حديث أبو حميد الساعدي لمَّا قال: اسْتَعْمَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأسْدِ، يُقَالُ له: ابنُ اللُّتْبِيَّةِ، قالَ عَمْرٌو: وَابنُ أَبِي عُمَرَ، علَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: هذا لَكُمْ، وَهذا لِي، أُهْدِيَ لِي، قالَ: فَقَامَ رَسولُ اللهِ ﷺ علَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عليه، وَقالَ: ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فيَقولُ: هذا لَكُمْ، وَهذا أُهْدِيَ لِي، أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ
والقياس هو: ردُّ فرعٍ لأصلٍ لعلَّة مشتركة بينهما.
والمعنى أنه: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم
والعلة المشتركة: بين أخذ إكرامية العمل في الزكاة، والعمل في غيرها، هو أنَّ كلامها عامل وليس مالكا، قال النبي ﷺ في الحديث السابق ﴿ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ﴾.
كذلك أنَّ هذا المال الزائد لولا عمله ما كان ليأخذه، قال النبي ﷺ في الحديث السابق: ﴿أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟﴾.
والمعنى: أنَّ الذي أخذ الإكرامية؛ فإنَّه لو لم يكن يعمل في ذلك المحل أو غيره.. ما كان ليأخذها، ﴿أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟﴾.
والفرق بينها: أي: إكرامية العمل في جمع الزكاة، وإكرامية غيرها، أنَّ مالك إكرامية العمل في جمع الزكاة هو كل المسمين، يتصرف فيها ولي الأمر بما شرع الله تعالى فيها، وأمَّا إكرامية غيرها فهي ملك لمالك العمل وهو واحد أو جماعة.
كما أنَّ إكرامية غير الزكاة يحق لمالكها التصرف فيها كما يشاء.
وأما الإكرامية التي تؤخذ في العمل في جمع الزكاة؛ فإنَّ وليَّ الأمر مقيد بالشرع فيها، وهي ليست من حقه الخاص.
وهذه الفروق ليس لها تأثير في أصل العلَّة.
حكم أخذ الإكرامية بدون موافقة المالك:
حكمها حكم النبي ﷺ حيث قال: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ.
أي: حرام أخذها إلا بموافقة المالك.
كذلك لا تؤخذُ الإكرامية من المالك بسيف الحياء، أي: بأن يحرجه أمام الناس، فيقول له الملك: خذها هي لك حياء، فقد قال النبي ﷺ: لا يَحِلُّ مالُ امرِيءٍ مُسلمٍ إلَّا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ
وقال البعض: ما أُخذَ بسيف الحياء كالذي أخذ بسيف الغصب.
وقيل: ما أُخذَ بسيف الحياء فهو حرام.
وقيل: ما أُخذَ بسيف الحياء فالنار أولى بهِ، وغير ذلك من الألفاظ.
قال ابن حجر الهيتميُّ في «الفتاوى الكبرى»: «ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن مَن أُخذ منه شيءٌ على سبيل الحياء من غير رضًا منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعلَّلوه بأن فيه إكراهًا بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحِسِّي، بل كثيرون يُقابلون هذا السيف ويتحمَّلون مرار جُرحه ولا يقابلون الأوَّل خوفًا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتمَّ الخوف» .
الخلاصة:- الإكرامية من حق المالك يتصرف فيها كما يشاء.- لاتؤخذ الإكرامية من المالك إلا بطيب خاطره وعن قناعة منه.هذا واللهُ تعالى أعلى وأعلم- أخذ الإكرامية بدون علم المالك: حرام.
كتبه:
الدكتور: عصام الدين إبراهيم النقيلي. ❝
⏤ الدُّكتُور: عِصَامُ الدِّينِ إِبْرَاهِيمَ النُّقَيْلِي