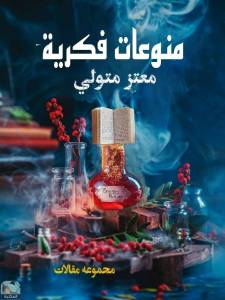❞ منوعات فكرية ❝ 💬 اقتباسات من الكتب 📖
- منوعات فكرية 💬 اقتباسات من الكتب 📖
█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2025
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
اقتباسات في ❞منوعات فكرية❝
-
❞ الصراع الثقافى في عالمنا أصبح للثقافة أهمية خاصة في إدارة العلاقات بين الأفراد وداخل المجتمع الواحد، وبين المجتمعات المختلفة ودورها في كيفية إدارة العلاقات الدولية، فإن الثقافة هوية ولغة لابد من تواجدها بين الشعوب يعيش العالم العربي والإسلامي عالمين متناقضين، حاملا ثقافتين متباعدتين يصعب التقريب بينهما، ثقافة تراثية مفعمة بالمواطنة الأصلية وأخرى غربية فردية مصطنعة، وبين العالمين يقف الإنسان العربي عاجزا بين ماضية التراثي وبين العصرنة المغتربة عنه، فيصبح فاقدا للشخصية الثقافية، غير قادر على التأقلم مع الماضي أو التعايش مع الآخرين ؛ إن الثقافة محورا هاما في مجتمعاتنا لذلك يجب أن تحرص المجتمعات علي إرساء وتأكيد ثقافتها وهويتها بما تحمله من ماضيها العريق لدى كل الأفراد سواء كان طفل أو شاب أو عجوز بإختلاف مهامهم داخل المجتمع؛ حيث إن الإزدواجية الثقافية لدى الفرد تحدث نقصا فكرى وعلمى وتربوى لديه مما ينتج عنه أزمات فردية وعامة داخل عالمنا العربي والإسلامي ؛ ومن هنا يحدث الصراع الثقافى عن طريق الهيمنة بالقوة علي الثقافات التقليدية والمتوارثة عبر الأجيال، بهدف طمس هوية الشعوب وتغريب الإنسان وعزلة عن قضاياه المحورية والأساسية وإدخال الضعف لديه، ويحدث ذلك أيضا نتيجة لوجود وسائل وأساليب تعمل علي إحداث خلل في العمليات الثقافية والعلمية والإقتصادية والإعلامية والتربوية لعالمنا العربي والإسلامي، والذى ينتج عنه نوعا من الإزدواجية الثقافية وتغيير ملامح الثقافة الوطنية، وتشكيك الإنسان في جميع قناعاته الدينية والوطنية والأيديولوجية ؛ وقد تعددت آليات الهيمنة علي ثقافة عالمنا كما وكيفا، فمثلا نجد إهتمام الغرب بالثقافة العربية والإسلامية مقدمة ووسيلة للغزو الفكرى للمجتمع، وبالفعل إستطاعت الثقافة الغربية من التأثير علي بعض المثقفين والكتاب والمفكرين وتكوين نخبة مثقفة في مجمعاتنا يحملون أفكارهم لدرجة أنهم يرون أن طريق التقدم والأزدهار الوحيد في رفض التراث كله والتنكر للماضي برمته يتضح لنا مما سبق أن الثقافة سلاح ذو حدين مع أو ضد الشعوب والمجتمعات، فإذا كانت الثقافة راسخة وثابتة في قوام المجتمع وبين أفرادة، وتعمل تلك الثقافة علي تحقيق التكافؤ بين تراثها وماضيها والتقدم العصرى في مختلف المجالات علميا وإقتصاديا وتربويا.... وغيرها، نجد المجتمع مزدهر ومتقدم، أما إذا كانت الثقافة ضد المجتمع فاللآسف يظهر الصراع الثقافى والإزدواجية الثقافية.. ❝ ⏤معتز متولي❞ الصراع الثقافى في عالمنا
أصبح للثقافة أهمية خاصة في إدارة العلاقات بين الأفراد وداخل المجتمع الواحد، وبين المجتمعات المختلفة ودورها في كيفية إدارة العلاقات الدولية، فإن الثقافة هوية ولغة لابد من تواجدها بين الشعوب
يعيش العالم العربي والإسلامي عالمين متناقضين، حاملا ثقافتين متباعدتين يصعب التقريب بينهما، ثقافة تراثية مفعمة بالمواطنة الأصلية وأخرى غربية فردية مصطنعة، وبين العالمين يقف الإنسان العربي عاجزا بين ماضية التراثي وبين العصرنة المغتربة عنه، فيصبح فاقدا للشخصية الثقافية، غير قادر على التأقلم مع الماضي أو التعايش مع الآخرين ؛
إن الثقافة محورا هاما في مجتمعاتنا لذلك يجب أن تحرص المجتمعات علي إرساء وتأكيد ثقافتها وهويتها بما تحمله من ماضيها العريق لدى كل الأفراد سواء كان طفل أو شاب أو عجوز بإختلاف مهامهم داخل المجتمع؛ حيث إن الإزدواجية الثقافية لدى الفرد تحدث نقصا فكرى وعلمى وتربوى لديه مما ينتج عنه أزمات فردية وعامة داخل عالمنا العربي والإسلامي ؛
ومن هنا يحدث الصراع الثقافى عن طريق الهيمنة بالقوة علي الثقافات التقليدية والمتوارثة عبر الأجيال، بهدف طمس هوية الشعوب وتغريب الإنسان وعزلة عن قضاياه المحورية والأساسية وإدخال الضعف لديه،
ويحدث ذلك أيضا نتيجة لوجود وسائل وأساليب تعمل علي إحداث خلل في العمليات الثقافية والعلمية والإقتصادية والإعلامية والتربوية لعالمنا العربي والإسلامي، والذى ينتج عنه نوعا من الإزدواجية الثقافية وتغيير ملامح الثقافة الوطنية، وتشكيك الإنسان في جميع قناعاته الدينية والوطنية والأيديولوجية ؛
وقد تعددت آليات الهيمنة علي ثقافة عالمنا كما وكيفا، فمثلا نجد إهتمام الغرب بالثقافة العربية والإسلامية مقدمة ووسيلة للغزو الفكرى للمجتمع، وبالفعل إستطاعت الثقافة الغربية من التأثير علي بعض المثقفين والكتاب والمفكرين وتكوين نخبة مثقفة في مجمعاتنا يحملون أفكارهم لدرجة أنهم يرون أن طريق التقدم والأزدهار الوحيد في رفض التراث كله والتنكر للماضي برمته
يتضح لنا مما سبق أن الثقافة سلاح ذو حدين مع أو ضد الشعوب والمجتمعات، فإذا كانت الثقافة راسخة وثابتة في قوام المجتمع وبين أفرادة، وتعمل تلك الثقافة علي تحقيق التكافؤ بين تراثها وماضيها والتقدم العصرى في مختلف المجالات علميا وإقتصاديا وتربويا.. وغيرها، نجد المجتمع مزدهر ومتقدم، أما إذا كانت الثقافة ضد المجتمع فاللآسف يظهر الصراع الثقافى والإزدواجية الثقافية. ❝
⏤ معتز متولي -
❞ الفروق الفردية المدرسية الفروق الفردية هى التباين الذى يميز فرد عن غيره فى السمات والقدرات سواء كانت عقلية أو جسمية أو متعلقة بالفروق الإجتماعية والإقتصادية وغيرها ، فإن الفروق الفردية القائمة بين الأفراد تعتمد على تحديد الصفة التى نريد دراستها ثم نقيس مدى تفوق أو ضعف الفرد فى هذه الصفة ، وعندما نحدد مستويات الأفراد فى صفة ما ، فإننا نكون بذلك قد حددنا الفروق القائمة بينهم بالنسبة لتلك الصفة ومنها نستطيع إيجاد والتعامل مع الفروق الفردية بين الأفراد كى يحقق كل منهم أقصى ما يمكن تحقيقه من الأهداف التربوية الموضوعية . تعد المدرسة هى المؤسسة الرئيسية والثانية بعد الأسرة فى تشكيل الفروق الفردية ومسؤلية إعداد الأفراد الإعداد السليم ، فإن لها أدوار متعددة وأهمها حتى وإن لم تكن مسؤلة عن الوصول بالفرد ( التلميذ ) إلى أقصى درجات التعليم ، فهى مجبره على تنشئته التنشئة السليمة الصحيحه ، لكى لا يصير المجتمع مسرح للتطرف والانحراف والعنصرية والتأخر ، ويعيش فى التخلف العلمي والإجتماعي وما شابه ، وهنا تكمن مسؤلية الإدارة المدرسية فى تحقيق ما عليها من التزامات فى غاية الأهمية ( فالإدارة إرادة ) إرادة فى تحقيق النظام والفكر المستنير وتطبيق اللوائح والقوانين المدرسية فنحن نشرع ولا ننفذ مما يتعارض مع القدرة على اكتشاف وتنمية الفروق والقدرات والتنشئة السليمة . إرادة فى نمو وإعداد الأفراد مما يتفق مع مطالب النمو فى مراحله المختلفة من اكتساب أساليب السلوك الوجدانى والمعرفى لتحقيق تعلم المهارات وتكوين العادات . ويؤدي المعلم الدور الأساسي فى تحقيق الإرادة والمطالب من خلال مسؤلياته كمربي ، وما تحدده له وظائفه المتعددة ، فمن خلال عمله اليومي مع التلاميذ يستطيع معرفة المشكلات التى تواجههم سواء كانت تعليمية معرفية أو اجتماعية انفعالية ، كما يستطيع أيضآ التعامل مع التلاميذ المتفوقين أو المتخلفين ؛ وبالتالي تكون لديه القدرة على الحكم على الفروق الفردية بينهم والتعامل مع هذه الفروق بما يحقق الكفاية والفاعلية لجميع التلاميذ في جميع الأنشطة الاجتماعية والتعليمية . ولما كانت المدرسة ، وكان المعلم يتعامل داخل الفصل الدراسي ، لا مع تلاميذ أفراد وإنما مع مجموعات تتكون من أفراد بينهم عدد من الفروق ، تصبح هذه الفروق أمرا ضروريا يجب دراسة أنواعها المختلفة ونظرياتها والعوامل التى تكمن ورائها وطرق قياسها ، وطرق العمل على ضوئها ؛ فمما لا شك فيه وبالتأكيد أنه كلما زادت معرفة المدرس بهذه الفروق كلما سهل عليه تدريب التلاميذ وكيفية التعامل معهم وتوجيههم نحو تحقيق الأغراض التربوية المختلفة.. ❝ ⏤معتز متولي❞ الفروق الفردية المدرسية
الفروق الفردية هى التباين الذى يميز فرد عن غيره فى السمات والقدرات سواء كانت عقلية أو جسمية أو متعلقة بالفروق الإجتماعية والإقتصادية وغيرها ، فإن الفروق الفردية القائمة بين الأفراد تعتمد على تحديد الصفة التى نريد دراستها ثم نقيس مدى تفوق أو ضعف الفرد فى هذه الصفة ، وعندما نحدد مستويات الأفراد فى صفة ما ، فإننا نكون بذلك قد حددنا الفروق القائمة بينهم بالنسبة لتلك الصفة ومنها نستطيع إيجاد والتعامل مع الفروق الفردية بين الأفراد كى يحقق كل منهم أقصى ما يمكن تحقيقه من الأهداف التربوية الموضوعية .
تعد المدرسة هى المؤسسة الرئيسية والثانية بعد الأسرة فى تشكيل الفروق الفردية ومسؤلية إعداد الأفراد الإعداد السليم ، فإن لها أدوار متعددة وأهمها حتى وإن لم تكن مسؤلة عن الوصول بالفرد ( التلميذ ) إلى أقصى درجات التعليم ، فهى مجبره على تنشئته التنشئة السليمة الصحيحه ، لكى لا يصير المجتمع مسرح للتطرف والانحراف والعنصرية والتأخر ، ويعيش فى التخلف العلمي والإجتماعي وما شابه ، وهنا تكمن مسؤلية الإدارة المدرسية فى تحقيق ما عليها من التزامات فى غاية الأهمية ( فالإدارة إرادة )
إرادة فى تحقيق النظام والفكر المستنير وتطبيق اللوائح والقوانين المدرسية فنحن نشرع ولا ننفذ مما يتعارض مع القدرة على اكتشاف وتنمية الفروق والقدرات والتنشئة السليمة .
إرادة فى نمو وإعداد الأفراد مما يتفق مع مطالب النمو فى مراحله المختلفة من اكتساب أساليب السلوك الوجدانى والمعرفى لتحقيق تعلم المهارات وتكوين العادات .
ويؤدي المعلم الدور الأساسي فى تحقيق الإرادة والمطالب من خلال مسؤلياته كمربي ، وما تحدده له وظائفه المتعددة ، فمن خلال عمله اليومي مع التلاميذ يستطيع معرفة المشكلات التى تواجههم سواء كانت تعليمية معرفية أو اجتماعية انفعالية ، كما يستطيع أيضآ التعامل مع التلاميذ المتفوقين أو المتخلفين ؛ وبالتالي تكون لديه القدرة على الحكم على الفروق الفردية بينهم والتعامل مع هذه الفروق بما يحقق الكفاية والفاعلية لجميع التلاميذ في جميع الأنشطة الاجتماعية والتعليمية .
ولما كانت المدرسة ، وكان المعلم يتعامل داخل الفصل الدراسي ، لا مع تلاميذ أفراد وإنما مع مجموعات تتكون من أفراد بينهم عدد من الفروق ، تصبح هذه الفروق أمرا ضروريا يجب دراسة أنواعها المختلفة ونظرياتها والعوامل التى تكمن ورائها وطرق قياسها ، وطرق العمل على ضوئها ؛ فمما لا شك فيه وبالتأكيد أنه كلما زادت معرفة المدرس بهذه الفروق كلما سهل عليه تدريب التلاميذ وكيفية التعامل معهم وتوجيههم نحو تحقيق الأغراض التربوية المختلفة. ❝
⏤ معتز متولي -
❞ مبررات إنسانية إجتمع إخوة سيدنا يوسف عليه السلام حين تآمروا على قتل أخيهم الغلام، ودون الدخول في التفسير الدينى كانت آلية التبرير الإنساني حاضرة بتلك القصة، فلابد عليهم من البحث عن مبرر يجمل قبح جريمتهم فى أنفسهم، ويكون عونا لهم حتى لا يترددوا بتنفيذها، حين إعتقدوا أنهم بقتله سيتقربون أكثر من أبيهم ويكونوا من بعده فى مأمن ورضا، فأوجدوا المبرر فى قوله تعالى (8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9) ، وهذا السبب لم يكن كافيا ليحقق لهم الإستقرار النفسى، ويخلصهم من وطأة الذنب، فشرعت الفطرة الإنسانية لآخوة سيدنا يوسف عليه السلام فى البحث عن مبرر آخر إنساني لا أخلاقى يخدعون به أنفسهم ليسكتوا صوت الفطرة الذى يغص مضاجعهم فكان المبرر وجوابهم بعد سنين طويلة قال تعالى \" إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ \" قولهم هذا ليكون دافع أقوى، فهناك دافع أعمق من مجرد الهروب من العقاب، وهو الهروب من الإنسانية نفسها، فالتبرير هنا \" لوم الظروف \" أو \" لوم الطبيعة البشرية \" مما يعتبر هروب إنساني لا أخلاقى يتعدى كل حدود الآدمية، إن التبرير إعطاء مبررات للدوافع والسلوكيات فى محاولة التخلص من الأفكار المزعجة أو المشاعر المؤلمة، فالتبرير سلوك وأسلوب دفاعى يستخدمه الإنسان لتقليل الإحساس بالذنب والتوتر الناشئ عن الأخلاق فى الوصول إلى الهدف، وتنشأ تلك الحالة من السلوك نتيجة عدم قدرة الفرد فى مواجهة نفسه أو أمام الآخرين بفشله فى الوصول إلى غايته، فضلا عن أن الموقف الذى لم ينجح فيه الفرد في الوصول إلى توقعاته قد يؤدي به إلى الإحباط، وذلك أمر غير مرغوب فيه من أجل الصحة النفسية للإنسان، حيث بواسطته يقوم الفرد هنا بتحليل معتقداته أو أفعالة بإبداء أسباب غير تلك التي سببتها أو أثارتها، وعن طريق خلق المبررات الإنسانية، وبالتالي يكون قادرا على تقديم التعللات المسببة لإخفاقه ومن ثم يحافظ على دفاعية الأنا، فالتبرير عند الإنسان كغيره من العديد من ميكانزمات التوافق قد يبالغ في إستخدامه ؛ كما أنه أيضا يجب أن نعلم أن التبرير سلوك متعدد الألوان والأشكال، فتوجد مبررات كاذبة بلا إنسانية، وهناك أيضا مبررات تقتصد إلى حد ما الحقيقة، وفي هذه الحالة يكون الفرد غير راضي عما تحصل عليه، ولكنه يظهر ويصر على أن كل شيء على مايرام، فمثلا تعمل في مكان أو شئ غير مريح وأنت غير راضي عنه ولكنك بالفعل تعمل وتصرح أنك تحب عملك، أو قد تشتري شئ لايعجبك ولكنك بالفعل أشتريته .. ❝ ⏤معتز متولي❞ مبررات إنسانية
إجتمع إخوة سيدنا يوسف عليه السلام حين تآمروا على قتل أخيهم الغلام، ودون الدخول في التفسير الدينى كانت آلية التبرير الإنساني حاضرة بتلك القصة، فلابد عليهم من البحث عن مبرر يجمل قبح جريمتهم فى أنفسهم، ويكون عونا لهم حتى لا يترددوا بتنفيذها، حين إعتقدوا أنهم بقتله سيتقربون أكثر من أبيهم ويكونوا من بعده فى مأمن ورضا، فأوجدوا المبرر فى قوله تعالى
(8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9)
، وهذا السبب لم يكن كافيا ليحقق لهم الإستقرار النفسى، ويخلصهم من وطأة الذنب، فشرعت الفطرة الإنسانية لآخوة سيدنا يوسف عليه السلام فى البحث عن مبرر آخر إنساني لا أخلاقى يخدعون به أنفسهم ليسكتوا صوت الفطرة الذى يغص مضاجعهم فكان المبرر وجوابهم بعد سنين طويلة قال تعالى
˝ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ˝ قولهم هذا ليكون دافع أقوى، فهناك دافع أعمق من مجرد الهروب من العقاب، وهو الهروب من الإنسانية نفسها، فالتبرير هنا ˝ لوم الظروف ˝ أو ˝ لوم الطبيعة البشرية ˝ مما يعتبر هروب إنساني لا أخلاقى يتعدى كل حدود الآدمية،
إن التبرير إعطاء مبررات للدوافع والسلوكيات فى محاولة التخلص من الأفكار المزعجة أو المشاعر المؤلمة، فالتبرير سلوك وأسلوب دفاعى يستخدمه الإنسان لتقليل الإحساس بالذنب والتوتر الناشئ عن الأخلاق فى الوصول إلى الهدف، وتنشأ تلك الحالة من السلوك نتيجة عدم قدرة الفرد فى مواجهة نفسه أو أمام الآخرين بفشله فى الوصول إلى غايته، فضلا عن أن الموقف الذى لم ينجح فيه الفرد في الوصول إلى توقعاته قد يؤدي به إلى الإحباط، وذلك أمر غير مرغوب فيه من أجل الصحة النفسية للإنسان، حيث بواسطته يقوم الفرد هنا بتحليل معتقداته أو أفعالة بإبداء أسباب غير تلك التي سببتها أو أثارتها، وعن طريق خلق المبررات الإنسانية، وبالتالي يكون قادرا على تقديم التعللات المسببة لإخفاقه ومن ثم يحافظ على دفاعية الأنا، فالتبرير عند الإنسان كغيره من العديد من ميكانزمات التوافق قد يبالغ في إستخدامه ؛
كما أنه أيضا يجب أن نعلم أن التبرير سلوك متعدد الألوان والأشكال، فتوجد مبررات كاذبة بلا إنسانية، وهناك أيضا مبررات تقتصد إلى حد ما الحقيقة، وفي هذه الحالة يكون الفرد غير راضي عما تحصل عليه، ولكنه يظهر ويصر على أن كل شيء على مايرام، فمثلا تعمل في مكان أو شئ غير مريح وأنت غير راضي عنه ولكنك بالفعل تعمل وتصرح أنك تحب عملك، أو قد تشتري شئ لايعجبك ولكنك بالفعل أشتريته. ❝
⏤ معتز متولي -
❞ الأفكار التسلطية كتب ا. معتز متولي الأفكار التسلطية تعني وجود فكرة غير منطقية لا تلبث أن تعاود الفرد وتسيطر عليه إلى حد الذى يشعر معه الفرد بنوع من العبودية أو الإنقياد لها، وإلى الحد الذى يجعله لا يستطيع أن يفكر أو يعمل عملا إيجابيا مفيدا ؛ يخيل للشخص أنه قام بفعل ما، وهو فى الحقيقية لم يقم به، وتبدأ محاكمته الأخلاقية لنفسه على هذا الفعل ويبدأ تأنيب الضمير بغزو ذهنة، فنجد أن هؤلاء ممن يسيطر عليهم الفكر التسلطى يعانون من إضطراب وخلل عضوى بالمخ يملأ عقولهم بأفكار غير مرغوبة وغير موجودة وتهديدات بالضياع والمرض، لو لم يقوموا بأفعال متكررة وغير منطقية، ولا معنى لها بل وأحيانا حمقاء . تعد العوامل السلوكية من أسباب الأفكار التسلطية حيث تجد الفرد يعتاد على طقوس معينة وأعمال يفعلها بإستمرار دون توقف بطريقة لا إرادية، ولا يستطيع أن يتوقف عنها، بالإضافة إلى النواقل العصبية، يشعر بعض العصابيين بأنهم مدعوون للقيام ببعض الأعمال بغض النظر عن حقيقة غير منطقية أو لا معنى لها، إلى جانب العوامل الوراثية والعوامل النفسية . أما عن ظواهر وأشكال الأفكار التسلطية ؛ شخص ما يهتم بصحته إهتماما غير سوى ومبالغ فيه، فهو يستيقظ في الصباح شاعرا بالإجهاد وينتقل من طبيب لآخر دون أن يستفيد شيئا، وتمتلئ خزانة الدواء عنده بمختلف الأدوية أو يتخلص من جميع الأدوية التى توصف له دون أن يستخدمها، ويمكن القول بأنه إنسان يتوهن المرض يستمتع بإعتلاء صحته، ومن المحتمل أن يعترض بشدة على أى إنسان يقول له إن صحته جيدة . طالب التعليم بمراحلة المختلفة نتيجة القلق العصابى الذى يجعله في حاله ثابتة تقريبا من الخوف والترقب والقلق، فهو قد يظل متعلقا بدرجة شديدة بالنسبة لدرجاته التحصيلية أو بالنسبة لإمكانيته فى تكوين أصدقاء من زملائه، وما إن انتقل إلى مرحلته الجامعية ينتابه الشعور بالخوف من المجهول فى إمكانية إعتمادة على ذاته . تصل الأفكار التسلطية بالإنسان إلى حد تصور أشياء مخيفة ورهيبة عن الذات الإلهية أو الأنبياء أو الدين أو الأخلاق أو العلم لايمكن دفعها، فالنظام العقلي للفرد فى تلك الحالة يسود فيه الأوهام والهلاوس حيث يسيطر الخيال أساسا على السلوك، وهنا يرى الفرد في شئ ما أنه غير مريح بالنسبة له بناءا على أفكار وتصورات بنيت فى عقلية هذا الفرد ليس نقصا منه ولكن تسلط فكرى وإنحرافات فكرية . ليس من المجدى فى علاج الإنحرافات الفكرية الذهنية الخاصة بالأفكار التسلطية تناول الأعراض مباشرة، بل من الضروري إكتشاف الصراعات والإحباطات التى يعانيها الفرد والوقوف على جميع الظروف والأحداث المحيطة به والتى مر بها في حياته، ثم محاولة مساعدته لحلها والتخلص منها .. ❝ ⏤معتز متولي❞ الأفكار التسلطية
كتب ا. معتز متولي
الأفكار التسلطية تعني وجود فكرة غير منطقية لا تلبث أن تعاود الفرد وتسيطر عليه إلى حد الذى يشعر معه الفرد بنوع من العبودية أو الإنقياد لها، وإلى الحد الذى يجعله لا يستطيع أن يفكر أو يعمل عملا إيجابيا مفيدا ؛ يخيل للشخص أنه قام بفعل ما، وهو فى الحقيقية لم يقم به، وتبدأ محاكمته الأخلاقية لنفسه على هذا الفعل ويبدأ تأنيب الضمير بغزو ذهنة، فنجد أن هؤلاء ممن يسيطر عليهم الفكر التسلطى يعانون من إضطراب وخلل عضوى بالمخ يملأ عقولهم بأفكار غير مرغوبة وغير موجودة وتهديدات بالضياع والمرض، لو لم يقوموا بأفعال متكررة وغير منطقية، ولا معنى لها بل وأحيانا حمقاء .
تعد العوامل السلوكية من أسباب الأفكار التسلطية حيث تجد الفرد يعتاد على طقوس معينة وأعمال يفعلها بإستمرار دون توقف بطريقة لا إرادية، ولا يستطيع أن يتوقف عنها، بالإضافة إلى النواقل العصبية، يشعر بعض العصابيين بأنهم مدعوون للقيام ببعض الأعمال بغض النظر عن حقيقة غير منطقية أو لا معنى لها، إلى جانب العوامل الوراثية والعوامل النفسية .
أما عن ظواهر وأشكال الأفكار التسلطية ؛
شخص ما يهتم بصحته إهتماما غير سوى ومبالغ فيه، فهو يستيقظ في الصباح شاعرا بالإجهاد وينتقل من طبيب لآخر دون أن يستفيد شيئا، وتمتلئ خزانة الدواء عنده بمختلف الأدوية أو يتخلص من جميع الأدوية التى توصف له دون أن يستخدمها، ويمكن القول بأنه إنسان يتوهن المرض يستمتع بإعتلاء صحته، ومن المحتمل أن يعترض بشدة على أى إنسان يقول له إن صحته جيدة .
طالب التعليم بمراحلة المختلفة نتيجة القلق العصابى الذى يجعله في حاله ثابتة تقريبا من الخوف والترقب والقلق، فهو قد يظل متعلقا بدرجة شديدة بالنسبة لدرجاته التحصيلية أو بالنسبة لإمكانيته فى تكوين أصدقاء من زملائه، وما إن انتقل إلى مرحلته الجامعية ينتابه الشعور بالخوف من المجهول فى إمكانية إعتمادة على ذاته .
تصل الأفكار التسلطية بالإنسان إلى حد تصور أشياء مخيفة ورهيبة عن الذات الإلهية أو الأنبياء أو الدين أو الأخلاق أو العلم لايمكن دفعها، فالنظام العقلي للفرد فى تلك الحالة يسود فيه الأوهام والهلاوس حيث يسيطر الخيال أساسا على السلوك، وهنا يرى الفرد في شئ ما أنه غير مريح بالنسبة له بناءا على أفكار وتصورات بنيت فى عقلية هذا الفرد ليس نقصا منه ولكن تسلط فكرى وإنحرافات فكرية .
ليس من المجدى فى علاج الإنحرافات الفكرية الذهنية الخاصة بالأفكار التسلطية تناول الأعراض مباشرة، بل من الضروري إكتشاف الصراعات والإحباطات التى يعانيها الفرد والوقوف على جميع الظروف والأحداث المحيطة به والتى مر بها في حياته، ثم محاولة مساعدته لحلها والتخلص منها. ❝
⏤ معتز متولي -
❞ الثقافة الإجتماعية الثقافة الإجتماعية جزءا هام في حياتنا اليوميه لاتنتهي أبدا تتجدد دائما مع تغيير الأفراد والحقب الزمنية والظروف البيئية، فهى عملية إبداعية متجددة تعبر عن آداب الحياة الإجتماعية؛ حيث أن الثقافة بمفهومها الإجتماعي تعكس مدى معرفة أبناء المجتمع للمنظومة الإجتماعية التى يعيشون فيها من عادات وتقاليد ولغة وأعراف ومكتسبات ونظم إجتماعية سائدة تطغى على المكونات الشخصية والسلوكية الفردية لأفراد المجتمع دون أن تخل تلك المكتسبات الشخصية والأطر العامة التى تحرك السلوك العام في المجتمع بالثوابت العامة والرئيسية كالعقائد الدينية والتشريعات والقوانين الوضعية....وغيرها، وينبغي على أفراد المجتمع أن يتماشوا مع التجديد بهدف التطوير والتعايش والبناء يقول العالم الإجتماعي البريطاني الانثربولوجى ˝لإدوارد تايلور ˝ [ الثقافة أو الحضارة بمعناها الإناسى الأوسع، هى ذلك الكل المركب الذى يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والأعراف والقدرات والعادات الأخرى التى يكتسبها الإنسان بإعتباره عضوا في المجتمع ] إن الثقافة الإجتماعية ليست مجموعة من الأفكار فحسب ولكنها نظرية في السلوك ترسم طريق الحياة إجمالا. ولم تعد ثقافتتا الإجتماعية منغلقة على نفسها، معزولة عما يدور حولها من متغيرات في جميع مجالات الحياة، وذلك في ظل ظروف العصر الحديث والتقدم العلمي والتكنولوجي وثورة الإتصالات وهنا يمكننا القول أن الثقافة تمثل قوام الحياة الإجتماعية وظيفة وحركة، فليس من عمل إجتماعي يتم خارج دائرتها، حيث تيسر للإنسان سبل التفاعل مع محيطة مادة وبشرا ومؤسسات إن السلوكيات الإجتماعية اليومية للأفراد تعتمد على مدى ثقافتهم الإجتماعية وإدراكهم لطبيعة الأمور التى يتواجدون فيها بتعاملهم فيما بينهم وتقبلهم للآخر والحوار، وتسخيرهم للمقدرات الطبيعية مما يجعل الفرد يستطيع أن يحقق التوازن بين نفسه والمجتمع الذى يعيش فيه.. ❝ ⏤معتز متولي❞ الثقافة الإجتماعية
الثقافة الإجتماعية جزءا هام في حياتنا اليوميه لاتنتهي أبدا تتجدد دائما مع تغيير الأفراد والحقب الزمنية والظروف البيئية، فهى عملية إبداعية متجددة تعبر عن آداب الحياة الإجتماعية؛ حيث أن الثقافة بمفهومها الإجتماعي تعكس مدى معرفة أبناء المجتمع للمنظومة الإجتماعية التى يعيشون فيها من عادات وتقاليد ولغة وأعراف ومكتسبات ونظم إجتماعية سائدة تطغى على المكونات الشخصية والسلوكية الفردية لأفراد المجتمع دون أن تخل تلك المكتسبات الشخصية والأطر العامة التى تحرك السلوك العام في المجتمع بالثوابت العامة والرئيسية كالعقائد الدينية والتشريعات والقوانين الوضعية..وغيرها، وينبغي على أفراد المجتمع أن يتماشوا مع التجديد بهدف التطوير والتعايش والبناء
يقول العالم الإجتماعي البريطاني الانثربولوجى ˝لإدوارد تايلور ˝
[ الثقافة أو الحضارة بمعناها الإناسى الأوسع، هى ذلك الكل المركب الذى يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والأعراف والقدرات والعادات الأخرى التى يكتسبها الإنسان بإعتباره عضوا في المجتمع ]
إن الثقافة الإجتماعية ليست مجموعة من الأفكار فحسب ولكنها نظرية في السلوك ترسم طريق الحياة إجمالا. ولم تعد ثقافتتا الإجتماعية منغلقة على نفسها، معزولة عما يدور حولها من متغيرات في جميع مجالات الحياة، وذلك في ظل ظروف العصر الحديث والتقدم العلمي والتكنولوجي وثورة الإتصالات
وهنا يمكننا القول أن الثقافة تمثل قوام الحياة الإجتماعية وظيفة وحركة، فليس من عمل إجتماعي يتم خارج دائرتها، حيث تيسر للإنسان سبل التفاعل مع محيطة مادة وبشرا ومؤسسات
إن السلوكيات الإجتماعية اليومية للأفراد تعتمد على مدى ثقافتهم الإجتماعية وإدراكهم لطبيعة الأمور التى يتواجدون فيها بتعاملهم فيما بينهم وتقبلهم للآخر والحوار، وتسخيرهم للمقدرات الطبيعية مما يجعل الفرد يستطيع أن يحقق التوازن بين نفسه والمجتمع الذى يعيش فيه. ❝
⏤ معتز متولي