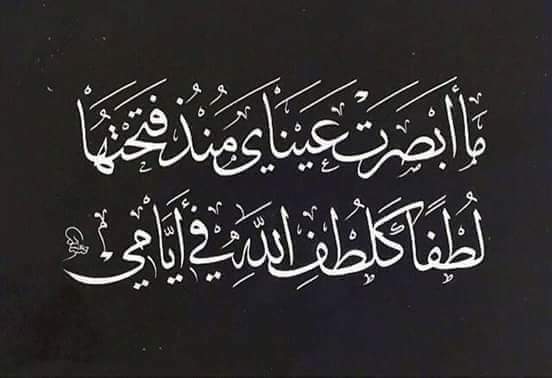❞ Envy ❝ 💬 اقتباسات من الكتب 📖
- Envy 💬 اقتباسات من الكتب 📖
█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2025
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
اقتباسات في ❞Envy❝
-
❞ خيرية أهل المغرب في هذا الزلزال ( أبو الحسن هشام المحجوبي و أبو مريم عبدالكريم صكاري) بسم الله الرحمن الرحيم في كل محنة منحة لقد أظهر هذا الزلزال خيرا كبيرا و عميقا في نفوس هذه الأمة الكريمة، جميع فئات الشعب تألمت و بكت و بذلت المال و الجهد لجبر خواطر المنكوبين و هذا الخير المستحكم أصله من قيم الإسلام العظيم الذي تشبعت به أرض المغرب الطيبة و الذي ينبغي أن نقيّمه و نتفكر فيه كيف نستمر في هذا الخير و في هذا العطاء السخي حتى نقضي على زلزال الجهل و الفقر و البطالة و الحسد و الحقد و البغضاء و الأزمة الأخلاقية بتوجيهات و ارشادات علمائنا و شيوخنا و فقهائنا و حكمائنا و خبرائنا و نشطاء المجتمع المدني باختصار نخبة أهل المغرب ، نحن متأكدون أن الناس ينتظرون من يوجههم و يضع لهم السكة حتى ينطلق قطار الخير و العطاء و البناء و الإصلاح وتكون هذه الصحوة نموذجا لجميع أمم الأرض. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. In every trial, there is a blessing. This earthquake has revealed a great and profound goodness in the hearts of this noble nation. All segments of the population have felt pain, shed tears, and contributed money and effort to alleviate the suffering of the affected. This strong goodness stems from the values of Islam, which have saturated the land of Morocco, and which we should appreciate and contemplate in order to continue this goodness and generous giving, and to eradicate the earthquake of ignorance, poverty, unemployment, envy, hatred, animosity, and moral crisis. This can be achieved through the guidance and instructions of our scholars, sheikhs, jurists, wise men, experts, and civil society activists - in short, the elite of the Moroccan people. We are confident that people are waiting for someone to guide them and set the path for them, so that the train of goodness, giving, construction, and reform can depart. May this awakening serve as a model for all nations on Earth.. ❝ ⏤بستان علم النبوءة❞ خيرية أهل المغرب في هذا الزلزال ( أبو الحسن هشام المحجوبي و أبو مريم عبدالكريم صكاري)
بسم الله الرحمن الرحيم في كل محنة منحة لقد أظهر هذا الزلزال خيرا كبيرا و عميقا في نفوس هذه الأمة الكريمة، جميع فئات الشعب تألمت و بكت و بذلت المال و الجهد لجبر خواطر المنكوبين و هذا الخير المستحكم أصله من قيم الإسلام العظيم الذي تشبعت به أرض المغرب الطيبة و الذي ينبغي أن نقيّمه و نتفكر فيه كيف نستمر في هذا الخير و في هذا العطاء السخي حتى نقضي على زلزال الجهل و الفقر و البطالة و الحسد و الحقد و البغضاء و الأزمة الأخلاقية بتوجيهات و ارشادات علمائنا و شيوخنا و فقهائنا و حكمائنا و خبرائنا و نشطاء المجتمع المدني باختصار نخبة أهل المغرب ، نحن متأكدون أن الناس ينتظرون من يوجههم و يضع لهم السكة حتى ينطلق قطار الخير و العطاء و البناء و الإصلاح وتكون هذه الصحوة نموذجا لجميع أمم الأرض.
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. In every trial, there is a blessing. This earthquake has revealed a great and profound goodness in the hearts of this noble nation. All segments of the population have felt pain, shed tears, and contributed money and effort to alleviate the suffering of the affected. This strong goodness stems from the values of Islam, which have saturated the land of Morocco, and which we should appreciate and contemplate in order to continue this goodness and generous giving, and to eradicate the earthquake of ignorance, poverty, unemployment, envy, hatred, animosity, and moral crisis. This can be achieved through the guidance and instructions of our scholars, sheikhs, jurists, wise men, experts, and civil society activists - in short, the elite of the Moroccan people. We are confident that people are waiting for someone to guide them and set the path for them, so that the train of goodness, giving, construction, and reform can depart. May this awakening serve as a model for all nations on Earth. ❝
⏤ بستان علم النبوءة -
❞ موانع النجاح مع الله (الشيخ هشام المحجوبي) بسم الله الرحمن الرحيم في دراستي لكتب علماءنا العارفين بالله تجد ان تشخيصهم و تقييمهم للموانع التي تمنع الإنسان من الإرتقاء في درجات ولاية الرحمان و التقوى و الإحسان تدور على مرضين مرض الشهوة و مرض الشبهة فالمصاب بالمرض الأول يتصف بطباع حيوانية تجعل نفسه تميل الى السفالة و الإغراق في التفكير في إشباع غرائزه و شهواته و خطر هذا المرض أنه يزين لصاحبه إستباحة الفواحش و المنكرات و المحرمات و إن لم يصل بالإنسان الى المستوى الحرام فإنه يضيع عليه أوقات كثيرة و طاقات كبيرة كان الأولى أن تُسْثَتْمر في عمل الآخرة هذا النوع يجعل الإنسان مسجونا في سجن من الملذات بتصورات متجددة لا تنتهي لا تزيد الإنسان الا رغبة فيما بعدها (ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب )و دواء هذا المرض هو الزُهد في الدنيا و الإهتمام بالآخرة و شغل الأوقات بالطاعات (قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها) و اما المرض الثاني فينحرف فهم صاحبه الى عقائد و ضلالات تهواها نفسه أحيانا بسبب حب الثورة على الواقع أو حب التميز بشيء لم يأت به أحد أو بسبب حسَد الإنسان لعلماء الدين و شيوخه ، و خُبث النفس لا حد له و دواء هذا المرض الصدق في طلب الحق و دراسة اصول الدين و اصول الفقه اللهم اننا نعوذ بك من الفواحش و الضلالات و في الأخير علينا ان نعلم ان الدنيا قصيرة و حقيرة فإياك ان تبيع آخرتك بها ( وللآخرة خير لك من الأولى و لسوف يعطيك ربك فترضى ) The obstacles to success with Allah (Sheikh Hisham Mahjoubi) In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Lust and the disease of suspicion. Taboo, even if a person does not reach the forbidden level, he wastes many times and great energies on him. The hollow of the son of Adam fills with nothing but dust (the cure for this disease is asceticism in this world, concern for the afterlife, and preoccupation with the times of acts of obedience (the one who purifies it has succeeded, and the one who indexes it) has been disappointed. The delusions that he loves himself sometimes because of the love of revolution against reality or the love of excellence in something that no one has brought, or because of man’s envy of religious scholars and elders, and the malice of the soul is limitless. We seek refuge in You from immorality and delusions, and in the end, we must know that the world is short and despicable, so beware of selling your hereafter (and the Hereafter is better for you than the first, and your Lord will give you, and you will be satisfied. ❝ ⏤بستان علم النبوءة❞ موانع النجاح مع الله (الشيخ هشام المحجوبي)
بسم الله الرحمن الرحيم
في دراستي لكتب علماءنا العارفين بالله تجد ان تشخيصهم و تقييمهم للموانع التي تمنع الإنسان من الإرتقاء في درجات ولاية الرحمان و التقوى و الإحسان تدور على مرضين مرض الشهوة و مرض الشبهة فالمصاب بالمرض الأول يتصف بطباع حيوانية تجعل نفسه تميل الى السفالة و الإغراق في التفكير في إشباع غرائزه و شهواته و خطر هذا المرض أنه يزين لصاحبه إستباحة الفواحش و المنكرات و المحرمات و إن لم يصل بالإنسان الى المستوى الحرام فإنه يضيع عليه أوقات كثيرة و طاقات كبيرة كان الأولى أن تُسْثَتْمر في عمل الآخرة هذا النوع يجعل الإنسان مسجونا في سجن من الملذات بتصورات متجددة لا تنتهي لا تزيد الإنسان الا رغبة فيما بعدها (ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب )و دواء هذا المرض هو الزُهد في الدنيا و الإهتمام بالآخرة و شغل الأوقات بالطاعات (قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها) و اما المرض الثاني فينحرف فهم صاحبه الى عقائد و ضلالات تهواها نفسه أحيانا بسبب حب الثورة على الواقع أو حب التميز بشيء لم يأت به أحد أو بسبب حسَد الإنسان لعلماء الدين و شيوخه ، و خُبث النفس لا حد له و دواء هذا المرض الصدق في طلب الحق و دراسة اصول الدين و اصول الفقه اللهم اننا نعوذ بك من الفواحش و الضلالات و في الأخير علينا ان نعلم ان الدنيا قصيرة و حقيرة فإياك ان تبيع آخرتك بها ( وللآخرة خير لك من الأولى و لسوف يعطيك ربك فترضى )
The obstacles to success with Allah (Sheikh Hisham Mahjoubi) In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Lust and the disease of suspicion. Taboo, even if a person does not reach the forbidden level, he wastes many times and great energies on him. The hollow of the son of Adam fills with nothing but dust (the cure for this disease is asceticism in this world, concern for the afterlife, and preoccupation with the times of acts of obedience (the one who purifies it has succeeded, and the one who indexes it) has been disappointed. The delusions that he loves himself sometimes because of the love of revolution against reality or the love of excellence in something that no one has brought, or because of man’s envy of religious scholars and elders, and the malice of the soul is limitless. We seek refuge in You from immorality and delusions, and in the end, we must know that the world is short and despicable, so beware of selling your hereafter (and the Hereafter is better for you than the first, and your Lord will give you, and you will be satisfied. ❝
⏤ بستان علم النبوءة -
❞ ملخص كتاب ❞الموت وطقوسه من خلال صحيحي البخاري ومسلم❝، بقلم أيمن العتوم
في الفصل الثّالث من الكتاب تتحدّث الباحثة عن: (الموت والتّصوّرات الأخرويّة)، وتقدّم لهذا الفصل بالحديث عن الزّمن، وهو – في رأيي – مأخوذٌ على نحوٍ ما من تعريف إخوان الصّفا للزّمن في كتابهم المشهور: (رسائل إخوان الصّفا). تقول الباحثة: "ليس الزّمن في الإسلام دائريًّا صِرْفًا، فيه عَوْدٌ على بدء أبديّ، وتداول بين الحياة والموت كما هو الشّأن في بعض الأديان غير السّماويّة، بل إنّه زمنٌ خطّيٌّ يمكن أن نرمز إليه بمحورٍ زمنيٍّ يبتدئ بولادة الإنسان، ويمتدّ إلى ما بعد موته، لأنّ موته دخولٌ في زمنٍ آخر لعلّه أهمّ من الأوّل، بل لعلّ حياته لا تعدو أن تكون نقطةً في هذا المحور كما سنرى، وليس هذا المحور نهايةً طبعًا، وإن كان استقرار الإنسان بأحد فضائي الآخرة – الجنّة أو النّار – هو آخر المطاف بعد سلسلة من الأحداث الأخرويّة".
الموت وطقوسه (2):
تتعرّض الباحثة في هذا الفصل الثّالث لقضيّة عذاب القبر، فهي تُبته، وتؤمن به ابتداءً، ولكنّها تثير مسألة: ما إذا كان العذاب للجسد أم للرّوح أم لكليهما؟ وها هي تقول: "ولكن أريد من حديث أنسٍ أن يكون دليلاً على أنّ العذاب المذكور في القرآن الكريم يلحق بالجسد لا بالرّوح، وهذا هو رأي الأغلبيّة السّنّيّة، وهو الّذي ينتصر له البخاريّ والمُحدِّثون، بخلاف الرّأي القائل بأنّ العذاب يلحق بالرّوح". وتواصل الباحثة رحلة استنتاجاتها الغريبة، والّتي توحي لِمَنْ يقرؤها بأنّها مستمدّة بذكاء من صحيحًي البخاريّ ومسلم، ولكن تبقى إشارات الاستفهام تدور حولها، واسمعها حين تريد أن تُقنِعنا بأنّ فكرة عذاب القبر لم تكن موجودة في ذهن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وأنّها جاءت متأخّرة حوالي السّنة (10هـ) وأنّه استمدّها من اليهود، وهو كلامٌ يجب الوقوف طويلاً عنده قبل أخذه أو الاقتناع به، وها هي تتفلسف: "فعذاب القبر حسب مجموعةٍ من المرويّات تعود إلى عائشة عقيدةٌ يهوديّةٌ تبنّاها محمّد وإن استغربها في البداية. تقول عائشة: دخل عليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وعندي امرأة من اليهود، وهي تقول: هل شعرتم أنّكم تُفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقال: إنّما تُفتن يهود. قالت عائشة: فلبثْنا ليالي، ثمّ قال صلّى الله عليه وسلّم: هل شعرتُ أنّه أوحي إليّ أنّكم تُفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يستعيذ من عذاب القبر". قلت: ليس ارتياع الرّسول صلّى الله عليه وسلّم دليلاً على إنكاره لعذاب القبر أو لعدم علمه بوجوده، بل – والله أعلم – لعلمه بشدّة هذا العذاب، فتعوّذ منه وارتاع. تُثبِت الباحثة أنّ صلاة الجنازة الواردة عن الرّسول صلّى الله عليه سلّم بأربع تكبيرات، وفي بعض الرّوايات بخمس، كانت موجودة في الجاهليّة، وأنّها مِمّا أبقى عليه الإسلام ولم يُغيّرْه أو يُبطلْه وتعتقد الباحثة أنّ الإنسان يموت ثلاث مرّات، فأمّا المرّة الأولى، فهي أمام النّاس في الحياة الدُّنيا حيثُ يوارَى التّراب… والمرّة الثّانية هي بعد أن يُوارَى التّراب تُعاد إليه روحه ليستعدّ لسؤال المَلَكَيْن اللَّذَيْن يسألانه عن ربّه وعن نبيّه وعن كتابه… ثمّ يموت بعدها… والمرّة الثالثة هي حينَ يُحاسَب تعود إليه روحه فيُحاسَب، وبعد الحساب يموت… حتّى تُعاد إليه روحه فيدخل بعدها الجنّة أو النّار… وهذا رأيٌ غريبٌ لم أسمعه من قبلُ. فأمّا أنّه تعود إليه روحه في القبر ليُواجِه سؤال المَلَكَيْن، فهذا نعرفه وقرأناه، ولكنّ الجديد استنتاج الكاتبة أنّه يموت بعدها، وعلى هذا الرّأي بَنَتْ استنتاجًا مفاده: أنّ عذاب القبر ليس مستمرًّا ولا مُتواصِلاً، لأنّ هناك موتًا ثالثًا ينتظره؛ هذا الموت الثّالث طلعَتْ الباحثة به علينا مُستَنتِجةً إيّاه من قوله صلّى الله عليه وسلّم: "ليس أحدٌ يُحاسَب يومَ القيامة إلاّ هَلَك، فقالت عائشة: يا رسول الله: أليس قد قال الله تعالى: (فأمّا مَنْ أوتِيَ كتابه بيمينه فسوف يُحاسَبُ حِسابًا يسيرًا)؟ فقال: إنّما ذلك العَرْض، وليس أحدٌ يُناقَش الحِسابَ يومَ القيامة إلاّ عُذِّب". فهذا الموت يكون يومَ القيامة، لا إثْرَ سؤال المَلَكَيْن؛ فهو الموت الثّالث وليس الثّاني". وتتساءل الباحثة في بعض مواطن الكِتاب تساؤل العارف المتغابي، حينَ نقول أيُعقَل أن يكون جِهادُ إنسانٍ طوال حياته، يُساوي لحظةً واحدةً يقتل فيها نفسه، وهي هنا تتساءل – بِخُبْثٍ – عن موطن العَدْلِ في ذلك. اسمعها وهي تتفلسَف في قصّة ذلك الصّحابيّ الّذي قاتل بشراسةٍ وشدّة منقطعة النّظير في إحدى المعارك، ثمّ قال عنه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (هو في النّار)، وحينَ رجعوا إليه، وجدوه قد قتل نفسَه. تقول الباحثة: "وليس هذا المبدأ عقليًّا؛ لأنّه يجعل عمل الإنسان طوالَ سنينَ من حياته مُعادِلاً للحظاته الأخيرة. ولكنّه يدلّ على أيّة حالٍ على تشدّدٍ في النّهي عن قتل النّفس". والباحثة في موضعٍ آخر من الكتاب ترى أنّ الأدعية الّتي يتلوها المرء في حالات المرض أو مرض الموت هي عبارة عن نشاطٍ سحريّ، تقول: "فمنها ما يتّسم بطابعٍ قوليٍّ كالمُعوِّذات والأدعية لأنّ الأساس فيها هو الكلام، ومنها ما يُشبه الوصفات الطّبّيّة وإنْ كان لا يخلو من نشاطٍ سحريّ". وحينَ دعا الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لسعدٍ بالشّفاء من المرض ثلاث مرّاتٍ بقوله: (اللّهمّ اشفِ سعدًا اللّهمّ اشفِ سعدًا اللّهمّ اشفِ سعدًا ثلاث مرّات) تقول الباحثة إنّ هذا التّكرار الثلاثيّ (الوِتر) نوعٌ من النّشاط السّحريّ. ها هي تتذاكي: "والسّجع والازدواج نوعان من التّكرار كما لا يخفى؛ فالأوّل تكرار للفواصل، والثّاني تكرار لبنية تركيبيّة. والتّكرار من خصائص الخِطاب السّحريّ، ولعلّ المقصود بها إعادة تنظيم العالَم الّذي يقوم على عودة الفصول، ودورة الأفلاك، وتداول اللّيل والنّهار؛ أي التّكرار، أو لعلّ المقصود به تهدئة القوى المُراد إخضاعُها حتّى تُجيبَ الطّلب". "فكأنّ الإسلام لم يتخلّ تمامًا عن إرث الجاهليّة السّحريّ، بل أخذ منه عناصر جعلها مع العناصر السّماويّة التّوحيديّة جنبًا إلى جنب". وتُثبِت الباحثة أنّ صلاة الجنازة الواردة عن الرّسول صلّى الله عليه سلّم بأربع تكبيرات، وفي بعض الرّوايات بخمس، كانت موجودة في الجاهليّة، وأنّها مِمّا أبقى عليه الإسلام ولم يُغيّرْه أو يُبطلْه. تقول: "وذَكرَ أنّهم كانوا يُصلُّون على موتاهم، وكانت صلاتُهم أن يُحمَلَ الميّت على سرير، ثمّ يقوم وليّه فيَذكُرُ محاسنه كلّها، ويُثني عليه، ثمّ يقول: عليه رحمة الله، ثمّ يُدفَن". وتنقل كلام أحد الباحثين، وهو جواد علي فتقول إنّ: "صلاة الجنازة عرفها العربُ في الجاهليّة وأقرّها الإسلام". حرّكت الكاتبة في عقولنا شيئًا ما، و استطاعت أنْ تُعيد صياغة بعض الأفكار الّتي توارَثْناها، وأوقفَتْنا أمام بعض الحقائق بطريقة المفاجأة وتتعرّض الكاتبة – في بعض ما تعرّضت له – إلى البكاء على الميّت من قِبَل النّساء، وتبيّن أنّ ذلك عملٌ مسرحيٌّ، كان الواجب يمليه على النّساء، وخاصّة إذا ما شاركَتْ إحداهنّ الأخرى بهذه الوظيفة، واسمعْها قائلةً: "وقد يكون هذا البكاء واجبًا تؤدّيه امرأة في حقّ امرأةٍ أخرى، تُوفِّيَ عنها أحد أقربائها، وسبقَ لها أنْ شارَكَتْ هذه المرأة في البكاء على ميّت، فهو بمثابة الدَّيْن. يُقرَض ثم يُستَرَدّ. وهذا معنى (الإسعاد): "بايعْنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقرأ علينا ألاّ يُشرِكْنَ بالله شيئًا، ونهانا عن النِّياحة، فقبضت امرأةٌ يدها فقالت: أسعدَتْني فلانةٌ أريد أن أجزِيَها. فما قال لها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم شيئًا. فانطلقتْ ورجَعَتْ فبايَعها". والباحثة في نهاية كتابها، تَخلُصُ إلى مجموعةٍ من النّتائج، تُفرِدُ لها ما يقرب من (40) صفحةً، غير أنّه يُمكن تلخيص بعض ما جاء في هذه النّتائج، من خلال الفقرات المقتبَسَة الآتية: "فطقوس الموت كما صوّرها الصّحيحان تحمل بصفةٍ عامّةٍ طابع البداوة العربيّة ذات المؤسَّسات البسيطة، ولكنّها تعكس أيضًا موقف الرّسول صلّى الله عليه وسلّم منها. فقد حدّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم من دور الطّقوس، ومن مجال تطبيقها، فجعل حِداد المرأة على غير زوجها لا يزيد على ثلاثة أيّام، وحِدادها على زوجها أربعة أشهرٍ وعشرًا بعد أن كان يدوم حولاً كاملاً. وقد غلب النّهي على تشريعه لعلاقة الأحياء بالميّت؛ فنهى عن البكاء، ونهى عن بناء القبور، ونهى عن الصّلاة إليها… إلخ، وكلّ ذلك خوفًا من أن ترتدّ أمّته عن التّوحيد إلى الوثنيّة، كبني إسرائيل الّذين عبدوا عِجْلاً من دون الله، أو الكثير من الأمم البائدة الّتي ذكرها القرآن، ووصف العذاب الّذي سلّطه الله عليها". وتقول في موضعٍ آخر من هذه النّتائج: "فحياة المسلم كما يُصوّرها الصّحيحان، أو كما يريدها الإسلام تمرّ على وتيرةٍ واحدةٍ، ولا تَحَوُّلَ فيها سوى الموت. وهي مُتّجهةٌ نحو الآخرة أكثر من اتّجاهها نحو أيّ شيءٍ آخر. وقد بيّنّا في الفصل الثّالث من القسم الأوّل مدى حضور التّصوّرات الأخرويّة في الأذهان، ومدى ضآلة الموت نفسه إذا ما قُورِنَ بالأحداث الّتي تعقبه من عذابٍ في القبر، وبعثٍ، وموتٍ ثان]، وموتٍ ثالثٍ، وحياةٍ أخرى. وقد رسمْنا مِحورًا لحياة الفرد كما يُصوّرها الصّحيحان ولاحظْنا أنّ الحياة الدّنيا لا تشغل إلاّ حيِّزًا صغيرًا منه". وبعد هذا التّطواف في الكتاب، يُمكننا القول: إنّ الباحثة لم تأخذ بالمُسَلَّمات، ولم تترك الأمور على ما فسّره الأقدمون من كِبار المُفسّرين، وعلماء الحديث، وحاولتْ أن تخرج بنتائج خاصّة بما وَعَتْه مِمّا قرأت في الصّحيحَيْن حول الموت، وأنا أقول: إنّها أصابت وأخطأت، واقتربتْ وابتعدَتْ، شأنَ أيّ مجتهد وباحث. ولولا أنّها حرّكت في عقولنا شيئًا ما أخذنا بشيءٍ مِمّا قالت، غير أنّها استطاعت أنْ تُعيد صياغة بعض الأفكار الّتي توارَثْناها، وأوقفَتْنا أمام بعض الحقائق بطريقة المفاجأة… ولا أدعو الله إلا أن يغفر لنا ولها، وأن يُبصّرنا، فإنّما ضلّ كثيرون بما زيّن لهم الشّيطان سوء أعمالهم فرأوها حَسَنة.. ❝ ⏤رجاء بن سلامةملخص كتاب ❞الموت وطقوسه من خلال صحيحي البخاري ومسلم❝، بقلم أيمن العتوم
في الفصل الثّالث من الكتاب تتحدّث الباحثة عن: (الموت والتّصوّرات الأخرويّة)، وتقدّم لهذا الفصل بالحديث عن الزّمن، وهو – في رأيي – مأخوذٌ على نحوٍ ما من تعريف إخوان الصّفا للزّمن في كتابهم المشهور: (رسائل إخوان الصّفا). تقول الباحثة: "ليس الزّمن في الإسلام دائريًّا صِرْفًا، فيه عَوْدٌ على بدء أبديّ، وتداول بين الحياة والموت كما هو الشّأن في بعض الأديان غير السّماويّة، بل إنّه زمنٌ خطّيٌّ يمكن أن نرمز إليه بمحورٍ زمنيٍّ يبتدئ بولادة الإنسان، ويمتدّ إلى ما بعد موته، لأنّ موته دخولٌ في زمنٍ آخر لعلّه أهمّ من الأوّل، بل لعلّ حياته لا تعدو أن تكون نقطةً في هذا المحور كما سنرى، وليس هذا المحور نهايةً طبعًا، وإن كان استقرار الإنسان بأحد فضائي الآخرة – الجنّة أو النّار – هو آخر المطاف بعد سلسلة من الأحداث الأخرويّة".الموت وطقوسه (2) تتعرّض الباحثة في هذا الفصل الثّالث لقضيّة عذاب القبر، فهي تُبته، وتؤمن به ابتداءً، ولكنّها تثير مسألة: ما إذا كان العذاب للجسد أم للرّوح أم لكليهما؟ وها هي تقول: "ولكن أريد من حديث أنسٍ أن يكون دليلاً على أنّ العذاب المذكور في القرآن الكريم يلحق بالجسد لا بالرّوح، وهذا هو رأي الأغلبيّة السّنّيّة، وهو الّذي ينتصر له البخاريّ والمُحدِّثون، بخلاف الرّأي القائل بأنّ العذاب يلحق بالرّوح". وتواصل الباحثة رحلة استنتاجاتها الغريبة، والّتي توحي لِمَنْ يقرؤها بأنّها مستمدّة بذكاء من صحيحًي البخاريّ ومسلم، ولكن تبقى إشارات الاستفهام تدور حولها، واسمعها حين تريد أن تُقنِعنا بأنّ فكرة عذاب القبر لم تكن موجودة في ذهن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وأنّها جاءت متأخّرة حوالي السّنة (10هـ) وأنّه استمدّها من اليهود، وهو كلامٌ يجب الوقوف طويلاً عنده قبل أخذه أو الاقتناع به، وها هي تتفلسف: "فعذاب القبر حسب مجموعةٍ من المرويّات تعود إلى عائشة عقيدةٌ يهوديّةٌ تبنّاها محمّد وإن استغربها في البداية. تقول عائشة: دخل عليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وعندي امرأة ....... [المزيد]
قراءة ملخص كتاب الموت وطقوسه من خلال صحيحي البخاري ومسلم ⏤ رجاء بن سلامة -
❞ بسم الله الرحمن الرحيم ، يقول سبحانه و تعالى (و لا تبخسو الناس اشياءهم) الوجه الثاني في تفسير هذه الآية لا تحتقر اعمال الناس و أموالهم و أنسابهم و أولادهم و عاداتهم وتقاليدهم فهذه الصفة القبيحة تدل على الكبر و الحسد و تشيع بين الناس الفشل و نزول الهمة فشجع الإنسان إن رأيت خيرا أو إصمت . \"كتب هذه التغريدة الشيخ هشام المحجوبي المراكشي \" In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Allah, may He be glorified and exalted, says, \"And do not depreciate people\'s belongings.\" The second aspect of interpreting this verse is to not belittle people\'s deeds, wealth, lineage, children, customs, and traditions. This vile attribute indicates arrogance and envy, spreading failure and demotivation among people. Therefore, encourage others when you see goodness or remain silent. This tweet was written by Sheikh Hisham Al-Mahjoubi Al-Marrakchi #IslamicTeachings #RespectingOthers #AvoidingArrogance #Envy #Encouragement. ❝ ⏤بستان علم النبوءة❞ بسم الله الرحمن الرحيم ، يقول سبحانه و تعالى (و لا تبخسو الناس اشياءهم) الوجه الثاني في تفسير هذه الآية لا تحتقر اعمال الناس و أموالهم و أنسابهم و أولادهم و عاداتهم وتقاليدهم فهذه الصفة القبيحة تدل على الكبر و الحسد و تشيع بين الناس الفشل و نزول الهمة فشجع الإنسان إن رأيت خيرا أو إصمت .
˝كتب هذه التغريدة الشيخ هشام المحجوبي المراكشي ˝
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
Allah, may He be glorified and exalted, says, ˝And do not depreciate people˝s belongings.˝ The second aspect of interpreting this verse is to not belittle people˝s deeds, wealth, lineage, children, customs, and traditions. This vile attribute indicates arrogance and envy, spreading failure and demotivation among people. Therefore, encourage others when you see goodness or remain silent.
This tweet was written by Sheikh Hisham Al-Mahjoubi Al-Marrakchi
#IslamicTeachings #RespectingOthers #AvoidingArrogance #Envy #Encouragement. ❝
⏤ بستان علم النبوءة -
❞ ملخص كتاب ❞الموت وطقوسه من خلال صحيحي البخاري ومسلم❝، بقلم أيمن العتوم
(الموت وطقوسه؛ من خلال صحيحَي البُخاريّ ومُسلِم) للدّكتورة رجاء بن سلامة، والمؤلّفة تونسيّة، وباحثة أدبيّة، ومحلّلة نفسيّة. يتكوّن الكتاب من حوالي (300) ثلاثمئة صفحة من القطع الصّغير، ويبدو أنّه دراسةٌ قامت بها الكاتبة في مرحلة الماجيستير أو الدكتوراه، وقد كان الباعث – مِمّا استنتجتُه من مقدّمة الكتاب – على القيام بهذه الدّراسة هو موت والدها. وقد ناقشت فيه الموت بطريقة فلسفيّة عقديّة خالية من القناعات المسبقة ومعتمدةً اعتمادًا كلّيًّا على صحيحَي البخاريّ ومُسلِم، وهذا ما أعطى بحثها شرعيّةً ومصداقيًّةً عاليَتَيْن، ومع أنّ الكتاب يحرّك خلايا الذّهن، ويوقد شعلة التّفكير أو إعادة التّفكير في فهم النّصوص، إلاّ أنّ بعض هذه التّفسيرات والتّأويلات الّتي أتت بها الكاتبة بدت جريئة جدًّا وخطيرة …
الموت وطقوسه (1):
لا أكتم أحدًا سرًّا إنْ قلتُ: إنّني توقَّفْتُ مليًّا عند هذه التّحليلات وتباينت مواقفي تُجاهها، أيّدتُها أحيانًا، أعُجِبْتِ بها أحيانًا أخرى… خِفتُ منها أحيانًا ثالثة… وفي كلّ الأحوال فتحتْ عيني على مقدار الجهل الّذي كنتُ أعيشه بعيدًا عن رياض هذين الصّحيحَيْن اللّذين لا يعرف منهما كثيرٌ من النّاس إلاّ بعض الأحاديث المشهورة، وأنا أوّل هؤلاء… ولهذا السّبب فقد قرّرتُ أو قُلْ تشجَّعْتُ لإعادة قراءتهما والغوص في محيطهما، واستخراج كنوزهما النبويّة الثّمينة.. كنتُ كلّما قرأتُ حديثًا أو بعض حديثٍ لم يمرّ عليّ سابقًا، ويُدهشني بأسلوبه، ومضمونه، كنتُ أردّد مع الشّافعيّ: كُلّما أَدَّبَنِي الدَّهْـــرُ أَرانِي نَقْصَ عَقْلِي وَإِذا مَا ازْدَدْتُ عِلْمًا زَادَنِي عِلْمًا بِجَهْلِي الموتُ مفارقةٌ عجيبةٌ؛ فهو يقين، يقين لا يمكن التّيقّن من فحواه، بما أنّ الذّات إذ تموت ينعدم وعيها. وهو يقين ينفي نفسه، لأنّ الذّات تعلم أنّها مائتة لا محالة، ولكنّها لا تستطيع تصوّر فنائها تقول المؤلّفة في كتابها عن كتابها مشيدةً به، وبطريقتها في عرض ما خلصتْ إليه: "إنّه يبقى دراسةً مختلفةً عن الكمّ الهائل من الكتب الصّفراء عذاب القبر وأشراط السّاعة وأهوال القيامة والعوالم الأخرويّة، إضافةً إلى كتب الحجاب وذمّ النّساء، وكلّ ما ساهمَ في انتشار الخوف والشّعور بالإثم، وانتشار العصاب الوسواسيّ الدّينيّ، وهو ما غَذّتْهُ الفضائيّات العربيّة بدُعاتِها وخطبائها. هؤلاء الدّعاة والخُطباء لا يتحدّثون عن الموت باعتباره خاتمةً، بقَدْرِ ما يجعلون الحياة موتًا مستديمًا قبل الموت، أو رقصة موتٍ مُقدَّس". تُحاول الكاتبة في بعض صفحات الكِتاب أن تُقارِنَ بين المُتشابهات في اللّفظ في هذين الصّحيحَيْن، لتتساءل عن العلاقة بينها، معتمدةً في ذلك طريقة المُفاجأة في إلقاء اللّفظة في وجه القارئ، لكنّها تتغافل – حين تفعل ذلك – عن سعةِ اللغة في إلقاء الظّلال على الكلمات المُتشابهة حتّى تعود – وهي هي من حيثُ اللّفظ – لا علاقة تربط بين واحدةٍ ونظيرتها … واسمع إليها تَتَفَذْلَكُ في هذا الموضوع من خلال هذا الكلام، تقول: "الموتُ مفارقةٌ عجيبةٌ؛ فهو يقين، و(اليقين) اسمٌ من أسمائه في مُدوّنة الحديث، ولكنّه أوّلاً يقين لا يمكن التّيقّن من فحواه، بما أنّ الذّات إذ تموت ينعدم وعيها. وهو ثانيًا يقين ينفي نفسه، لأنّ الذّات تعلم أنّها مائتة لا محالة، ولكنّها لا تستطيع تصوّر فنائها وقد تُنكره، لا لأنّه مريرٌ مأساويٌّ فحسب، بل لأمرٍ آخر انفرد فرويد بذكره عندما كتب: في لا شعورِ كلّ واحدٍ منّا إقرارٌ بخلوده. فالإنسان سواء كان مؤمنًا بالبعث أو غيرَ مؤمنٍ به يُقرّ في أعماق نفسه بخلوده". أمّا أنا فأرى أنّ كلام فرويد يجب أن يُعدّل، إلى أنّ الإنسان لا يُقرّ في أعماق ذاته أنّه خالدٌ، ولكنّه يُخَيّل له ذلك، أضفْ إلى أنّه يسعى إلى ذلك وهو يعلم أنّ سعيه سوف يصير هباءً، إذ إنّه لم يخرج عن دائرة الموت أحدٌ بما فيهم الأنبياء، ولم يُفلِت من حومة الفناء بشرٌ أبدًا… وتحاول الكاتبة في بعض مواضع الكتاب أن تطعن في صحيحَي البُخاريّ ومسلم، من خلال نقلها كلامًا لمستشرقين أو أجانب يلمزون بالصّحيحَين دون أن تردّ عليه، أو تناقشه، أو تبيّن عواره، وهذا يدخل من باب دسّ السُّمّ في الدّسم، فها هي تقول في أحد مقولاتها: "يقول دوزي: يرى أكثر النّقّاد تشدّدًا أنّ نصفَ أحاديث البخاريّ صحيحة". أقول: فما معنى هذا الكلام …؟! وما الكلام المخبوء خلفه؟! ألا تريد هذه الكاتبة أن تقول لنا من وراء سِتار: بما أنّ نصف أحاديث البخاري صحيحة؛ فإنّ نصفها الآخر غير ذلك!!! انظر إلى التّمويه وإلى التّدليس، وصحيحٌ أنّ هذا الكلام ليس لها، ولكنّها لم تُفنّدْه؛ بل على العكس من ذلك، مضتْ تُورِدُ أقوال المتشكّكين فيصحّة البخاريّ ومسلك؛ كبلاشير وغيره… وتتطاوَل أحيانًا الكاتبة في تفسيراتها، أو قل إنّها – على الأقلّ – تتجرّأ في فهم النّصوص بِما قد يقود إلى الخروج بالمفهوم عن مساره إمّا فذلكةً أو تعنًّتًا أو بقصد الإساءة، والله أعلم في كلّ حال… فمن ذلك أنّها تُورِدُ الأحاديث الّتي تقول: إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يخرج في ليلة عائشة إلى بقيع الغرقد ويزور قبور الصّحابة ويكلّمها… وأنّ ذلك تكرّر أكثر من مرّة… فتقول – في الفحوى – : لماذا نهى الإسلام عن عباد القبور والأجداد، ألم يكن فِعل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم من هذا الباب؟! أليست العبادة تكرار لفعلٍ ما على نحوٍ ما؟ ألا نُسمّي زيارة الرّسول للقبور على هذا النّحو المتكرّر عبادة؟! اسمعْها تقول ذلك بالنّصّ: "ويمكن أن نعتبر زيارة الرّسول لبقيع الغرق، كما يُصوّرها الحديث شكلاً إسلاميًّا (باهتًا) من أشكال عبادة الأجداد". وتكون الكاتبة ذلك نسيت أو تناستْ أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يذهب إلى القبور ليدعو لأصحابه من الشّهداء والموتى، ويتّعظ – كما أخبرنا في تفسيره لدعوته لنا إلى زيارة القبور – بمصير كلّ حيّ… ولم يكن – حاشاه – يؤدّي أيّ نوعٍ من العبادة.. فانظر إلى هذه الجرأة من الكاتبة في الوقت الّذي كان يجدر بها أن تقول: إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قدّم النّموذج الأعلى، والقدوة المُثلى في الاتّعاظ بمصاير الأموات في قبورهم، ولم تكنْ نبوّته، ومغفرة الله له، وغِناه عن الذّهاب إلى القبور للعظة بمانعةٍ إيّاه من فِعْل ذلك حَثًّا منه للمسلمين على تذكّر الموت، لأنّه يقرّب المؤمن إلى ربّه، ويعجّل بتوبته، وإنابته إليه…!! غير أنّ الكاتبة تنتزع منّي أحيانًا بعض الإعجاب في طريقة تصويرها للمُسلّمات، فتعرضها بأسلوب جميل، فمن ذلك قولها: "فكأنّ الحياة دَيْنٌ لله على الإنسان، ومِنَ المنطقيّ والمعقول أن يستردّه يومًا، وتظهر هذه المبادئ في بعض عبارات المُعجَم الّذي استخرجناه، فالموت: رجوعٌ؛ لأنّ الذّاهب لا بدّ أن يؤوب، وهو: إجابةٌ؛ لأنّ النّداء لا بُدّ أن يُلَبَّى. وهو: لَحاقٌ بالرّسول؛ لأنّه لا بدّ لكلّ سابقٍ من لاحقٍ". غير أن مسلسل التّجديف، والتجرّؤ في غير موطنه يستمرّ في معظم صفحات الكِتاب، فها هي تكتب ناقلةً: "وقد أرّخ شونسي لهذه الفكرة؛ أي: زيف الحياة الدّنيا وزوالها في: (أفكار محمّد في الموت) فاعتبرها متأخّرة. فقد خاف محمّد الموت ككلّ إنسانٍ، لكنّه سيطر على هذا الخوف باهتمامه المتزايد بفكرةٍ ذكَرَها مرّةً في الفترة المكّيّة الثّانية، وتسع مرّات في السّنوات الأخيرة بمكّة، وكرّرها ما لا يقلّ عن ثلاثٍ وأربعين مرّةً في المدينة: الحياة الدّنيا الّتي يُفارقها الإنسان بموته لا تستحقّ أن نتعلّق بها". نأت الكاتبة عن الحقيقة كثيرًا، وسمحتْ لنفسها بالتّأويل الّذي لا يحتمله السّياق، ونسيتْ أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بشرٌ، يعتريه ما يعتري البشر من الحزن والفرح، وقد حَزِنَ على موت فلذة كبده، أفي هذا خروجٌ عن بشريّته؟! ونسيتْ الباحثة العظيمة، ونسيَ مَنْ نقلتْ عنه، أنّنا نقول: إنّ الجنديّ في المعركة لا يخاف الموت، بل يُقدِمُ بشجاعةٍ لا نظير لها، من أجل أهدافٍ قد تكون دنيويّة أو سمعةً، فما بالك بمعلّم البشر، الّذي كان الصّحابة يحتمون به في المعارك إذا حَمِيَ الوطيس! إنّ فكرة خوف الرّسول من الموت بهذا التّجريد، تُظهره إنسانًا عايًّا لا نبيًّا… فيبدو كما لو كان ملكًا حاربَ في الدّنيا وعندما اقترب أجله داخَلَهُ الخوف من المصير المحتوم… إنّه أسمى وأعلى من أن يخاف الموت بهذا التّجريد الّذي تسوّقه الكاتبة والمستشرقون، وهي تعلم أنّه في الحديث الصّحيح خُيِّرَ بين الموت والحياة فاختار الموت؛ أي اللّحاق بالرّفيق الأعلى… فواعجبا!!! وتُغالِطُ الكاتبة الحقائق أحيانًا، فتقول: "وقد وردت عبارة (سكرةُ الموت) في القرآن منسوبةً إلى الكفرة لا إلى المؤمنين: (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بِالحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ)". والفهم المغلوط فيما قالتْه يتبدّى في أنّ سكرة الموت هي عامّة للبشر جميعهم، مؤمنيهم وكافريهم، وليست خاصًّا بالكفّار دون سواهم، بل إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم عانى منها في مرض وفاته، حين قال: (إنّ للموتِ لسَكَرات). وانظر إلى هذا التّلاعب في فهم النّصوص الّذي تستمرّ الكاتبة في إشاعته عبر صفحات كِتابها، فهي تقول: "والرّسول صلّى الله عليه وسلّم أراد أن يدفع المرض عنه، أو يؤجّل حلول الموت به، فقد (كان ينفثُ على نفسه بالمعوّذات في المرض الّذي مات فيه) وقد لجأ إلى نوعٍ من الطّبّ السّحريّ فأمر نساءه بأن يُرِقْنَ عليه الماء (من سبع قِرَبٍ لم تُحْلَلْ أوكيتهنّ). ثمّ إنّه رَغِبَ في السِّواك وهو يُحتَضَر وكأنّه يريد أن يودّع الدّنيا". قلتُ: ولا أظنّ أنّ مؤمنًا حقًّا، يحبّ الله ورسوله يُمكن أن يسمّي فعل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وهو وَحْيٌ وهَدْيٌ ربّانيٌّ بـِ: (الطّبّ السّحريّ)!! وقلتُ: هل يودّع الإنسانُ الدّنيا بسِواكٍ إذا كان متعلّقًا بها؟! والكاتبة تقول عن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بأنّ مواقفه متناقضة، فهو ينهى عن البكاء، ثمّ يبكي على إبراهيم، وهو يتعلّق بالدّنيا بلا سببٍ واضح، انظر إليها وهي تفتري قائلةً: "ولهذا التّناقض وجهٌ آخر، فالحديثُ يُعلي الموت كما رأينا، ويصوّر الدّنيا دارَ باطلٍ، والآخرةَ دار حقٍّ. لكنّه قد يُصوّرُ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم إنسانًا يتعلّق بالدّنيا، ويكره موتَه، ويحزَن لموت الآخرين، فقد حَزِنَ لموت إبراهيم، وهو يعلم أنّ له (أي إبراهيم) مُرضِعًا في الجنّة، وحزن لمقتل الصّحابة وهو الّذي عُرِضت عليه الجنّة ورأى للشّهداء منها المقام الأرفع". قلتُ: لقد نأت عن الحقيقة كثيرًا، وسمحتْ لنفسها بالتّأويل الّذي لا يحتمله السّياق، ونسيتْ أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بشرٌ، يعتريه ما يعتري البشر من الحزن والفرح، وقد حَزِنَ على موت فلذة كبده، أفي هذا خروجٌ عن بشريّته؟! على العكس إنّها لتدلّ على مدى الرّحمة الّتي يمتلئ بها قلبه عليه السّلام.. ❝ ⏤رجاء بن سلامةملخص كتاب ❞الموت وطقوسه من خلال صحيحي البخاري ومسلم❝، بقلم أيمن العتوم
(الموت وطقوسه؛ من خلال صحيحَي البُخاريّ ومُسلِم) للدّكتورة رجاء بن سلامة، والمؤلّفة تونسيّة، وباحثة أدبيّة، ومحلّلة نفسيّة. يتكوّن الكتاب من حوالي (300) ثلاثمئة صفحة من القطع الصّغير، ويبدو أنّه دراسةٌ قامت بها الكاتبة في مرحلة الماجيستير أو الدكتوراه، وقد كان الباعث – مِمّا استنتجتُه من مقدّمة الكتاب – على القيام بهذه الدّراسة هو موت والدها. وقد ناقشت فيه الموت بطريقة فلسفيّة عقديّة خالية من القناعات المسبقة ومعتمدةً اعتمادًا كلّيًّا على صحيحَي البخاريّ ومُسلِم، وهذا ما أعطى بحثها شرعيّةً ومصداقيًّةً عاليَتَيْن، ومع أنّ الكتاب يحرّك خلايا الذّهن، ويوقد شعلة التّفكير أو إعادة التّفكير في فهم النّصوص، إلاّ أنّ بعض هذه التّفسيرات والتّأويلات الّتي أتت بها الكاتبة بدت جريئة جدًّا وخطيرة …الموت وطقوسه (1) لا أكتم أحدًا سرًّا إنْ قلتُ: إنّني توقَّفْتُ مليًّا عند هذه التّحليلات وتباينت مواقفي تُجاهها، أيّدتُها أحيانًا، أعُجِبْتِ بها أحيانًا أخرى… خِفتُ منها أحيانًا ثالثة… وفي كلّ الأحوال فتحتْ عيني على مقدار الجهل الّذي كنتُ أعيشه بعيدًا عن رياض هذين الصّحيحَيْن اللّذين لا يعرف منهما كثيرٌ من النّاس إلاّ بعض الأحاديث المشهورة، وأنا أوّل هؤلاء… ولهذا السّبب فقد قرّرتُ أو قُلْ تشجَّعْتُ لإعادة قراءتهما والغوص في محيطهما، واستخراج كنوزهما النبويّة الثّمينة.. كنتُ كلّما قرأتُ حديثًا أو بعض حديثٍ لم يمرّ عليّ سابقًا، ويُدهشني بأسلوبه، ومضمونه، كنتُ أردّد مع الشّافعيّ: كُلّما أَدَّبَنِي الدَّهْـــرُ أَرانِي نَقْصَ عَقْلِي وَإِذا مَا ازْدَدْتُ عِلْمًا زَادَنِي عِلْمًا بِجَهْلِي الموتُ مفارقةٌ عجيبةٌ؛ فهو يقين، يقين لا يمكن التّيقّن من فحواه، بما أنّ الذّات إذ تموت ينعدم وعيها. وهو يقين ينفي نفسه، لأنّ الذّات تعلم أنّها مائتة لا محالة، ولكنّها لا تستطيع تصوّر فنائها تقول المؤلّفة في كتابها عن كتابها مشيدةً به، وبطريقتها في عرض ما ....... [المزيد]
قراءة ملخص كتاب الموت وطقوسه من خلال صحيحي البخاري ومسلم ⏤ رجاء بن سلامة