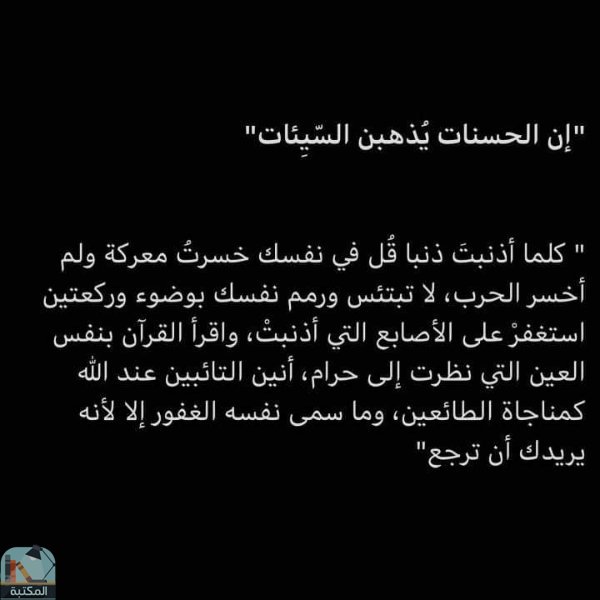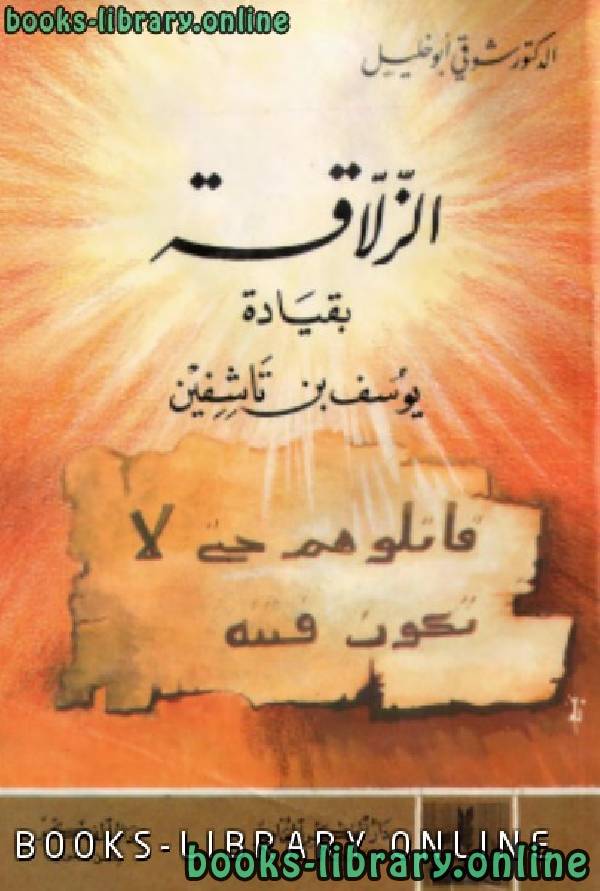❞ معركة ❝ 💬 اقتباسات من الكتب 📖
- معركة 💬 اقتباسات من الكتب 📖
█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2025
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
اقتباسات في ❞معركة❝
-
❞ ملخص كتاب ❞ الزلاقة بقيادة يوسف بن تاشفين❝
يأخذنا الدكتور (شوقي أبو خليل) في جولة تاريخية في بلاد (الأندلس) و(المغرب). وكيف بدأت دولة المرابطين؟ وجهادهم في سبيل الفتوحات الإسلامية في (المغرب ). وحال المسلمين في (الأندلس )، وكيف أثرت الفُرْقَة والعداوة بين ملوك الطوائف على قوة المسلمين في (الأندلس )؟ واستدعاء المرابطين لنصرة المسلمين، والوقوف في وجه النصارى.
1- حال الأندلس أثناء حكم ملوك الطوائف:
انتصرت رايات العباسيين على الأمويين في الشرق، ولكن سلطة الأمويين لم تنته بقيام الدولة العباسية سنة 132هـ؛ لأن (عبد الرحمن الداخل ) استطاع أن يؤسس إمارة أموية في (الأندلس ) سنة 138هـ. وبدأ عصر الخلافة الأموية في (الأندلس ) سنة 316هـ، عندما أعلنها (عبد الرحمن الناصر )، الذي استطاع أن يقضي على العصاة ويعيد لـ (الأندلس ) وحدتها وقوتها، أَدَّبَ المتمردين من من (الإسبان )، وجعلهم يدركون قوة (الأندلس )، وبلغت (الأندلس ) من القوة في زمانه أن حكام (إسبانيا ) كثيرًا ما طلبوا من السلطات الأندلسية التدخل في حل مشاكلهم. وفي عام 400هـ، بدأ عصر الطوائف، وذهبت الخلافة الأموية ضحية غطرسة الحرس الخليفي، ونتيجة أطماع الولاة، وانحلال الشعب الذي فقد حبه وولاءه للأسرة الحاكمة، وسقطت الخلافة الأموية في (الأندلس) نتيجة تناقضاتها الداخلية، وليس من جراء قوة أعدائها في الخارج. انقسمت (الأندلس) إلى دُوَيْلات، واتخذ حكامها ألقابًا تبعًا لحجم دويلاتهم، وأخذ القوي منهم يبطش بالضعيف. كانت حال المسلمين في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري تسوده الخصومة والتطاحن بين الأمراء، حتى أن بعضهم تحالف مع الدول النصرانية، واستمد عونهم نظير الجزية. ولما أراد (المأمون) صاحب (طُلَيْطِلة ) أن يستولي على (قرطبة )، استجار أمير (قرطبة ) بجيرانه (بني عباد ) في (إشبيلية )، و (بني الأفطس ) أصحاب (بطليوس )؛ لمعاونته ضد (طُلَيْطِلة ). واستمرت الحرب بين (طُلَيْطِلة ) و (قرطبة ) أعوامًا، وكانت سجالًا. وأراد (المأمون ) صاحب (طُلَيْطِلة ) حسم الموقف، فأوقع بقوات (قرطبة ) وحلفائها هزيمة شديدة، واستطاع الوصول إلى (قرطبة ) فحاصرها؛ فبادرت (إشبيلية ) إلى نصرتها، فأرسل ( ابن عباد ) ولده (محمد ) على رأس جيش قوي فيه وزيره (أبو بكر محمد بن عمار ) الموصوف بوفرة الذكاء، وزودهما بخطة وأوامر سرية. هاجم جيش (ابن عباد ) الجيش المحاصر لـ (قرطبة )؛ فاضطر إلى رفع الحصار، وارتد عنها، وخرج القرطبيون ليطاردوا عدوهم؛ فأتموا بذلك هزيمة الطُلَيْطِليين. وتنفيذًا لخطة (ابن عباد )، استغل (ابن عمار ) خروج جيش قرطبة لمطاردة (المأمون )؛ فدخل (قرطبة ) دون مقاومة، واستولى على مراكزها الحصينة. وبذلك أصبح (ابن عباد ) أمير (إشبيلية ) أقوى أمراء (الأندلس ). ولكن (المأمون ) جزع من قوة (ابن عباد )، فتحالف مع (فرناندو الأول ) صاحب (قشتاله )، واستولوا على (بلنسية )، واستعدوا لمحاربة (ابن عباد )، إلا أن وفاة (فرناندو الأول ) حالت دون ذلك. وتوفي (المعتضد بن عباد )؛ فخلفه ابنه (محمد ) الملقب بـِِِِِ (المعتمد على الله ) ولم يكن أمامه عدو يخشاه سوى (المأمون). لم يوفَّق (المعتمد ) في حربه مع (المأمون )، وتحالف (المأمون ) مع (ألفونسو ) الذي فاز بحكم (قَشْتَالَة )؛ فزادت قوة (المأمون )، ودخل (قرطبة ) دون مقاومة تذكر، إلا أن (المأمون ) توفي بعد دخولها بأيام. واستعادها (ابن عباد )، وتعاهد (المعتمد ) مع (ألفونسو ) على نصرته ضد جميع المسلمين، نظير دفع جزية له، وعدم الوقوف أمام مشروع (ألفونسو ) في افتتاح (طُلَيْطِلة ). بعد سنوات من الحرب، استطاع (ألفونسو ) أن يدخل (طُلَيْطِلة )، وجعلها حاضرة دولته النصرانية. أحدث سقوط (طُلَيْطِلة ) رد فعل عنيف، أثار المسلمين في الأندلس كلها. ولم يقنع (ألفونسو ) بـِِِِِ (طُلَيْطِلة )، بل استولى على جميع الأراضي الواقعة على ضفتي نهر (تاجة ). وكتب (المعتمد ) إلى (ألفونسو ) ألا يتعدى في فتوحاته (طُلَيْطِلة )، وإلا كان هذا خرقًا للتعاهد، ولكن ملك (قَشْتَالَة ) لم يَرَ في إنذار حليفه ما يحمله على التوقف عن الفتوح، وعزم على فتح الولايات المسلمة كلها. وهنا رأى أمراء (الأندلس ) شبح السقوط ماثلًا أمام أعينهم؛ فاتحدوا للمرة الأولى، واجتمعت كلمتهم على أن يضعوا حدًا لفتوحات (ألفونسو )، وإن كانت قواهم مجتمعة لا تستطيع إيقافه؛ فجتمعت كلمتهم على الاستنجاد بالمرابطين في (إفريقية ).. ❝ ⏤شوقي أبو خليلملخص كتاب ❞ الزلاقة بقيادة يوسف بن تاشفين❝
يأخذنا الدكتور (شوقي أبو خليل) في جولة تاريخية في بلاد (الأندلس) و(المغرب). وكيف بدأت دولة المرابطين؟ وجهادهم في سبيل الفتوحات الإسلامية في (المغرب ). وحال المسلمين في (الأندلس )، وكيف أثرت الفُرْقَة والعداوة بين ملوك الطوائف على قوة المسلمين في (الأندلس )؟ واستدعاء المرابطين لنصرة المسلمين، والوقوف في وجه النصارى.1- حال الأندلس أثناء حكم ملوك الطوائف انتصرت رايات العباسيين على الأمويين في الشرق، ولكن سلطة الأمويين لم تنته بقيام الدولة العباسية سنة 132هـ؛ لأن (عبد الرحمن الداخل ) استطاع أن يؤسس إمارة أموية في (الأندلس ) سنة 138هـ. وبدأ عصر الخلافة الأموية في (الأندلس ) سنة 316هـ، عندما أعلنها (عبد الرحمن الناصر )، الذي استطاع أن يقضي على العصاة ويعيد لـ (الأندلس ) وحدتها وقوتها، أَدَّبَ المتمردين من من (الإسبان )، وجعلهم يدركون قوة (الأندلس )، وبلغت (الأندلس ) من القوة في زمانه أن حكام (إسبانيا ) كثيرًا ما طلبوا من السلطات الأندلسية التدخل في حل مشاكلهم. وفي عام 400هـ، بدأ عصر الطوائف، وذهبت الخلافة الأموية ضحية غطرسة الحرس الخليفي، ونتيجة أطماع الولاة، وانحلال الشعب الذي فقد حبه وولاءه للأسرة الحاكمة، وسقطت الخلافة الأموية في (الأندلس) نتيجة تناقضاتها الداخلية، وليس من جراء قوة أعدائها في الخارج. انقسمت (الأندلس) إلى دُوَيْلات، واتخذ حكامها ألقابًا تبعًا لحجم دويلاتهم، وأخذ القوي منهم يبطش بالضعيف. كانت حال المسلمين في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري تسوده الخصومة والتطاحن بين الأمراء، حتى أن ....... [المزيد]
2- بداية المرابطين اطَّلع (يحي بن إبراهيم ) على مبادئ الإسلام، وعلى العلوم والمعارف التي كانت ذائعة في العالم الإسلامي في أواسط القرن الحادي عشر الميلادي؛ فعقد العزم على ألا يدخر وسعًا في تثقيف اللمتونيين –الذين كانوا يدينون المجوسية –في صحاريهم بعلوم الإسلام. واحتاج إلى عالم مسلم، فوقع على بغيته أثناء مقامه بـِِِِِ (القيروان ) على (عبد الله بن ياسين )، وكانت قبائل (لَمْتُونَة ) و (كَدَالَة ) و (مسطاسة ) تعرَف باسم مشترك هو (المُلَثَّمون )، وهم الذين وصلت إليهم دروس (عبد الله بن ياسين ) بعد عناء، فرفعوه إلى أعظم مقام، حتى أن (أبا بكر زكريا بن عمر ) زعيم الملثمين، أعلن أنه تلميذه وتابعه، فاختاره (عبد الله ) أميرًا وقائدًا، يقود المجاهدين في ميدان الحرب. وأطلق المُلَثَّمون على أنفسهم اسمًا جديدًا هو (المرابطون ). أُخِذَت هذه التسمية الجديدة من (الرباط )، رباط المجاهدين وخيولهم بإزاء العدو في الثغور، ومنه المرابط، وهو من لازم الثغر لدفع العدو. وقد أُخِذت التسمية من قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ". كان الإسلام للمرابطين ....... [المزيد]
قراءة ملخص كتاب معركة الزلاقة بقيادة يوسف بن تاشفين ⏤ شوقي أبو خليل -
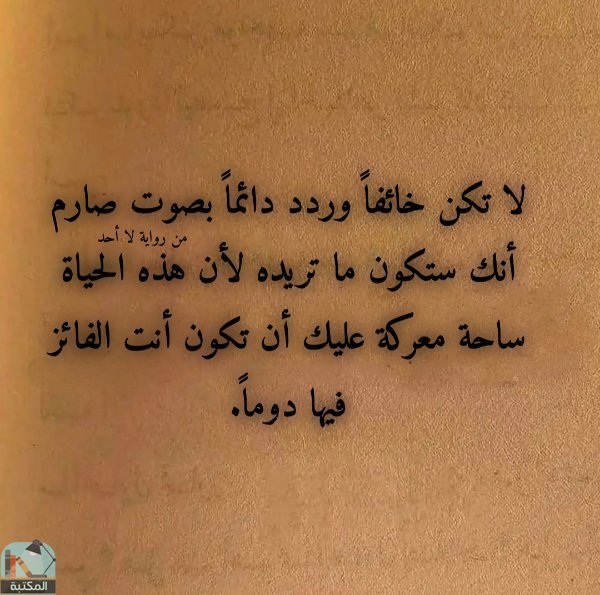 ❞ لا تكن خائفاً وردد دائماً بصوت صارم أنك ستكون ما تريده لأن هذه الحياة ساحة معركة عليك أن تكون أنت الفائز فيها دوماً. اقتباس من رواية لا أحد للكاتبة عائشة بوشارب #لا_أحد #عائشة_بوشارب #رواية #كتاب #كتب #كتب_books #قراءة #اقتباسات #اقتباس #مكتب #مكتبة #معرض #معرض_القاهرة_الدولي_للكتاب #مصر. ❝ ⏤عائشة بوشارب❞ لا تكن خائفاً وردد دائماً بصوت صارم أنك ستكون ما تريده لأن هذه الحياة ساحة معركة عليك أن تكون أنت الفائز فيها دوماً.
❞ لا تكن خائفاً وردد دائماً بصوت صارم أنك ستكون ما تريده لأن هذه الحياة ساحة معركة عليك أن تكون أنت الفائز فيها دوماً. اقتباس من رواية لا أحد للكاتبة عائشة بوشارب #لا_أحد #عائشة_بوشارب #رواية #كتاب #كتب #كتب_books #قراءة #اقتباسات #اقتباس #مكتب #مكتبة #معرض #معرض_القاهرة_الدولي_للكتاب #مصر. ❝ ⏤عائشة بوشارب❞ لا تكن خائفاً وردد دائماً بصوت صارم أنك ستكون ما تريده لأن هذه الحياة ساحة معركة عليك أن تكون أنت الفائز فيها دوماً.
اقتباس من رواية لا أحد للكاتبة عائشة بوشارب
#لا_أحد #عائشة_بوشارب
#رواية #كتاب #كتب #كتب_books #قراءة #اقتباسات #اقتباس #مكتب #مكتبة #معرض #معرض_القاهرة_الدولي_للكتاب #مصر. ❝
⏤ عائشة بوشارب -
❞ هديه ﷺ في الجنائز : كان هديه ﷺ في الجنائز أكمل الهدي ، مخالفاً لهدي سائر الأمم ، مشتملاً على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده ، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه ، وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال ، والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها ، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفاً يحمدون الله ويستغفرون له ، ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه ، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته ، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه ، ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره ، والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا ، فأول ذلك تعاهده في مرضه ، وتذكيره الآخرة ، وأمره بالوصية ، والتوبة ، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه ، ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمِنُ بالبعث والنشور ، مِن لطم الخُدُود ، وشق الثياب ، وحلق الرؤوس ، ورفع الصوت بالندب ، والنياحة وتوابع ذلك ، وسَنَّ ﷺ الخشوع للميت ، والبكاء الذي لا صوت معه ، وحُزْنَ القلب ، وكان يفعل ذلك ويقول ( تَدْمَعُ العَيْنُ وَيَحْزَنُ القَلْبُ وَلَا نَقُولُ إلا ما يُرضِي الرَّبِّ ) ، وسَنَّ لأمته الحمد والاسترجاع والرضى عن الله ، ولم يكن ذلك منافياً لدمع العين وحزن القلب ، ولذلك كان ﷺ أرضى الخلقِ عن الله في قضائه ، وأعظمهم ، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه ، ورحمة للولد ، ورقة عليه ، والقلب ممتلىء بالرضى عن الله عز وجل وشكره ، واللسانُ مشتغل بذكره وحمده ، وكان من هديه ﷺ الاسراع بتجهيز الميت إلى الله ، وتطهيره ، وتنظيفه ، وتطييبه ، وتكفينه في الثياب البيض ، ثم يُؤتى به إليه ، فيُصلي عليه بعد أن كان يُدعى إلى الميت عند احتضاره فيُقيم عنده حتى يقضي ، ثم يحضر تجهيزه ، ثم يُصلِّي عليه ، ويشيعه إلى قبره ، ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق عليه ، فكانوا إذا قضى الميت ، دعوه فحضر ، تجهيزه وغسله وتكفينه ، ثم رأوا أن ذلك يشق عليه ، فكانوا هم يُجهزون ، ميتهم ، ويحملونه إليه ﷺ على سريره ، فيُصلي عليه خارج المسجد ، ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد ، وإنما كان يُصلي على الجنازة خارج المسجد ، وربما كان يصلي أحياناً على الميت في المسجد ، كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد ، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته ، وكان من هديه ﷺ تسجيةُ الميت إذا مات وتغميض عينيه ، وتغطية وجهه و بدنه ، وكان رُبما يُقبل الميت كما قبَّل عثمان بن مظعون وبكى ، وكذلك الصديق أكب عليه ، فقبله بعد موته ، وكان ﷺ يأمر بغسل الميت ثلاثاً أو خمساً ، أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل ، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة ، وكان لا يُغسل الشُّهَداءَ قَتْلَى المعركة ، وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم ، وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويَدفنُهم في ثيابهم ، ولم يُصل عليهم ، وكان إذا مات المُحرِمُ ، أمر أن يُغسل بماء وسدر ، ويكفن في ثوبيه وهما ثوبا إحرامه ، إزاره ورداؤه وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه ، وكان يأمر من ولي الميت أن يُحسن كفنه ، ويُكفنه في البياض ، وينهى عن المغالاة في الكفن ، وكان إذا قصَّرَ الكفن عن سَتر جميع البدن غطّى رأسه ، وجعل على رجليه من العشب.. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية❞ هديه ﷺ في الجنائز :
كان هديه ﷺ في الجنائز أكمل الهدي ، مخالفاً لهدي سائر الأمم ، مشتملاً على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده ، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه ، وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال ، والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها ، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفاً يحمدون الله ويستغفرون له ، ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه ، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته ، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه ، ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره ، والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا ، فأول ذلك تعاهده في مرضه ، وتذكيره الآخرة ، وأمره بالوصية ، والتوبة ، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه ، ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمِنُ بالبعث والنشور ، مِن لطم الخُدُود ، وشق الثياب ، وحلق الرؤوس ، ورفع الصوت بالندب ، والنياحة وتوابع ذلك ، وسَنَّ ﷺ الخشوع للميت ، والبكاء الذي لا صوت معه ، وحُزْنَ القلب ، وكان يفعل ذلك ويقول ( تَدْمَعُ العَيْنُ وَيَحْزَنُ القَلْبُ وَلَا نَقُولُ إلا ما يُرضِي الرَّبِّ ) ، وسَنَّ لأمته الحمد والاسترجاع والرضى عن الله ، ولم يكن ذلك منافياً لدمع العين وحزن القلب ، ولذلك كان ﷺ أرضى الخلقِ عن الله في قضائه ، وأعظمهم ، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه ، ورحمة للولد ، ورقة عليه ، والقلب ممتلىء بالرضى عن الله عز وجل وشكره ، واللسانُ مشتغل بذكره وحمده ، وكان من هديه ﷺ الاسراع بتجهيز الميت إلى الله ، وتطهيره ، وتنظيفه ، وتطييبه ، وتكفينه في الثياب البيض ، ثم يُؤتى به إليه ، فيُصلي عليه بعد أن كان يُدعى إلى الميت عند احتضاره فيُقيم عنده حتى يقضي ، ثم يحضر تجهيزه ، ثم يُصلِّي عليه ، ويشيعه إلى قبره ، ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق عليه ، فكانوا إذا قضى الميت ، دعوه فحضر ، تجهيزه وغسله وتكفينه ، ثم رأوا أن ذلك يشق عليه ، فكانوا هم يُجهزون ، ميتهم ، ويحملونه إليه ﷺ على سريره ، فيُصلي عليه خارج المسجد ، ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد ، وإنما كان يُصلي على الجنازة خارج المسجد ، وربما كان يصلي أحياناً على الميت في المسجد ، كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد ، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته ، وكان من هديه ﷺ تسجيةُ الميت إذا مات وتغميض عينيه ، وتغطية وجهه و بدنه ، وكان رُبما يُقبل الميت كما قبَّل عثمان بن مظعون وبكى ، وكذلك الصديق أكب عليه ، فقبله بعد موته ، وكان ﷺ يأمر بغسل الميت ثلاثاً أو خمساً ، أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل ، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة ، وكان لا يُغسل الشُّهَداءَ قَتْلَى المعركة ، وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم ، وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويَدفنُهم في ثيابهم ، ولم يُصل عليهم ، وكان إذا مات المُحرِمُ ، أمر أن يُغسل بماء وسدر ، ويكفن في ثوبيه وهما ثوبا إحرامه ، إزاره ورداؤه وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه ، وكان يأمر من ولي الميت أن يُحسن كفنه ، ويُكفنه في البياض ، وينهى عن المغالاة في الكفن ، وكان إذا قصَّرَ الكفن عن سَتر جميع البدن غطّى رأسه ، وجعل على رجليه من العشب. ❝
⏤ محمد ابن قيم الجوزية