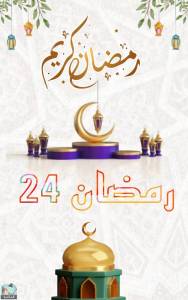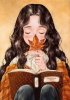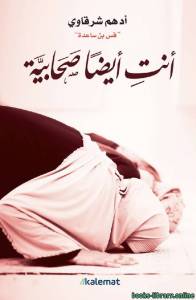❞ إن شئت ❝ 💬 اقتباسات من الكتب 📖
- إن شئت 💬 اقتباسات من الكتب 📖
█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2025
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
اقتباسات في ❞إن شئت❝
-
❞ أم المؤمنين (سودة بنت زمعة) هي ثاني زوجات الرسول محمد، ومن السابقين الأولين في الإسلام. فما سيرة السيدة سودة؟ نسبها ومولدها وُلدت في مكة في عائلة قرشية، هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس، وأمها الشموس بنت قيس ، بنت أخي سلمى بنت عمرو بن زيد أمِّ عبد المطلب، تزوَّجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمٍّ لها هو: السكران بن عمرو ، وهاجر بها السكران إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وأنجبت منه ابنها عبدالله،ورُوى عن ابن عبّاس قال: كانت سودة بنت زمعة عند السَّكْرَان بن عَمْرو أخي سهيل بن عمرو فرأت في المنام كأنّ النبيّ أقبل يمشي حتى وطئ على عُنقها، فأخبرت زوجها بذلك فقال: «وأبيك لئن صَدَقَت رؤياك لأموتنّ وليتزَوّجنّك رسول الله»، فقالت: حجرًا وسترًا. وقال هشام: الحجر تنفي عن نفسها ذاك. ثمّ رأت في المنام ليلةً أُخرى أنّ قَمَرًا انقضّ عليها من السماء وهي مُضطجعة، فأخبرت زوجها فقال: «وأبيك لئن صَدَقت رؤياك لم ألبث إلا يسيرًا حتى أموت وتزوّجين من بعدي». فاشتكى السكران من يومه ذلك فلم يلبث إلا قليلًا،ثم رجع بها إلى مكة فمات عنها. فأمست السيدة سودة -رضي الله عنها- بين أهل زوجها المشركين وحيدة لا عائل لها ولا معين؛ حيث أبوها ما زال على كفره وضلاله، ولم يزل أخوها عبد الله بن زمعة على دين آبائه، وهذا هو حالها قبل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها. زواجها من النبي كان رحيل السيدة خديجة رضي الله عنها مثير أحزان كبرى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصَّة أن رحيلها تزامن مع رحيل عمِّه أبي طالب -كما سبق أن أشرنا- حتى سُمِّي هذا العام بعام الحزن. وفي هذا الجو المعتم حيث الحزن والوَحدة، وافتقاد مَنْ يرعى شئون البيت والأولاد، أشفق عليه أصحابه رضوان الله عليهم، فبعثوا إليه خولة بنت حكيم السلمية -رضي الله عنها- امرأة عثمان بن مظعون رضي الله عنه، ورفيقة سودة في الهجرة إلى الحبشة، تسأله أن يتزوج. وقالت له: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَاكَ قَدْ دَخَلَتْكَ خَلَّةٌ لِفَقْدِ خَدِيجَةَ». قال: «أَجَلْ أُمُّ الْعِيَالِ، وَرَبَّةُ الْبَيْتِ». فقالت: «أَلا أَخْطُبُ عَلَيْكَ؟»، قال: «بَلَى أَمَا إِنَّكُنَّ مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَرْفَقُ بِذَلِكَ.» فسألها: «وَمَن؟» قالت: «إِنْ شِئْتَ بِكْرًا، وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا» فقال: «وَمَنِ البِكْرُ وَمَنِ الثَّيِّب؟» فذكرت له البكر عائشة بنت أبي بكر والثيب سودة بنت زمعة فقال: «فَاذْكُرِيْهِمَا عَلَيّ». فلمَّا انتهت عدة سودة خطبتها خولة على النبي فقالت: «أمري إليك يا رسول الله.» فقال النبي: «مري رجلا من قومك يزوجك» فأمَّرت حاطب بن عمرو أخا السكران، فتزوجها. وكان زواجها في رمضان سنة عشرة من البعثة النبوية، وبنى بسودة بمكّة، ثم بَنَى بعائشة بعد ذلك حين قدم المدينة. وتعدُّ السيدة سودة أوَّل امرأة تزوَّجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وكانت قد بلغت من العمر حينئذٍ الخامسة والخمسين، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمسين من عمره، ولما سمع الناس في مكة بأمر هذا الزواج عجبوا؛ لأن السيدة سودة لم تكن بذات جمال ولا حسب، ولا مطمع فيها للرجال، وقد أيقنوا أنه إنما ضمَّها رفقًا بحالها، وشفقة عليها، وحفظًا لإسلامها، وجبرًا لخاطرها بعد وفاة زوجها إثر عودتهما من الحبشة، وكأنهم علموا أنه زواج تمَّ لأسباب إنسانيَّة. وحين حانت الهجرة إلى المدينة المنورة أمر النبي محمد زيد بن حارثة وأبا رافع الأنصاري أن يأخذا أهل بيته ليهاجروا إلى المدينة، فأخذا سودة ومعها فاطمة الزهراء وأم كلثوم بنت محمد وأم أيمن وأسامة بن زيد. صفات السيدة سودة وتُطالعنا سيرة السيدة سودة -رضي الله عنها- بأنها قد جمعت ملامح عظيمة وخصالاً طيبة، كان منها أنها كانت معطاءة تُكْثِر من الصدقة، عُرفت بكرمها، فأرسل إليها عمر بن الخطاب بِغرَارة من دَراهم ففرقتها على الفقراء كلها. وقد وَهَبَتْ رضي الله عنها يومها لعائشة؛ ففي صحيح مسلم أنها: \"لَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ\". وفي ذلك نزلت الأية: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ سورة النساء الآية. قالت عنها عائشة: «ما من الناس أحد أحبّ إليّ أن أكون في مِسْلَاخه من سَوْدة؛ إن بها إلا حدّة فيها كانت تسرع منها الفيئة.» كانتْ مِن العابِداتِ الزَّاهِداتِ؛ ولذلِكَ تمنَّتْ عائِشةُ رضِيَ الله عنها أنْ تَكونَ في مِسْلاخِ سَوْدةَ، أي أن تُصبِحَ كأنَّها هيَ في العِبادةِ. وقد ضمَّتْ إلى تلك الصفات لطافةً في المعشر، ودعابةً في الرُّوح؛ مما جعلها تنجح في إذكاء السعادة والبهجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن سعد في طبقاته عن إبراهيم، قال: قالت سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكتُ بأنفي مخافة أن يقطر الدم. قال: فضحك. مكانة سودة وكانت سودة ممن نزل فيها آيات الحجاب، فخرجت ذات مرة ليلًا لقضاء حوائجها وكانت امرأة طويلة جسيمة تفرُعُ النساء جسمًا لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فعرفها فقال: عرَفناكِ يا سَودَةُ، حِرصًا على أن يَنزِلَ الحجابُ، فنزلت الآيات: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) سورة الأحزاب. وروت سودة خمسة أحاديث؛ منها في الصحيحين حديث واحد عن البخاري، وروى عنها عبد الله بن عباس، ويحيى بن عبد الله الأنصاري. فروى لها ابن الزبير أنها قالت: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج قال: \"أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منك\" قال: نعم، قال: فالله أرحم حج عن أبيك». شهدت سودة غزوة خيبر مع النبي وأطعمها النبي من الغنائم ثمانين وَسْقًا تمرًا وعشرين وَسْقًا شعيًرا، ويقال قمح. وشهدت معه حجة الوداع، واستأذنته أن تصلي الصبح بمنى ليلة المزدلفة فأذن لها، فعن عائشة: «استأذنت سودة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ليلة المزدلفة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، يعني ثقيلة، فأذن لها، ولأن أكون استأذنته أحبّ إليّ من معروج به.» ولم تحج سودة بعدها ولزمت بيتها حتى وفاتها، فكانت تقول: «لا أحج بعدها أبدًا»، وتقول: «حججت واعتمرت فأنا أقر في بيتي، كما أمرني الله عز وجل»، وكانت زوجات النبي يحججن إلا سودة بنت زمعة وزينب بنت جحش، قالتا: «لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم». وفاتها توفيت أم المؤمنين سودة بنت زمعة -رضي الله عنها- سنة 54هـ في شوال، بالمدينة المنورة في خلافة معاوية. #أمهات_المؤمنين #صفاءفوزي. ❝ ⏤مجموعة من المؤلفين❞ أم المؤمنين
(سودة بنت زمعة)
هي ثاني زوجات الرسول محمد، ومن السابقين الأولين في الإسلام. فما سيرة السيدة سودة؟
نسبها ومولدها
وُلدت في مكة في عائلة قرشية، هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس، وأمها الشموس بنت قيس ، بنت أخي سلمى بنت عمرو بن زيد أمِّ عبد المطلب، تزوَّجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمٍّ لها هو: السكران بن عمرو ، وهاجر بها السكران إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وأنجبت منه ابنها عبدالله،ورُوى عن ابن عبّاس قال:
كانت سودة بنت زمعة عند السَّكْرَان بن عَمْرو أخي سهيل بن عمرو فرأت في المنام كأنّ النبيّ أقبل يمشي حتى وطئ على عُنقها، فأخبرت زوجها بذلك فقال: «وأبيك لئن صَدَقَت رؤياك لأموتنّ وليتزَوّجنّك رسول الله»، فقالت: حجرًا وسترًا.
وقال هشام: الحجر تنفي عن نفسها ذاك.
ثمّ رأت في المنام ليلةً أُخرى أنّ قَمَرًا انقضّ عليها من السماء وهي مُضطجعة، فأخبرت زوجها فقال: «وأبيك لئن صَدَقت رؤياك لم ألبث إلا يسيرًا حتى أموت وتزوّجين من بعدي».
فاشتكى السكران من يومه ذلك فلم يلبث إلا قليلًا،ثم رجع بها إلى مكة فمات عنها. فأمست السيدة سودة -رضي الله عنها- بين أهل زوجها المشركين وحيدة لا عائل لها ولا معين؛ حيث أبوها ما زال على كفره وضلاله، ولم يزل أخوها عبد الله بن زمعة على دين آبائه، وهذا هو حالها قبل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها.
زواجها من النبي
كان رحيل السيدة خديجة رضي الله عنها مثير أحزان كبرى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصَّة أن رحيلها تزامن مع رحيل عمِّه أبي طالب -كما سبق أن أشرنا- حتى سُمِّي هذا العام بعام الحزن.
وفي هذا الجو المعتم حيث الحزن والوَحدة، وافتقاد مَنْ يرعى شئون البيت والأولاد، أشفق عليه أصحابه رضوان الله عليهم، فبعثوا إليه خولة بنت حكيم السلمية -رضي الله عنها- امرأة عثمان بن مظعون رضي الله عنه، ورفيقة سودة في الهجرة إلى الحبشة، تسأله أن يتزوج.
وقالت له: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَاكَ قَدْ دَخَلَتْكَ خَلَّةٌ لِفَقْدِ خَدِيجَةَ».
قال: «أَجَلْ أُمُّ الْعِيَالِ، وَرَبَّةُ الْبَيْتِ».
فقالت: «أَلا أَخْطُبُ عَلَيْكَ؟»، قال: «بَلَى أَمَا إِنَّكُنَّ مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَرْفَقُ بِذَلِكَ.» فسألها: «وَمَن؟»
قالت: «إِنْ شِئْتَ بِكْرًا، وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا»
فقال: «وَمَنِ البِكْرُ وَمَنِ الثَّيِّب؟»
فذكرت له البكر عائشة بنت أبي بكر والثيب سودة بنت زمعة
فقال: «فَاذْكُرِيْهِمَا عَلَيّ».
فلمَّا انتهت عدة سودة خطبتها خولة على النبي
فقالت: «أمري إليك يا رسول الله.»
فقال النبي: «مري رجلا من قومك يزوجك»
فأمَّرت حاطب بن عمرو أخا السكران، فتزوجها.
وكان زواجها في رمضان سنة عشرة من البعثة النبوية، وبنى بسودة بمكّة، ثم بَنَى بعائشة بعد ذلك حين قدم المدينة.
وتعدُّ السيدة سودة أوَّل امرأة تزوَّجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وكانت قد بلغت من العمر حينئذٍ الخامسة والخمسين، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمسين من عمره، ولما سمع الناس في مكة بأمر هذا الزواج عجبوا؛ لأن السيدة سودة لم تكن بذات جمال ولا حسب، ولا مطمع فيها للرجال، وقد أيقنوا أنه إنما ضمَّها رفقًا بحالها، وشفقة عليها، وحفظًا لإسلامها، وجبرًا لخاطرها بعد وفاة زوجها إثر عودتهما من الحبشة، وكأنهم علموا أنه زواج تمَّ لأسباب إنسانيَّة.
وحين حانت الهجرة إلى المدينة المنورة أمر النبي محمد زيد بن حارثة وأبا رافع الأنصاري أن يأخذا أهل بيته ليهاجروا إلى المدينة، فأخذا سودة ومعها فاطمة الزهراء وأم كلثوم بنت محمد وأم أيمن وأسامة بن زيد.
صفات السيدة سودة
وتُطالعنا سيرة السيدة سودة -رضي الله عنها- بأنها قد جمعت ملامح عظيمة وخصالاً طيبة، كان منها أنها كانت معطاءة تُكْثِر من الصدقة،
عُرفت بكرمها، فأرسل إليها عمر بن الخطاب بِغرَارة من دَراهم ففرقتها على الفقراء كلها.
وقد وَهَبَتْ رضي الله عنها يومها لعائشة؛ ففي صحيح مسلم أنها: ˝لَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ˝.
وفي ذلك نزلت الأية: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ سورة النساء الآية.
قالت عنها عائشة: «ما من الناس أحد أحبّ إليّ أن أكون في مِسْلَاخه من سَوْدة؛ إن بها إلا حدّة فيها كانت تسرع منها الفيئة.»
كانتْ مِن العابِداتِ الزَّاهِداتِ؛ ولذلِكَ تمنَّتْ عائِشةُ رضِيَ الله عنها أنْ تَكونَ في مِسْلاخِ سَوْدةَ، أي أن تُصبِحَ كأنَّها هيَ في العِبادةِ.
وقد ضمَّتْ إلى تلك الصفات لطافةً في المعشر، ودعابةً في الرُّوح؛ مما جعلها تنجح في إذكاء السعادة والبهجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن سعد في طبقاته عن إبراهيم، قال: قالت سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكتُ بأنفي مخافة أن يقطر الدم. قال: فضحك.
مكانة سودة
وكانت سودة ممن نزل فيها آيات الحجاب، فخرجت ذات مرة ليلًا لقضاء حوائجها وكانت امرأة طويلة جسيمة تفرُعُ النساء جسمًا لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فعرفها فقال: عرَفناكِ يا سَودَةُ، حِرصًا على أن يَنزِلَ الحجابُ، فنزلت الآيات: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) سورة الأحزاب.
وروت سودة خمسة أحاديث؛ منها في الصحيحين حديث واحد عن البخاري، وروى عنها عبد الله بن عباس، ويحيى بن عبد الله الأنصاري.
فروى لها ابن الزبير أنها قالت: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج قال: ˝أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منك˝ قال: نعم، قال: فالله أرحم حج عن أبيك».
شهدت سودة غزوة خيبر مع النبي وأطعمها النبي من الغنائم ثمانين وَسْقًا تمرًا وعشرين وَسْقًا شعيًرا، ويقال قمح. وشهدت معه حجة الوداع، واستأذنته أن تصلي الصبح بمنى ليلة المزدلفة فأذن لها، فعن عائشة: «استأذنت سودة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ليلة المزدلفة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، يعني ثقيلة، فأذن لها، ولأن أكون استأذنته أحبّ إليّ من معروج به.»
ولم تحج سودة بعدها ولزمت بيتها حتى وفاتها، فكانت تقول: «لا أحج بعدها أبدًا»، وتقول: «حججت واعتمرت فأنا أقر في بيتي، كما أمرني الله عز وجل»، وكانت زوجات النبي يحججن إلا سودة بنت زمعة وزينب بنت جحش، قالتا: «لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وفاتها
توفيت أم المؤمنين سودة بنت زمعة -رضي الله عنها- سنة 54هـ في شوال، بالمدينة المنورة في خلافة معاوية.
#أمهات_المؤمنين#صفاءفوزي. ❝
⏤ مجموعة من المؤلفين -
❞ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ (58) سلام قولا من رب رحيم قال ابن الأنباري : ولهم ما يدعون وقف حسن ، ثم تبتدئ : " سلام " على معنى ذلك لهم سلام . ويجوز أن يرفع السلام على معنى : ولهم ما يدعون مسلم خالص . فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على " ما يدعون " . وقال الزجاج : " سلام " مرفوع على البدل من " ما " أي : ولهم أن يسلم الله عليهم ، وهذا منى أهل الجنة . وروي من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رءوسهم فإذا الرب تعالى قد اطلع عليهم من فوقهم فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة . فذلك قوله : سلام قولا من رب رحيم . فينظر إليهم وينظرون إليه ، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ، فيبقى نوره وبركاته عليهم في ديارهم ذكره الثعلبي والقشيري . ومعناه ثابت في صحيح مسلم ، وقد بيناه في [ يونس ] عند قوله تعالى : للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ويجوز أن تكون " ما " نكرة ، و " سلام " نعتا لها ، أي : ولهم ما يدعون مسلم . ويجوز أن تكون " ما " رفع بالابتداء ، و " سلام " خبر عنها . وعلى هذه الوجوه لا يوقف على " ولهم ما يدعون " . وفي قراءة ابن مسعود " سلاما " يكون مصدرا ، وإن شئت في موضع الحال ، أي : ولهم ما يدعون ذا سلام أو سلامة أو مسلما ، فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على " يدعون " وقرأ محمد بن كعب القرظي " سلم " على الاستئناف كأنه قال : ذلك سلم لهم لا يتنازعون فيه . ويكون " ولهم ما يدعون " تاما . ويجوز أن يكون " سلام " بدلا من قوله : ولهم ما يدعون ، وخبر " ما يدعون " لهم . ويجوز أن يكون " سلام " خبرا آخر ، ويكون معنى الكلام أنه لهم خالص من غير منازع فيه . " قولا " مصدر على معنى : قال الله ذلك قولا . أو بقوله قولا ، ودل على الفعل المحذوف لفظ مصدره . ويجوز أن يكون المعنى : ولهم ما يدعون قولا ، أي : عدة من الله . فعلى هذا المذهب الثاني لا يحسن الوقف على " يدعون " . وقال السجستاني : الوقف على قوله : " سلام " تام ، وهذا خطأ ؛ لأن القول خارج مما قبله .. ❝ ⏤محمد بن صالح العثيمين❞ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ (58)
سلام قولا من رب رحيم قال ابن الأنباري : ولهم ما يدعون وقف حسن ، ثم تبتدئ : ˝ سلام ˝ على معنى ذلك لهم سلام . ويجوز أن يرفع السلام على معنى : ولهم ما يدعون مسلم خالص . فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على ˝ ما يدعون ˝ . وقال الزجاج : ˝ سلام ˝ مرفوع على البدل من ˝ ما ˝ أي : ولهم أن يسلم الله عليهم ، وهذا منى أهل الجنة .
وروي من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رءوسهم فإذا الرب تعالى قد اطلع عليهم من فوقهم فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة . فذلك قوله : سلام قولا من رب رحيم . فينظر إليهم وينظرون إليه ، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ، فيبقى نوره وبركاته عليهم في ديارهم ذكره الثعلبي والقشيري . ومعناه ثابت في صحيح مسلم ، وقد بيناه في [ يونس ] عند قوله تعالى : للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ويجوز أن تكون ˝ ما ˝ نكرة ، و ˝ سلام ˝ نعتا لها ، أي : ولهم ما يدعون مسلم . ويجوز أن تكون ˝ ما ˝ رفع بالابتداء ، و ˝ سلام ˝ خبر عنها . وعلى هذه الوجوه لا يوقف على ˝ ولهم ما يدعون ˝ . وفي قراءة ابن مسعود ˝ سلاما ˝ يكون مصدرا ، وإن شئت في موضع الحال ، أي : ولهم ما يدعون ذا سلام أو سلامة أو مسلما ، فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على ˝ يدعون ˝ وقرأ محمد بن كعب القرظي ˝ سلم ˝ على الاستئناف كأنه قال : ذلك سلم لهم لا يتنازعون فيه . ويكون ˝ ولهم ما يدعون ˝ تاما . ويجوز أن يكون ˝ سلام ˝ بدلا من قوله : ولهم ما يدعون ، وخبر ˝ ما يدعون ˝ لهم . ويجوز أن يكون ˝ سلام ˝ خبرا آخر ، ويكون معنى الكلام أنه لهم خالص من غير منازع فيه . ˝ قولا ˝ مصدر على معنى : قال الله ذلك قولا . أو بقوله قولا ، ودل على الفعل المحذوف لفظ مصدره . ويجوز أن يكون المعنى : ولهم ما يدعون قولا ، أي : عدة من الله . فعلى هذا المذهب الثاني لا يحسن الوقف على ˝ يدعون ˝ . وقال السجستاني : الوقف على قوله : ˝ سلام ˝ تام ، وهذا خطأ ؛ لأن القول خارج مما قبله. ❝
⏤ محمد بن صالح العثيمين -
❞ في قصر فرعون! أنتِ أيضاً صحابيَّة! عندكِ شغف رهيب لمعرفة أخبار الأمم السَّابقة، تجدين في هذا تثبيتاً لقلبكِ، وتعزيةً لروحكِ، وتزدادين يقيناً أنَّ هذا الدِّين واحد عند الله، بدأ بآدم عليه السَّلام وخُتم بمحمدٍ ﷺ! تختلفُ الشَّرائع، وتتفاوتُ العبادات، أما الدِّين فواحد لا يتغيَّر عنوانه قول ربِّكِ: \"إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ\" وها هو نبيُّكِ وحبيبُكِ ﷺ يَسرجُ لكِ صهوة صوته العذب، وها أنتِ تمتطين ظهر الكلام، وتعودين أدراجكِ إلى ماضٍ سحيق لم تعيشيه، وتطَّلعين على غيبٍ لم تشهديه! يقولُ لكِ حبيبكِ ومصطفاكِ وقُرَّة عينيكِ: لم يكذبْ إبراهيم عليه السَّلام إلا ثلاث كذباتٍ ثنتين في ذات الله! قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ\"﴾ وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾ وبينما هو ذات يومٍ وسارة إذ أتى على جبَّارٍ من الجبابرة فقيل له: إنَّ ها هُنا رجلاً مع امرأةٍ من أحسن الناس، فأرسلَ إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي! فأتى سارة فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيركِ، وإنَّ هذا سألني فأخبرته عنكِ أنكِ أختي، فلا تُكذبيني! فأرسلَ إليهما، فلما دخلتْ عليه ذهبَ يتناولها بيده، فأُخِذ! فقال لها: ادعي الله أن يُطلقَ يدي، ولا أضُرّكِ فدعتْ، فأُطلِقَ! ثم جاءَ يتناولها الثانية، فأُخِذَ مثلها أو أشدَّ، فدعا بعض صحبته، فقال: إنكم لم تأتوني بإنسانٍ، إنما أتيتموني بشيطان! فأتتْ إبراهيم وهو يُصلي، وقالتْ: كفَّ الله يدَ الفاجر، وأخدمني هاجر! والقصّة أيتها الصحابيّة باختصار: أنَّ إبراهيم عليه السّلام عندما أخرجه قومه من العراق، توجه بزوجته سارة إلى مصر، وكانتْ سارة أجمل امرأة في تاريخ البشرية، حتى ليُقال أن جمال يوسف عليه السلام بعِرْقٍ منها فهي جدَّتُه! وكان فرعون في ذلك الوقت زير نساء، لا يرى امرأة جميلة إلا أرادها لنفسه، وكان قد أمر جنوده إذا رأوا امرأةً جميلة أن يخبروه بها، فأخبره جنوده بجمال سارة، فأرسل فرعون إلى إبراهيم عليه السلام يطلبه، فلما حضر عنده سأله عنها، فقال له إبراهيم عليه السَّلام: هي أختي! لأنه يعلمُ أنه لو قال إنها زوجته، فسيقتله، ويأخذها منه! ولما حضر إبراهيم وسارة إلى قصر فرعون، أمر فرعون أن تُحملَ إليه فلما أراد أن يمدَّ يده عليها تخشَّبتْ يده! فطلبَ منها أن تدعو الله له أن يفكه ولن يقربها، لأنه علم أنها وإبراهيم عليه السلام موحدين يعبدون الله، فدعتْ له، فشُفيَ، ولكنه حنثَ بوعده، وقام يحاولُ أن يمدَّ يده عليها، فأصابه أشد مما أصابه في المرّة الأولى، فنادى على خدمه وأخبرهم أنَّ هذه شيطانة لا إنسانة! وأمرَ أن يطلقوها ويعطوها هاجر هديةً لها، فعادتْ إلى إبراهيم عليه السلام وهو يصلي، وأخبرته بالأمر، وقيل إنَّ الله سبحانه قد كشفَ الحجاب لإبراهيم عليه السلام، فكان يرى ما يحدث بين فرعون وسارة تعزيةً لخليله إبراهيم، وطمأنة لقلبه أن عِرضه مُصان! يا صحابية، إنَّ الكذبَ الوارد في القصة ليس هو الكذب الذي تعرفينه، ذاك الكذب الذي يقلب الحقَّ باطلاً، وإنما هو إخبار بغير الحقيقة للضرورة، والإسلام العظيم دين الواقعية والحياة بامتياز، لذلك أباح الكذب في ثلاثة مواضع! كذب المسلمُ على أعدائه، فليس من المنطق أن يأخذ الكفار أسيراً مسلماً، ويسألوه عن أسرار المسلمين فيخبرهم! وكذب المسلم لإصلاح ذات البين فعندما تقعُ الخلافات بين الناس يجب حلَّها، فإذا وقع بين صديقتيكِ خلاف، جئتِ إلى صديقة منهما وقلتِ لها: فلانة تُحبكِ، ونادمة على ما كان منها، وقد قالتْ عنكِ كلاماً جميلاً، دعينا لا نتحدث عما حدث، ونصلح الذي كان، وتقولين للأخرى مثل ذلك وبهذا ينتهي الخلاف، ولكِ أجر الصلح وليس عليكِ إثم الكذب! وأباح الإسلام العظيم كذب الرجل على امرأته، وكذب المرأة على زوجها، إذا ما تعلَّقَ الأمر بجبر الخواطر، ومراعاة المشاعر، يقولُ الرجل لزوجته: أنتِ أجمل امرأة في الدنيا، وهو يعرفُ أنَّ هناك من هي أجمل منها، وهي تعرفُ كذلك، ولكن هذا ليس مضمار الحقيقة، لأن الحقيقة هنا تكسر القلب! وقد يمدح ثوباً لبسته وهو لا يُعجبه وتسريحة شعرٍ وهي لا تروق له، وطبخة جديدة وهو لم يستطِبْها، وكل هذا داخل في باب جبر الخواطر، وجبر الخواطر عبادة! وما يُقال في حق الزوج، يُقال في حق الزوجة أيضاً! سألَ رجلٌ زوجته إن كانتْ تُحبُّه، وناشدها الله أن تصدقه، فقالتْ: أما إنكَ ناشدتني الله، فلا أُحبُكَ! فشكاها إلى عمر بن الخطاب، فأرسل عُمر في طلبها، وأنَّبها على ما كان منها فقالتْ له: يا أمير المؤمنين، أتريدني أن أكذب عليه؟! فقال لها: نعم اكذبي عليه، أَكُلُّ البيوت بُنيت على الحُب، ألا إنَّ الناس يتعاملون بالمروءة والذمة! يا صحابية، صرتِ تعرفين الآن أن ما كان عليه إبراهيم عليه السّلام، إنما كان من باب حُسن التدبير والحيلة، وكذلك قوله ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ كان كي لا يخرج معهم إلى عبادة غير الله، وقوله ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾ كان من باب إقامة الحُجة عليهم، وكي يريهم أن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله إنما هي عاجزة لا تضر ولا تنفع! فلا تكوني فظّة بدعوى أنكِ تقولين الحقيقة! عند جبر الخواطر \"الدبلوماسية\" هي المطلوبة، وعندما تقع الخلافات كوني رسول خير، ولا تمشي بالنميمة بين المتخاصمين، فتصبين الزيت على النار وتذكري: لا يدخل الجنة نمَّام! يا صحابية، من أرادتْ العِفَّة عفَّها الله، إنَّ الله أعدل من يراك تطلبين الستر فيفضحك، وأجلَّ من أن تطلبي الخير فيوقعكِ في الشَّر، أصلحي قلبكِ ونيّتكِ ثم اتركيها على الله، كل الأسباب بيده سبحانه، شُلَّتْ يد فرعون لأنها امتدتْ إلى امرأة عفيفة، فكوني مع الله يكُنْ معكِ! يا صحابية، الجمال، المال، والمنصب نِعَم يجب أن تُصان، الجمال يُصان بستره وعدم كشفه إلا لصاحبه، والمال يُصان بالحمد ومساعدة الفقراء، والمنصب يُصان بخدمة الناس، كوني جميلة، واهتمي بأنوثتكِ، ضعي مساحيق التجميل، والبسي أجمل الثياب، واستخدمي أجمل العطور، ولكن في موضعها، موضعها فقط! تعلمي، واحصلي على الشهادات، وتاجري إن شئتِ، كوني ثرية ولكن دون كبر وكفران النعمة! وانجحي في وظيفتكِ، واسعي لمنصب أعلى، ولكن لا تنسي أبداً أنَّ الذي رفعكِ، قادرٌ على أن يُنزلكِ بدعوة مظلوم! يا صحابية، مهما كنتِ جميلة وثرية وناجحة، كوني دوماً في كنف زوجكِ، ولا تتكبري عليه، أو تنتقصي من رجولته! ما هذا دأبُ الصالحات، ولا أخلاقهُنَّ، مهما بلغتِ من الجمال فلن تصلي إلى جمال سارة، وقد كانت في كنف إبراهيم عليه السلام، زوجة مُحبَّة، ورفيقة درب! ومهما بلغتِ من الثراء فلن تصلي إلى ثراء خديجة رضي الله عنها وقد جعلتْ كل مالها في يد زوجها، وأعطته حين حرمه الناس، وصدقته حين كذَّبه الناس، وآمنتْ به حين كفرَ به الناس! مالكِ لكِ لا شكَّ، وهذا حقكِ الذي لا يجادلك فيه أحد، ولكن البيوت التي يكون فيها جيبان، وهذا لكَ وهذا لي، العيشُ فيها لا يُطاق!. ❝ ⏤أدهم شرقاوي❞ في قصر فرعون!
أنتِ أيضاً صحابيَّة!
عندكِ شغف رهيب لمعرفة أخبار الأمم السَّابقة،
تجدين في هذا تثبيتاً لقلبكِ،
وتعزيةً لروحكِ،
وتزدادين يقيناً أنَّ هذا الدِّين واحد عند الله،
بدأ بآدم عليه السَّلام وخُتم بمحمدٍ ﷺ!
تختلفُ الشَّرائع، وتتفاوتُ العبادات،
أما الدِّين فواحد لا يتغيَّر عنوانه قول ربِّكِ:
˝إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ˝
وها هو نبيُّكِ وحبيبُكِ ﷺ يَسرجُ لكِ صهوة صوته العذب،
وها أنتِ تمتطين ظهر الكلام،
وتعودين أدراجكِ إلى ماضٍ سحيق لم تعيشيه،
وتطَّلعين على غيبٍ لم تشهديه!
يقولُ لكِ حبيبكِ ومصطفاكِ وقُرَّة عينيكِ:
لم يكذبْ إبراهيم عليه السَّلام إلا ثلاث كذباتٍ
ثنتين في ذات الله!
قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ˝﴾
وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾
وبينما هو ذات يومٍ وسارة
إذ أتى على جبَّارٍ من الجبابرة
فقيل له: إنَّ ها هُنا رجلاً مع امرأةٍ من أحسن الناس،
فأرسلَ إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟
قال: أختي!
فأتى سارة فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيركِ،
وإنَّ هذا سألني فأخبرته عنكِ أنكِ أختي،
فلا تُكذبيني!
فأرسلَ إليهما، فلما دخلتْ عليه ذهبَ يتناولها بيده،
فأُخِذ!
فقال لها: ادعي الله أن يُطلقَ يدي، ولا أضُرّكِ
فدعتْ، فأُطلِقَ!
ثم جاءَ يتناولها الثانية، فأُخِذَ مثلها أو أشدَّ،
فدعا بعض صحبته، فقال:
إنكم لم تأتوني بإنسانٍ، إنما أتيتموني بشيطان!
فأتتْ إبراهيم وهو يُصلي، وقالتْ:
كفَّ الله يدَ الفاجر، وأخدمني هاجر!
والقصّة أيتها الصحابيّة باختصار:
أنَّ إبراهيم عليه السّلام عندما أخرجه قومه من العراق،
توجه بزوجته سارة إلى مصر،
وكانتْ سارة أجمل امرأة في تاريخ البشرية،
حتى ليُقال أن جمال يوسف عليه السلام بعِرْقٍ منها فهي جدَّتُه!
وكان فرعون في ذلك الوقت زير نساء،
لا يرى امرأة جميلة إلا أرادها لنفسه،
وكان قد أمر جنوده إذا رأوا امرأةً جميلة أن يخبروه بها،
فأخبره جنوده بجمال سارة،
فأرسل فرعون إلى إبراهيم عليه السلام يطلبه،
فلما حضر عنده سأله عنها،
فقال له إبراهيم عليه السَّلام: هي أختي!
لأنه يعلمُ أنه لو قال إنها زوجته،
فسيقتله، ويأخذها منه!
ولما حضر إبراهيم وسارة إلى قصر فرعون،
أمر فرعون أن تُحملَ إليه
فلما أراد أن يمدَّ يده عليها تخشَّبتْ يده!
فطلبَ منها أن تدعو الله له أن يفكه ولن يقربها،
لأنه علم أنها وإبراهيم عليه السلام موحدين يعبدون الله،
فدعتْ له، فشُفيَ،
ولكنه حنثَ بوعده، وقام يحاولُ أن يمدَّ يده عليها،
فأصابه أشد مما أصابه في المرّة الأولى،
فنادى على خدمه وأخبرهم أنَّ هذه شيطانة لا إنسانة!
وأمرَ أن يطلقوها ويعطوها هاجر هديةً لها،
فعادتْ إلى إبراهيم عليه السلام وهو يصلي، وأخبرته بالأمر،
وقيل إنَّ الله سبحانه قد كشفَ الحجاب لإبراهيم عليه السلام،
فكان يرى ما يحدث بين فرعون وسارة
تعزيةً لخليله إبراهيم،
وطمأنة لقلبه أن عِرضه مُصان!
يا صحابية،
إنَّ الكذبَ الوارد في القصة ليس هو الكذب الذي تعرفينه،
ذاك الكذب الذي يقلب الحقَّ باطلاً،
وإنما هو إخبار بغير الحقيقة للضرورة،
والإسلام العظيم دين الواقعية والحياة بامتياز،
لذلك أباح الكذب في ثلاثة مواضع!
كذب المسلمُ على أعدائه،
فليس من المنطق أن يأخذ الكفار أسيراً مسلماً،
ويسألوه عن أسرار المسلمين فيخبرهم!
وكذب المسلم لإصلاح ذات البين
فعندما تقعُ الخلافات بين الناس يجب حلَّها،
فإذا وقع بين صديقتيكِ خلاف،
جئتِ إلى صديقة منهما وقلتِ لها:
فلانة تُحبكِ، ونادمة على ما كان منها،
وقد قالتْ عنكِ كلاماً جميلاً،
دعينا لا نتحدث عما حدث، ونصلح الذي كان،
وتقولين للأخرى مثل ذلك وبهذا ينتهي الخلاف،
ولكِ أجر الصلح وليس عليكِ إثم الكذب!
وأباح الإسلام العظيم كذب الرجل على امرأته،
وكذب المرأة على زوجها،
إذا ما تعلَّقَ الأمر بجبر الخواطر، ومراعاة المشاعر،
يقولُ الرجل لزوجته: أنتِ أجمل امرأة في الدنيا،
وهو يعرفُ أنَّ هناك من هي أجمل منها،
وهي تعرفُ كذلك،
ولكن هذا ليس مضمار الحقيقة،
لأن الحقيقة هنا تكسر القلب!
وقد يمدح ثوباً لبسته وهو لا يُعجبه
وتسريحة شعرٍ وهي لا تروق له،
وطبخة جديدة وهو لم يستطِبْها،
وكل هذا داخل في باب جبر الخواطر،
وجبر الخواطر عبادة!
وما يُقال في حق الزوج، يُقال في حق الزوجة أيضاً!
سألَ رجلٌ زوجته إن كانتْ تُحبُّه، وناشدها الله أن تصدقه،
فقالتْ: أما إنكَ ناشدتني الله، فلا أُحبُكَ!
فشكاها إلى عمر بن الخطاب،
فأرسل عُمر في طلبها، وأنَّبها على ما كان منها
فقالتْ له: يا أمير المؤمنين، أتريدني أن أكذب عليه؟!
فقال لها: نعم اكذبي عليه، أَكُلُّ البيوت بُنيت على الحُب،
ألا إنَّ الناس يتعاملون بالمروءة والذمة!
يا صحابية،
صرتِ تعرفين الآن أن ما كان عليه إبراهيم عليه السّلام،
إنما كان من باب حُسن التدبير والحيلة،
وكذلك قوله ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾
كان كي لا يخرج معهم إلى عبادة غير الله،
وقوله ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾
كان من باب إقامة الحُجة عليهم،
وكي يريهم أن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله
إنما هي عاجزة لا تضر ولا تنفع!
فلا تكوني فظّة بدعوى أنكِ تقولين الحقيقة!
عند جبر الخواطر ˝الدبلوماسية˝ هي المطلوبة،
وعندما تقع الخلافات كوني رسول خير،
ولا تمشي بالنميمة بين المتخاصمين، فتصبين الزيت على النار
وتذكري: لا يدخل الجنة نمَّام!
يا صحابية،
من أرادتْ العِفَّة عفَّها الله،
إنَّ الله أعدل من يراك تطلبين الستر فيفضحك،
وأجلَّ من أن تطلبي الخير فيوقعكِ في الشَّر،
أصلحي قلبكِ ونيّتكِ ثم اتركيها على الله،
كل الأسباب بيده سبحانه،
شُلَّتْ يد فرعون لأنها امتدتْ إلى امرأة عفيفة،
فكوني مع الله يكُنْ معكِ!
يا صحابية،
الجمال، المال، والمنصب نِعَم يجب أن تُصان،
الجمال يُصان بستره وعدم كشفه إلا لصاحبه،
والمال يُصان بالحمد ومساعدة الفقراء،
والمنصب يُصان بخدمة الناس،
كوني جميلة، واهتمي بأنوثتكِ،
ضعي مساحيق التجميل،
والبسي أجمل الثياب،
واستخدمي أجمل العطور،
ولكن في موضعها، موضعها فقط!
تعلمي، واحصلي على الشهادات، وتاجري إن شئتِ،
كوني ثرية ولكن دون كبر وكفران النعمة!
وانجحي في وظيفتكِ، واسعي لمنصب أعلى،
ولكن لا تنسي أبداً أنَّ الذي رفعكِ،
قادرٌ على أن يُنزلكِ بدعوة مظلوم!
يا صحابية،
مهما كنتِ جميلة وثرية وناجحة،
كوني دوماً في كنف زوجكِ،
ولا تتكبري عليه، أو تنتقصي من رجولته!
ما هذا دأبُ الصالحات، ولا أخلاقهُنَّ،
مهما بلغتِ من الجمال فلن تصلي إلى جمال سارة،
وقد كانت في كنف إبراهيم عليه السلام،
زوجة مُحبَّة، ورفيقة درب!
ومهما بلغتِ من الثراء
فلن تصلي إلى ثراء خديجة رضي الله عنها
وقد جعلتْ كل مالها في يد زوجها،
وأعطته حين حرمه الناس،
وصدقته حين كذَّبه الناس،
وآمنتْ به حين كفرَ به الناس!
مالكِ لكِ لا شكَّ،
وهذا حقكِ الذي لا يجادلك فيه أحد،
ولكن البيوت التي يكون فيها جيبان،
وهذا لكَ وهذا لي،
العيشُ فيها لا يُطاق!. ❝
⏤ أدهم شرقاوي -
❞ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) قال ابن عباس : ( يريد كفار أهل مكة ) . وقال علي : ( هم الخوارج أهل حروراء . وقال مرة : هم الرهبان أصحاب الصوامع ) . وروي أن ابن الكواء سأله عن الأخسرين أعمالا فقال له : أنت وأصحابك . قال ابن عطية : ويضعف هذا كله قوله - تعالى - بعد ذلك : أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم . وليس من هذه الطوائف من يكفر بالله ولقائه والبعث والنشور ، وإنما هذه صفة مشركي مكة عبدة الأوثان ، وعلي وسعد - رضي الله عنهما - ذكرا أقواما أخذوا بحظهم من هذه الآية . و أعمالا نصب على التمييز . و حبطت قراءة الجمهور بكسر الباء . وقرأ ابن عباس " حبطت " بفتحها . الثانية : قوله تعالى : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قراءة الجمهور نقيم بنون العظمة . وقرأ مجاهد بياء الغائب ; يريد فلا يقيم الله - عز وجل - ، وقرأ عبيد بن عمير " فلا يقوم " ويلزمه أن يقرأ " وزن " وكذلك قرأ مجاهد " فلا يقوم لهم يوم القيامة وزن " . قال عبيد بن عمير : يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة . قلت : هذا لا يقال مثله من جهة الرأي ، وقد ثبت معناه مرفوعا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرءوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا . والمعنى أنهم لا ثواب لهم ، وأعمالهم مقابلة بالعذاب ، فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة ومن لا حسنة له فهو في النار . وقال أبو سعيد الخدري : يؤتى بأعمال كجبال تهامة فلا تزن شيئا . وقيل : يحتمل أن يريد المجاز والاستعارة ; كأنه قال : فلا قدر لهم عندنا يومئذ ; والله أعلم . وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه ، لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم ، بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قدر الكفاية المبتغى به الترفه والسمن . وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : إن أبغض الرجال إلى الله - تعالى - الحبر السمين ومن حديث عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : خيركم قرني ثم الذين يلونهم - قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة - ثم إن من بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وهذا ذم . وسبب ذلك أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل والشره ، والدعة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتها ، فهو عبد نفسه لا عبد ربه ، ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في الحرام ، وكل لحم تولد عن سحت فالنار أولى به ; وقد ذم الله - تعالى - الكفار بكثرة الأكل فقال : والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فإذا كان المؤمن يتشبه بهم ، ويتنعم بتنعمهم في كل أحواله وأزمانه ، فأين حقيقة الإيمان ، والقيام بوظائف الإسلام ؟ ! ومن كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصه ، وزاد بالليل كسله ونومه ، فكان نهاره هائما ، وليله نائما . وقد مضى في " الأعراف " هذا المعنى ; وتقدم فيها ذكر الميزان ، وأن له كفتين توزن فيهما صحائف الأعمال فلا معنى للإعادة . وقال - عليه الصلاة والسلام - حين ضحكوا من حمش ساق ابن مسعود وهو يصعد النخلة : تضحكون من ساق توزن بعمل أهل الأرض فدل هذا على أن الأشخاص توزن ; ذكره الغزنوي .. ❝ ⏤محمد بن صالح العثيمين❞ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105)
قال ابن عباس : ( يريد كفار أهل مكة ) . وقال علي : ( هم الخوارج أهل حروراء . وقال مرة : هم الرهبان أصحاب الصوامع ) . وروي أن ابن الكواء سأله عن الأخسرين أعمالا فقال له : أنت وأصحابك . قال ابن عطية : ويضعف هذا كله قوله - تعالى - بعد ذلك : أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم .
وليس من هذه الطوائف من يكفر بالله ولقائه والبعث والنشور ، وإنما هذه صفة مشركي مكة عبدة الأوثان ، وعلي وسعد - رضي الله عنهما - ذكرا أقواما أخذوا بحظهم من هذه الآية . و أعمالا نصب على التمييز . و حبطت قراءة الجمهور بكسر الباء . وقرأ ابن عباس " حبطت " بفتحها .
الثانية : قوله تعالى : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قراءة الجمهور نقيم بنون العظمة . وقرأ مجاهد بياء الغائب ; يريد فلا يقيم الله - عز وجل - ، وقرأ عبيد بن عمير " فلا يقوم " ويلزمه أن يقرأ " وزن " وكذلك قرأ مجاهد " فلا يقوم لهم يوم القيامة وزن " . قال عبيد بن عمير : يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة .
قلت : هذا لا يقال مثله من جهة الرأي ، وقد ثبت معناه مرفوعا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرءوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا . والمعنى أنهم لا ثواب لهم ، وأعمالهم مقابلة بالعذاب ، فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة ومن لا حسنة له فهو في النار . وقال أبو سعيد الخدري : يؤتى بأعمال كجبال تهامة فلا تزن شيئا . وقيل : يحتمل أن يريد المجاز والاستعارة ; كأنه قال : فلا قدر لهم عندنا يومئذ ; والله أعلم . وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه ، لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم ، بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قدر الكفاية المبتغى به الترفه والسمن . وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : إن أبغض الرجال إلى الله - تعالى - الحبر السمين ومن حديث عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : خيركم قرني ثم الذين يلونهم - قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة - ثم إن من بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وهذا ذم . وسبب ذلك أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل والشره ، والدعة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتها ، فهو عبد نفسه لا عبد ربه ، ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في الحرام ، وكل لحم تولد عن سحت فالنار أولى به ; وقد ذم الله - تعالى - الكفار بكثرة الأكل فقال : والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فإذا كان المؤمن يتشبه بهم ، ويتنعم بتنعمهم في كل أحواله وأزمانه ، فأين حقيقة الإيمان ، والقيام بوظائف الإسلام ؟ ! ومن كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصه ، وزاد بالليل كسله ونومه ، فكان نهاره هائما ، وليله نائما . وقد مضى في " الأعراف " هذا المعنى ; وتقدم فيها ذكر الميزان ، وأن له كفتين توزن فيهما صحائف الأعمال فلا معنى للإعادة . وقال - عليه الصلاة والسلام - حين ضحكوا من حمش ساق ابن مسعود وهو يصعد النخلة : تضحكون من ساق توزن بعمل أهل الأرض فدل هذا على أن الأشخاص توزن ; ذكره الغزنوي. ❝
⏤ محمد بن صالح العثيمين -
❞ 💠 كما تدين تدان💠 أب ماتت زوجته ولديه خمس بنات ، تقدم لخطبتهم اربع رجال فأراد الأب أن يزوج الكبيرة ثم التي تليها ثم التي تليها ، ثم التي تليها ، ولكن البنت الكبيرة رفضت الزواج لأنها أرادت أن تهتم بوالدها وتخدمه ، فزوَّج الأب أخواتها الأربعة ، وجلست البنت الكبرى تهتم بوالدها وتعتني به حتى مات . وبعد وفاة الأب فتحوا وصيته فوجدوه قد كتب فيها : ( لا تقسموا البيت حتى تتزوج أختكم الكبيرة التي ضحت بسعادتها من أجل سعادتكم ) . ولكن الأخوات الأربعة رفضوا الوصية وأرادو أن يبيعوا البيت لتأخذ كل واحدة نصيبها من الميراث ، دون مراعاة أين ستذهب أختهم الكبيرة التي ليس لها مأوى سوى الله عز وجل . ولما أحست الأخت الكبيرة أنه لا مفر من تقسيم البيت اتصلت الأخت الكبيرة بمن اشترى البيت ، وقصت عليه قصة وصيّة والدها وبأنها ليس لها إلا هذا البيت يأويها وعليه أن يصبر عليها بضعة أشهر لأنها أرادت أن تمكث في بيت أبيها حتى تجد لها مكانا مناسبا تعيش فيه ، فوافق ذلك الرجل وقال : ( حسنا لا عليكي ) ، فتمّ بيع البيت وتم تقسيم البيت على البنات الخمس ، وكل واحدة ذهبت إلى بيت زوجها وهي في غاية السعادة ولم يفكروا في مصير أختهم الكبيرة . ولكن الأخت الكبيرة كانت مؤمنة بأن الله لن يضيّعها لأنها لزمت مصاحبة والدها وعاشت في خدمته . مضت الشهور وتلقت الأخت الكبيرة اتصالاً من الرجل الذي اشترى البيت ، فخافت وظنت أنه سيطردها من البيت ، ولما أتاها قالت له : اعذرني أنا لم أجد مكاناً بعد فقال لها : لا عليكي أنا لم أحضر من أجل ذلك ، ولكني أتيت لأُسلِّمكِ ورقة من المحكمة ، لقد وهبت هذا البيت لكي مهرًا ، إن شئتِي قبلت أن أكون لك زوجًا ، وإن رفضتي رجعت من حيث أتيت وفي كلتا الحالتين البيت هو لكي ، فبكت الأخت الكبيرة وعلمت أن الله لا يضيع عمل المحسنين ، فوافقت على الزواج من ذلك التاجر الثري ، وعاشت معه في سعادة تامة . مهما فعلت من خير فلن يضيع الله أجرك ، فكيف البر بالوالدين . البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت … فكما تدين تدان . لـ/وفاء ابو خطيب. ❝ ⏤وفاء أبو خطيب❞ 💠 كما تدين تدان💠
أب ماتت زوجته ولديه خمس بنات ،
تقدم لخطبتهم اربع رجال
فأراد الأب أن يزوج الكبيرة ثم التي تليها ثم التي تليها ، ثم التي تليها ،
ولكن البنت الكبيرة رفضت الزواج لأنها أرادت أن تهتم بوالدها وتخدمه ،
فزوَّج الأب أخواتها الأربعة ،
وجلست البنت الكبرى تهتم بوالدها وتعتني به حتى مات .
وبعد وفاة الأب فتحوا وصيته فوجدوه قد كتب فيها : ( لا تقسموا البيت حتى تتزوج أختكم الكبيرة التي ضحت بسعادتها من أجل سعادتكم ) .
ولكن الأخوات الأربعة رفضوا الوصية وأرادو أن يبيعوا البيت لتأخذ كل واحدة نصيبها من الميراث ، دون مراعاة أين ستذهب أختهم الكبيرة التي ليس لها مأوى سوى الله عز وجل .
ولما أحست الأخت الكبيرة أنه لا مفر من تقسيم البيت اتصلت الأخت الكبيرة بمن اشترى البيت ، وقصت عليه قصة وصيّة والدها وبأنها ليس لها إلا هذا البيت يأويها وعليه أن يصبر عليها بضعة أشهر لأنها أرادت أن تمكث في بيت أبيها حتى تجد لها مكانا مناسبا تعيش فيه ،
فوافق ذلك الرجل وقال : ( حسنا لا عليكي ) ،
فتمّ بيع البيت وتم تقسيم البيت على البنات الخمس ، وكل واحدة ذهبت إلى بيت زوجها وهي في غاية السعادة ولم يفكروا في مصير أختهم الكبيرة .
ولكن الأخت الكبيرة كانت مؤمنة بأن الله لن يضيّعها لأنها لزمت مصاحبة والدها وعاشت في خدمته .
مضت الشهور وتلقت الأخت الكبيرة اتصالاً من الرجل الذي اشترى البيت ، فخافت وظنت أنه سيطردها من البيت ،
ولما أتاها قالت له : اعذرني أنا لم أجد مكاناً بعد
فقال لها : لا عليكي أنا لم أحضر من أجل ذلك ،
ولكني أتيت لأُسلِّمكِ ورقة من المحكمة ، لقد وهبت هذا البيت لكي مهرًا ،
إن شئتِي قبلت أن أكون لك زوجًا ،
وإن رفضتي رجعت من حيث أتيت وفي كلتا الحالتين البيت هو لكي ، فبكت الأخت الكبيرة وعلمت أن الله لا يضيع عمل المحسنين ،
فوافقت على الزواج من ذلك التاجر الثري ، وعاشت معه في سعادة تامة .
مهما فعلت من خير فلن يضيع الله أجرك ، فكيف البر بالوالدين .
البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت
اعمل ما شئت … فكما تدين تدان .
لـ/وفاء ابو خطيب. ❝
⏤ وفاء أبو خطيب